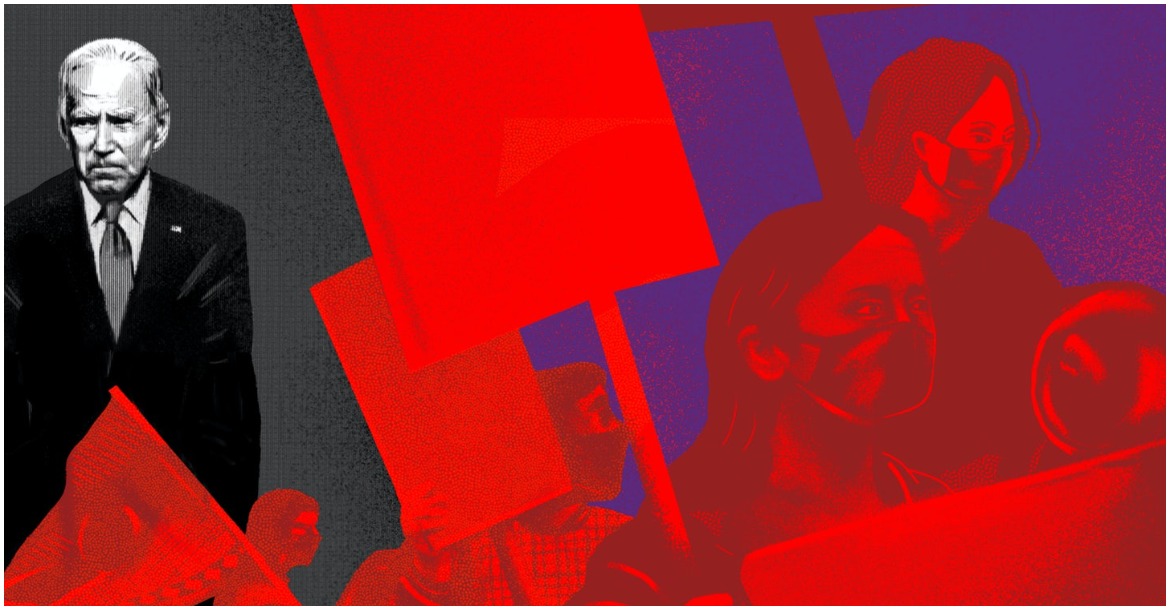فيما تجهزت إسرائيل لطرد عائلات فلسطينية لإفساح المكان والزمان للمستوطنين اليهود في القدس الشرقية، وشنت غارات جوية على غزة أدت إلى تدمير المنازل وقتل المئات من الفلسطينيين، بمن فيهم عشرات الأطفال، شهد الديمقراطيون في واشنطن ما وصفه أحد استطلاعات الرأي بأنه “تحول جذري”.
وراح نواب أميركيون منتخبون حديثا من شاكلة كوري بوش وماري نيومان يلفتون الانتباه إلى التورط الأميركي في الممارسات الإسرائيلية. حتى أعضاء مجلس الشيوخ، الموالين على نحو تقليدي لإسرائيل، مثل بوب مينينديز وكريس كونز، انبروا في توجيه نقد، ربما غير معتاد، لهذه الممارسات، والتعبير عن انزعاجهم من التقارير الخاصة بالعمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.
وبعد أن كان الديمقراطيون، على مدى جيل كامل، يقدمون بالإجماع دعما غير مشروط لإسرائيل، تحولوا الآن، وعلى نحو مفاجئ، حتى في صفوف بعض مؤيدي إسرائيل الأكثر موثوقية، إلى التردد في إظهار هذا الدعم على أقل تقدير.
من جانبه، حاول الرئيس جو بايدن الظهور في الصورة الجديدة بإعلانه أن “الفلسطينيين والإسرائيليين يستحقان جميعا، وبذات القدر، العيش في أمن وسلام”. لكن، برغم ذلك، يصر الرئيس، في كل منعطف، أن يبدو مخلصا لدعمه الراسخ والوطيد لإسرائيل.
يتجلى ذلك ـ من بين أشياء أخرى ـ في دفاعه عن العمليات العسكرية الإسرائيلية، والتأكيد على أن الغارات الجوية لم تكن “رد فعل مبالغا فيه”، ورفضه الدعوة علنا إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، وتعهده بتجديد منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية، ما دفع بأكثرمن 500 من المشاركين في حملته إلى نشر خطاب يدعونه فيه إلى “تقديم المزيد لحماية الفلسطينيين ومساءلة إسرائيل”.
كان هذا علامة على اتجاه أكثر عمومية؛ فبينما اقتفى بايدن أثر اليسار في القضايا المحلية، بقيت سياسته الخارجية عالقة بدرجة كبيرة في توافق عفا عليه الزمن. ورغم الأزمات العالمية والصراعات التي تبدو بلا نهاية التي قسمت السياسة الخرجية الأميركية على مدى العقدين الماضيين، يعيد بايدن تدوير الأفكار والأحكام السابقة المتعلقة بالتحالفات والاحتياجات الأمنية، والهيمنة الشاملة، ليس فقط فيما يتعلق بإسرائيل، وإنما أيضا بالصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية وفنزويلا وكوبا، وغيرهم.
وعندما أعلن بايدن أن “أميركا عادت”، وأنها “مستعدة لقيادة العالم”، لم يكن ذلك سوى إشارة إلى تحول لا يتجاوز الحناجر، ولا تربطه بالتحولات الجوهرية الكبرى علاقة من قريب أو بعيد. فرؤية الولايات المتحدة السابقة “المانوية” للعالم، بتصنيفها الراسخ للدول إلى مارقة وحليفة، لا تزال راسخة ومهيمنة. وتبقى المشكلة في أن هذه الرؤية تفاقم كثيرا الأزمات التي يعتقد بايدن في إمكانية حلها بالعودة ببساطة إلى النبع القديم.
ربما تسبب شعور عام بالراحة لخروج ترمب من السلطة، في ميل كثير من المحللين إلى التعامل مع سياسة بايدن الخارجية باعتبارها بداية جديدة. وعلى وجه التحديد، تم تصدير مشهدين في السياسة الخارجية الأميركية الحالية على أنهما يمثلان “نقاط تحول جوهرية في السياسة الخارجية الأميركية”.
ففي أبريل الماضي، عندما أعلن بايدن سحب 2500 جندي من أفغانستان، قرأ المحللون المشهد على أنه “انفصال تاريخي عن الالتزامات الأميركية التقليدية”، فيما رفض الوسطيون هذا الانسحاب، مؤكدين أن “هذا الانسحاب المتسرع يمكن أن يؤدي إلى فيتنام جديدة”.
في الواقع لا يمكن اعتبار هذا الإجراء من قبيل الخروج على منطق الحرب اللانهائية، أو حتى تراجعا عن سياسات التفوق الأميركي، وإنما ـ في واقع الأمر ـ مجرد محاولة من قبل الإدارة الأميركية الحالية للمضي قدما على طريق تحقيق رغبات بلتواي الراسخة في تحويل الموارد إلى صراعات وتنافسات أخرى، وهي الاستراتيجية التي أقرها الرؤساء الثلاثة السابقون جميعا.
لقد توقفت الولايات المتحدة، في حقيقة الأمر، عن النظر إلى أفغانستان على أنها تمثل أولوية استراتيجية دافعة منذ الغزو الأميركي للعراق في ولاية الرئيس جورج دبليو بوش، عندما تحولت أفغانستان إلى مسرح ثانوي للقتال في “الحرب على الإرهاب” المتركزة في منطقة الشرق الأوسط.
وبحلول عام 2011، أعلنت إدارة الرئيس باراك أوباما خطة الانسحاب، لكن تاريخه تغير بشكل متكرر، وترك أوباما أمر الانسحاب النهائي لخليفته. ثم جاء الرئيس السابق دونالد ترمب ليخطط لوضع اللمسات الأخيرة لانسحاب كامل بحلول عام 2021.

وورث بايدن هذا الخط الزمني، إلى جانب الإجماع الراسخ على أن الولايات المتحدة يجب أن تولي وجهها عن أفغانستان شطر منافسيها الحاليين، الصين وروسيا، وصراعاتها ضد القوى الأخرى، مثل إيران وكوريا الشمالية.
وأظهر بايدن نقطة التحول الثانية “المزعومة” حتى قبل أن يتولى سدة البيت الأبيض. فعلى مدى حملته الانتخابية أعرب بايدن عن دعمه للتعددية. وشملت ركائز هذا النهج تحالف الناتو والشراكات مع دول الاتحاد الأوربي، والعلاقات الكبرى في آسيا وأوقيانوسيا، مثل تلك التي تربط واشنطن باستراليا واليابان وكوريا الجنوبية، إلى جانب إعادة الدخول في اتفاقية باريس للمناخ.
وبمجرد اعتلائه سدة الرئاسة، أعلن بايدن في أول خطاب له حول سياسته الخارجية، والذي ألقاه من مقر وزارة الخارجية في رمزية واضحة، التزامه بـ “دبلوماسية متجذرة في القيم الديمقراطية الأميركية. ورحب محللو بيلتواي ودبلوماسيون سابقون بالخطاب باعتباره “بلسما لهؤلاء الذين اصابهم مس من اليأس” في سنوات حكم ترمب، و”إعادة ضبط جوهرية” تجسد “الوضوح الأخلاقي”.
رغم ذلك، يمكن فهم هذه الالتزامات على أنها جزء من قواعد اللعبة القديمة للتنافس بين القوى العظمى. فبايدن يدعم التحالفات التقليدية للولايات المتحدة لاحتواء، أو حتى لمواجهة، روسيا والصين. وبينما وعد الرئيس الأميركي بـ “إعادة ضبط العلاقات” مع الأنظمة السلطوية، إلا أنه استمر في بيع الأسلحة إلى الدول التي كان ترمب تفاوض معها بهذا الشأن، فيما يبدد أي تصور عن مقاربة جديدة “متجذرة في القيم الديمقراطية الأميركية”.
(يُتبع)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*هذه المادة مترجمة. يمكن مطالعة النص الأصلي باللغة الإنجليزية من هنا