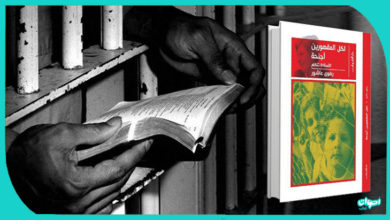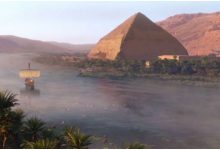مشهد بات مألوفاً في كل من الضفة الغربية وغزة المحاصرة في فلسطين٫ شبان وفتيات يحملون كماً من اطارات السيارات٫ يسيرون بها الى مكان عال ثم يشعلون فيها النار وسط تكبير وتهليل وصياح.
و ربما يتبادر لأحدهم أن يربط شعلة في طائرة ورقية ويطلقها في سماء بلاده٫ فتهبط في أحد مغتصبات العدو لتحرق حصاد مزارع العدو المقامة على أراض صٌودرت وانتزعت عنوة من أهل البلاد.
بات هذا الأسلوب النضالي٫ القليل التكلفة والمبتكر للغاية٫ معروفاً اعلامياً باسم “الإرباك الليلي” وبات ايضاً سبيل من لا يملكون السلاح على طريقة غزة في مقاومة ومقارعة المحتل.
وفي رأيي المتواضع٫ فإن هذا “الإرباك” على بساطة الوسائل المستخدمة لتحقيقه لا يقل في أهميته اطلاقاً عن النضال المسلح٫ ذلك أن كليهما يقاوم جوهر مشروع المحتل.
https://www.youtube.com/watch?v=YLtXRCyQZJA
للأرض أصحابها
إن المقولة الأساس في المشروع الصهيوني هي اعتبار فلسطين “أرضاً بلا شعب” وبالتالي فإنها مهيأة لاستقبال “شعب بلا ارض” ولكن الصهاينة كانوا يدركون تماماً أن في الارض شعباً وان هذا الشعب لن يتنازل عنها مهما كانت الأسباب ومهما كانت فداحة التضحيات التي يقدمها لاستردادها
ولعل هذا تحديداً ما أدركه «ماكس نوردو » وهو من أقرب أصدقاء مؤسس الحركة الصهيونية ثيودور هيرتزل ، حين سعى الى أن يقنع بعض رجال الدين اليهود الأوروبيين المترددين بالمشروع الصهيوني ، حيث اقترح أن يتم إرسال اثنين منهم إلى فلسطين ، لكي يشاهدا الأوضاع هناك بشكل مباشر ، ثم يعودان ليقدما تقريرهما عن حقائق الأوضاع هناك.
تجول المبعوثان في فلسطين لفترة ثم قاما بإرسال برقية إلى «نوردو » يقولان فيها بالرمز : « إن العروس جميلة جدا ، وهي مستوفية لجميع الشروط ، لكنها متزوجة فعلاً » في اشارة واضحة الى ان هناك شعباً في هذه الأرض وأنها ليست صحراء خاوية كما صورها الصهاينة.
أدرك المحتلون أنه لا سبيل للتخلص من “زوج العروس” سوى باستخدام اقصى درجات العنف بهدف التهجير القسري للسكان وهو ما تم في عام ١٩٤٨ وفق خطة صهيونية منظمة وصفها المؤرخ إيلان بابيه بأنها “جريمة تطهير عرقي”.
إلا أن من بقي في أرض فلسطين سواء في الداخل المحتل أو من لجأ منهم إلى الضفة او الى قطاع غزة والذي يشكل اللاجئون ثلثي سكانه بقوا “صداعاً” مزمناً للصهاينة فهم تذكير مستمر بأن “زوج العروس” ما زال موجوداً وأنه لازال يطلب عروسه الجميلة رغم كل ما مر به.
وزاد موقف الصهاينة تعقيداً عقب احتلالهم الضفة الغربية و قطاع غزة كنتيجة مباشرة لعدوان سنة ١٩٦٧ الذي يعتبرونه انجازهم العسكري الأبرز والأكبر٫ حيث وجد الجيش الصهيوني نفسه يلعب دور شرطي مهمته قمع ملايين من البشر وهي أمر لا يٌوكل عادة للجيوش ومما يزيد هذا الدور صعوبة هو أن الجيش بات مسؤولاً عن تأمين كتلة استيطانية تعيش على أرض مغتصبة وتتمسك بأساطير تلمودية لتبرير وجودها على هذه الأرض.
هنا تبرز أهمية هذا الإرباك الذي يمارسه الفلسطينيون بشكل يومي٫ فهو بمثابة تذكير متصل للجيش الصهيوني والمستعمرين ان للأرض أصحاباً وان الحياة على حسابهم ليست ممكنه او على الاقل ليست ممكنة دون ثمن باهظ يدفعه المحتلون وفي كل الأحوال لن تكون حياه هانئة أو حتى هادئة.
إن هذا الارباك يسحب بشكل متزايد من رصيد الأمن الذي ينبغي أن يتوافر لمشروع إحلالي مثل المشروع الصهيوني والذي يحرص الساسة الصهاينة على توفيره او على الاقل التظاهر بتوفيره لجمهور المستعمرين – وجلهم من المتعصبين دينياً – لكي يضمنوا أصواتهم في اية انتخابات تشريعية٫ وبالتالي فإن استمراريته حتى وإن كان -كما يراه المستعمرون- مجرد “ازعاج” يومي هو في حد ذاته فعل مقاوم.