ما هي الحضارة؟، وما علاقتها بكل من الثقافة والمدنية؟!.. ما دلالاتها المجتمعية؟!، وهل هي عامة بالمجتمع الإنساني ككل، أم خاصة بكل مجتمع؟!.. ثم، وهذا هو الأهم، كيف يبدو من خلالها تفاعل وتأثير العوامل الحاكمة للتطور الإنساني، وهي العوامل التي تتمثل في ثلاثية: الإنسان (المجتمعات وعلاقاتها في الداخل ومع الآخرين)، والمكان (الجغرافيا)، والزمان (التاريخ)…(؟!).
ليس هناك ثمة اتفاق على دلالة كلمات الحضارة والثقافة والمدنية، أو على الفارق بينها، إذ كثيرًا ما تستعمل كمترادفات في الدراسات التاريخية، حتى ليمكننا القول، بأن ثمة افتراضًا عامًا يقضي بأنه لا حاجة بنا إلى تعريف “الحضارة”، ما دام الإنسان قد امتلكها هي نفسها؛ ومن ثم، يحدث كل ما نراه من خلط هائل بين المصطلحات.
هدف الخلط المتعمد
إن ذلك الخلط المتعمد، من جهة، بين الحضارة والمدنية، بوصفها مجرد التقدم المادي يهدف، في ما يهدف إليه، إلى جعل العالم يألف فكرة نوع من الحضارة، هي الحضارة “الاقتصادية”، أو تحديدًا “حضارة التصنيع”؛ كما يهدف إلى إلباس الكلمة بلباس أخرى ذات معنى تاريخي. ومن ثم، تكون محاولة التمييز بين الحضارة والمدنية غير مبررة. لا شيء في تاريخ كلمة “حضارة” يوضح مجرد المحاولة، محاولة الفصل، أو التمييز بالأحرى.
حقًا، إن “حضارة التصنيع” تدين للغرب بالكثير؛ ولكن، متى تكونت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا (العظمى) وفرنسا؛ وكذلك، متى تكونت تلك النواحي المكونة لألمانيا، وتلك الأخرى المكونة لإيطاليا(؟!).

إن “الغرب”، بمفهومه المعاصر، لم يحقق هذه المرحلة من “حضارة التصنيع” إلا لأنه ورث خبرات زاخرة وتراثًا علميًا تجمع عبر العصور ـ وأحسن استخدامه، وتطويره، قطعًا ـ من عطاءات وشعوب انقرضت في الزمان (السومريين، الفنيقيين،..)، وأخرى تجمدت في المكان (الفرس، العرب،..).
من هذه الوجهة، يمكن التأكيد على أن نسبة الحضارة إلى أمة أو أمم معينة (الغرب تحديدًا)، لتختص بها دون غيرها، وعلى الأمم والشعوب الأخرى التعلق بها لاكتسابها.. كذب على التاريخ، وتزييف للواقع؛ إنه احتكار لا إنساني يدفع بقية البشر إلى “التشيؤ”، وليس ذلك ـ في الواقع ـ إلا نفيًا للحضارة، إذ “يَنفُسها” بعد أن يفرغها من محتواها.
أما عن الخلط المتعمد، من جهة أخرى، بين الحضارة والثقافة.. فهو خلط يمتد إلى سبعينات القرن قبل الماضي (القرن التاسع عشر)، عندما اختار “إدوارد بيرنت تايلور” (Edward B. Tylor)، أن يقدم لنا، في مطلع كتابه “الثقافة البدائية، 1871” تعريفه الشهير الشائع.. الذي يقول فيه: “الثقافة أو الحضارة، بمعناها الإثنوجرافي الواسع، هي ذلك الكل المركب الذي يشمل المعرفة والعقائد والفن والأخلاق والقانون والعرف وكل القدرات والعادات الأخرى التي يكتسبها الإنسان من حيث هو عضو في المجتمع”.
هنا نجد أن تعريف تايلور، رغم أنه لا يتضمن تفرقة بين الحضارة والثقافة، مايزال هو السائد حتى الآن؛ إذ إن الكثير من الكتابات تستخدم هذا التعريف صراحة أو ضمنًا، ومنها، بالطبع، بعض الكتابات العربية، إلى الدرجة التي باتت معها محاولة الإجابة على التساؤل: “ما الحضارة؟”، مشكلة يصعب حلها.
كيف نحل هذه المشكلة.. إذًا؟!
نسق معرفي مركب
لنقل، بداية، إن “الحضارة” في لغتنا وتراثنا العربيين من: “حضر، يحضر، فهو حاضر”.. فمن “يحضر”، وكيف “حضر”، ولماذا أصبح “حاضرًا”(؟!).
يتناول أحد الباحثين، مفهوم الحضارة ونقطة بدئها في تراثنا العربي، في كتابه: “الإسلام والعروبة والعلمانية، 1981″، حيث يؤكد محمد عمارة على أن: “الحضارة.. هي ذلك الطور الأرقى الذي بلغه الإنسان العربي عندما تجاوز حياة البداوة، فاستقر وتوطن، وأصبح حاضرًا في المكان؛ الأمر الذي صحبه امتلاكه لقيم ونظم وعادات وأعراف وأفكار وعلوم مثلت بناءه الحضاري”. ثم، يضيف قائلًا: “ففي مقابل البداوة والترحال، كانت القرية والمدينة حاضرة متحضرة”.. إذ إن: “الحضارة والبداوة نمطان متمايزان، بل ومتقابلان في كل الميادين تقريبًا”.

لدينا أسباب تحملنا على ألا نقبل مفهوم الحضارة هذا، على إطلاقه.. من بينها: أن الباحث قد نسب الطور الأرقى إلى “المكان”، عندما استقر الإنسان العربي وتوطن؛ وهنا نسأل: إذا كان هذا “الطور الأرقى” هو “فعل” ذلك الإنسان العربي، فما هو الذي سبق هذا الفعل(؟!).. ومن بينها: إذا كان هذا الاستقرار والتوطن قد صاحبه بناء حضاري، تمثل في “القيم والنظم والعادات…”؛ فالتساؤل هنا: هل “ابتدع” الإنسان العربي هذا البناء الحضاري فاقتصر عليه عندما استقر وتوطن، أم أنه قد “تطور” في “الزمان” فاستطاع أن يبلغ ذلك “الطور الأرقى” عندما استقر وتوطن وأصبح “حاضرًا” في “المكان”، من ناحية؛ ثم، عن طريق “إنماء” تلك “القيم والنظم والعادات…”، التي كانت تعوقه عن تطوره، من ناحية أخرى.. وهكذا امتلك بناءه الحضاري(؟!).
ما يدل على هذا الذي قلناه من قبل، وما نود أن نقوله من بعد، هو ما قاله الباحث نفسه، في موضع آخر من كتاباته.. ففي معرض حديثه عن الإنسان في مصر القديمة، وفي كتابه “الغزو الفكري وهم أم حقيقة؟، 1989″، يقول محمد عمارة: “لقد بلغ من العلم بالكيمياء حدًا اخترع به الألوان التي لا تزال زاهية حتى يومنا هذا، وفي الطب درجة ضمنت، بالتحنيط، أرقى درجات الخلود النسبي التي تحققت للأجساد عبر التاريخ كله والحضارات جميعها. وفي الهندسة والفلك والميكانيكا، الحد الذي تجسد في الأبنية المعجزة التي ترمز لها الأهرامات. وفي الزراعة، والصناعة، والتجارة، والفنون، والفلسفات، والأدب، درجات عرفنا من أخبارها طرفًا لا يزال يثير العجب والإعجاب، وجهلنا منها أكثر الكثير”.
وتكون هذه هي أولى الخطوات في التعرف على: “ما هي الحضارة؟!”..
فـ”الحضارة”، إذًا، تؤشر إلى: “نسق معرفي مركب”.. بمعنى: “نظام معرفي وليست شخوصًا خارج الإنسان”؛ إذ، إن كل ما هو خارج الإنسان من تراث “فكري” أو “فني” وصروح (مادية)، هي “آثار” حضارته ودلائلها ورموزها. وبينما يترك كل جيل في كل مجتمع “آثارًا” باقية تجسد الحضارة وتدل عليها وتحكي تاريخها.. تبقى الحضارة “مجموعة من المعارف” لا يجدي حصر عددها، ولا يمكن.
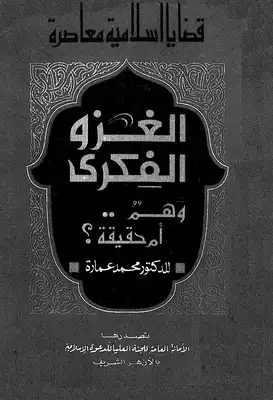
لا يجدي، لأنها مجموعة من المعارف تختلف كثيرًا أو قليلًا، وقد تتناقض، من مجتمع إلى مجتمع؛ وبالتالي، لا تكون محاولة حصرها مجدية ـ حتى إذا كانت ممكنة ـ إلا منسوبة إلى مجتمع معين.. ثم، إن حصرها غير ممكن، لأنها مالا حصر له من المعارف. أقصى ما يمكن أن يقال عنها: إنها معرفة قواعد سلوك مميزة ما بين الصواب والخطأ، في التعامل مع الأشياء والناس والوجود الشامل الأشياء والناس معًا.
في هذا السياق، سياق التعرف على “ما هي الحضارة؟”، يمكن أن نتقدم خطوات عدة في محاولة التوصل إلى تعريفها، أو: تحديد مفهومها.
الحضارة الثقافة المدنية
يقال، عادة، أن للإنسان علاقتين: إحداهما بالطبيعة، وثانيهما بالمجتمع؛ وتدور الدراسات، عادة، على أحد المحورين، أو عليهما كليهما. إلا أنه، وكما يؤكد عصمت سيف الدولة في كتابه: “عن العروبة والإسلام، 1986″، فإن هذا القول قاصر: “يحتاج لكي يكون مكتملًا، إلى إضافة علاقة الإنسان في الطبيعة وفي المجتمع، بالزمان؛ لأن تفاعل الإنسان مع الطبيعة ومع المجتمع ينتج حصيلة (إنتاج زراعي وصناعي، وأدوات إنتاج، ونقل، ونظم، ومذاهب وعقائد، وعادات، وأخلاق.. إلخ) تتضمنهما وتتجاوزهما.. إذ، هي حلول لمشكلات تصبح بمجرد وقوعها إضافة إليهما؛ “إضافة” ذات نوعية متميزة عن الطبيعة وعن المجتمع كليهما، بما تتضمنه من خلق الإنسان وإبداعه”.
وبالتالي، فإن النظر إلى الإنسان، في الطبيعة وفي المجتمع، في الزمان.. هو “نظر” إلى ما يسمى الماضي أو: “التاريخ”، أو: ما يمكن تسميته “الظروف”، لتكون شاملة الطبيعة والمجتمع والإنسان نفسه، وما تحقق بتفاعل كل هذا على مدى الزمان الذي انقضى وأفلت بانقضائه من قابلية الإلغاء.
ولكن.. ما علاقة ذلك بـ”الحضارة”(؟!).
العلاقة واضحة، إذ تكفي الملاحظة المجردة من أي علم، لنعرف أن تفاعل الناس مع الناس “مع الطبيعة”، ينتج حصيلة “مجتمعبة مادية” (إنتاج زراعي، إنتاج صناعي، أدوات إنتاج، مبان.. إلخ)، وتفاعل الناس مع الناس “في المجتمع”، ينتج حصيلة “مجتمعية معنوية ” (أفكار، مذاهب، نظم، قيم، تقاليد، فنون.. إلخ).. وعلى ذلك، فإن النظر إلى هذه الحصيلة من تفاعل الإنسان مع الطبيعة ومع غيره في المجتمع، هو “نظر” إلى ما يسمى “الحضارة”.
فإذا أضفنا إلى ذلك استقرار الشعوب على أرض خاصة، بما يعنيه ـ الاستقرار ـ من توافر وحدة اللغة ووحدة الأرض المشتركة؛ وبما يعنيه، أيضًا، من أن الطبيعة قد تحددت بأرض معينة متميزة عن غيرها (وليست ممتازة)، وأن الناس قد تحددوا بشعب معين متميز عن غيره (وليس ممتازًا)، كان مؤدى هذا التحديد: إن حصيلة تفاعل الناس مع أرضهم الخاصة، وفي ما بينهم، ستكون متميزة في مضمونها “المادي” (أو: المدنية)، و”المعنوي/الفكري” (أو: الثقافة) عن غيرها، أي تكون متميزة “حضاريًا”.
الحضارة، إذًا، هي: “المضمون المعرفي، ماديًا وفكريًا، لحصيلة تفاعل الإنسان مع الطبيعة ومع غيره، في مجتمع معين في مرحلة زمنية معينة”.
وهي على هذا الوجه، تمثل “جزءًا من تكوين الشخصية”، في كل جيل من كل مجتمع. وبالتالي، يكون الإنسان من كل جيل حاملًا حضارته من الماضي، و”منميها جدليًا”، فناقلها إلى جيل مقبل. فمن خصائص الحضارة، من ثم، انتقالها من جيل إلى جيل، عن طريق اللغة (التي تلعب الدور الأساس في هذا الانتقال)، في ما يقال له “تواصل الأجيال”.
ولا عجب، والحال هذه، أن يكون لكل مجتمع حضارته المتميزة، إنه “التمايز” الذي يطلق عليه البعض “الخصوصية الحضارية”.. بيد أننا نسارع إلى القول، بأن كون جماعة ما من الناس تمثل مجتمعًا ذا خصائص حضارية متميزة، لا يعني ـ ولا يمكن أن يعني ـ أن هذا المجتمع ليس جزءًا من حركة المجتمع الإنساني كله.
بعبارة أخرى، لا يعني التمايز الحضاري، أبدًا، انعزال هذه الحضارة عن حضارات الأمم الأخرى؛ كما لا يعني، أيضًا، أن تذوب هذه الحضارة في حضارات المجتمعات الأخرى. وما هذا الرصيد الإنساني (الحضاري)، إلا محصلة عطاء روافد الحضارات المتعددة.
بل، من المفروض، إن حضارة أي مجتمع إنما تُثري نفسها بالاحتكاك والتفاعل مع الخصوصيات الحضارية للمجتمعات الأخرى، وهو ما يمكن تسميته بـ”التفاعل الحضاري”، أو: “الاتصال الحضاري” بالأحرى.









