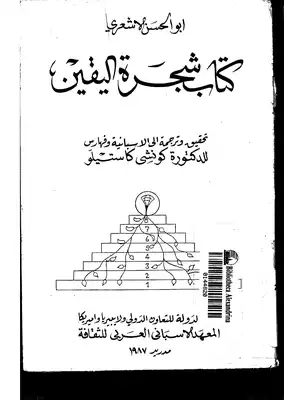لعل أول ما يلفت النظر، في ما يخص الأشعري، أبو الحسن علي بن إسماعيل (260 ـ 324 هـ) أنه كان أول متكلم سني في الإمامة، وذلك بالمعنى الذي كان لـ”الكلام” في عهده، أي بوصفه خطابًا مبنيًا على أصول ومقدمات توضع وضعًا، أو تستمد من الشريعة بكيفية من الكيفيات.
ليس هذا فقط ما يلفت النظر في ما يخص الأشعري؛ ولكن يلفت إليه أيضًا، آراؤه؛ ليس فقط لأنها كانت الأساس الذي استطاع أهل السنة بناءً عليه، تشييد نظريتهم في الخلافة؛ ولكن إضافة إلى ذلك، لأنها كانت قد نتجت عبر محاولته إثبات الشرعية الدينية لإمامة الخلفاء الأربعة الراشدين.
الأشعري والتحول الفكري
والواقع أن محاولة الأشعري هذه، التي تبدت بوضوح من خلال كتابه “الإبانة عن أصول الديانة” هذه المحاولة قد اعتمدت على الأصول الأربعة التي حددها الشافعي، أي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وربما تجدر الإشارة هنا، أن الشافعي هو واضع أصول الفقه، بل قواعد المنهج لفكر أهل السنة؛ بيد أن الواجب تثبيته هنا، هو التحول الفكري الذي طال أبا الحسن، ويعتبر من الوقفات التاريخية في حياته.

فمن الفكر الاعتزالي إلى الخروج منه، أو عليه بالأحرى، لم يكن تحولا في حياة الأشعري وحسب؛ بل كان –دون مغالاة– ضمن المؤثرات الرئيسة في الحياة الإسلامية الاعتقادية، لما كان لذلك من أثر في الصراع المذهبي، بين القوى الفكرية الإسلامية على تحرير العقيدة؛ تحريرها من الصراع الذي يعتبر المعتزلة فيه أوضح القوى وأكثرها فاعلية.
وهو ما يبدو بوضوح في كتاب “الإبانة” الذي صنفه الأشعري نفسه، على مذهب أهل السنة في مسائل علم الكلام التي خالف فيها المعتزلة، مثل قضية خلق القرآن، ومسائل أفعال العباد، والقدر.. فضلًا عن قضية الصفات الإلهية، التي تأتي ضمن أهم القضايا الخلافية بين الأشعري والمعتزلة.
هذا رغم كون ذلك الخلاف –في نظرنا– خلافًا في الطرح وليس في المضمون. فهو لم يتعرض لتنزيه الله سبحانه عن الصفات الموهمة للتجسيم؛ كالعين والوجه واليد ونحوها؛ وإنما جادل المعتزلة الذين ينكرون أن الصفات شيئًا زائدًا على ذات الله، فأثبت أن الله عليم بعلم هو غيره، وسميع بسمع هو غيره، وبصير ببصر هو غيره، وهكذا في بقية الصفات. وبالتالي، لم يزد أبو الحسن شيئًا سوى الاستفادة من أسلوب المعتزلة الجدلي.
إلا أن هذا لا يعني ولا يمكن أن يعني، أن ثمة ملامح منهجية لدى أبي الحسن، تأتي في مقدمتها أنه يميل إلى اعتبار واعتماد النص الشرعي وتقديمه على العقل في الشرعيات. وبحسب رؤيته فإن الاعتماد على العقل وحده في مسائل الإيمان “قد يؤدي إلى الزلل والضلال” ومن ثم فهو يقول بتقديم الشرع على العقل، كما إنه يقول بأن الإيمان بالله وصفاته وبالملائكة وبالغيبيات عمومًا، ومنها مسائل البعث والحساب والجنة والنار، وغيرها مما يسمى في علم الكلام بالسمعيات، هي كلها أمور توقيفية لا مجال فيها للرأي أو الاجتهاد.

الأشعري وشرعية الخلافة
والأهم في هذا المجال هو مفهوم الكسب الذي وضعه الأشعري، في محاولة منه للتوفيق بين رأي المعتزلة في أن “الإنسان هو خالق أفعاله” وبين رأي من يرفضون قولهم، في نسبة خلق الأفعال إلى الإنسان.. فقال في محاولته التوفيقية هذه؛ بإن الإنسان لا يخلق أفعاله، وإنما هي من الله، ولكنه يكسب نتائجها “إن خيرًا فخير، وإن شرًا فشر” بمعنى إن الإنسان مسؤول عما يفعل. وقد أصبحت مقولة الكسب الأشعرية، ضمن أهم القواعد التي اعتمدها اتباع الأشعري، وغدت مرتكزًا للمذهب الأشعري بعد ذلك.
وإذا كان أبو الحسن، في كتابه “الإبانة” وكما سبقت الإشارة، قد حاول إثبات الشرعية الدينية لإمامة الخلفاء الراشدين؛ ومن خلال اعتماده الأصول الأربعة للشافعي، نجده يلجأ إلى القرآن أولًا، ثم ينتقل مباشرة إلى الحديث، لإثبات أن النبي (عليه الصلاة والسلام) أخبر بأن الخلفاء من بعده أربعة. والحديث الذي يسوقه للدلالة يقول “الخلافة في أمتي ثلاثون سنة، ثم ملك بعد ذلك”. ثم يُضيف الأشعري قول راوي الحديث “أمسك خلافة أبي بكر وخلافة عمر وخلافة عثمان ثم.. أمسك خلافة على بن أبي طالب.. قال (الراوي الثاني للحديث) فوجدتها ثلاثون سنة”.
بعد ذلك ينتقل إلى الاستشهاد بإجماع الصحابة على مبايعة أبي بكر، ثم يقرر “إذا ثبتت إمامة الصديق ثبتت إمامة الفاروق عمر، لأن الصدّيق نص عليه وعقد له واختاره لها، وثبتت إمامة عثمان بعقد من عقد له الإمامة من أصحاب الشورى، وثبتت إمامة علي بعقد من عقدها له من الصحابة أهل الحل والعقد”.
ولا يتوقف الأشعري عند هذا الحد، بل يتابع اعتماده للأصل الرابع من الأصول الأربعة، نعني الاجتهاد، الذي جعله الشافعي مرادفًا للقياس، فيقول “فأما ما جرى بين علي والزبير وعائشة رضي الله عنهم أجمعين، وعلي الإمام فإنما كان عن تأويل واجتهاد، وكلهم من أهل الاجتهاد.. وكذلك ما يروى عما جرى بين علي ومعاوية رضي الله عنهما تأويل واجتهاد”.
الأشعري وعلم الكلام
وفي ما يبدو، فقد أرسى الأشعري أسس نظرية الخلافة عند أهل السنة، أو على الأصح قام بتنظير المواقف السياسية السابقة لهم، بالارتكاز على أصول الشافعي؛ فجعل من الكلام في السياسة تشريعًا لمواقف ماضية، مثلما جعل الشافعي من الاجتهاد أو القياس، أصلًا من الأصول الأربعة للفقه، الذي كان هو واضعه.
وهكذا أكمل صاحب “الإبانة” ما قصَّر فيه صاحب “الرسالة” على الأقل، من منظور أن الحاجة إلى التشريع للماضي لم تكن قد طُرِحت في عهد الشافعي، بنفس الإلحاح الذي طُرِحت به في عهد الأشعري.
ومن ثم لا نغالي إذا قلنا إن أبو الحسن الأشعري كان الإمام السني الذي ارتفعت على يديه منهجية أهل السنة، إلى مستوى التحديات التي فرضها قيام الدولة الفاطمية في مصر، وتعاظم تأثيرها على بعض الأقاليم المشرقية. لقد كان الأشعري إمام المتكلمين بتعبير ابن خلدون هو من قدر له أن يتم ذلك على يديه.
ولعل ما هو جدير بالإشارة هنا، أن اتباع صاحب “الإبانة” قد قاموا من بعده بامتصاص منهج المعتزلة، أي الإطار العقلاني لتفكيرهم، امتصاصًا تامًا. بل ربما كان اهتمام الأشاعرة بالتنظير لهذا المنهج –منهج المعتزلة– في “قياس الشاهد على الغائب”، أعمق وأوسع. والحق، أن أي مذهب في الإسلام، فقهيًا كان أو عقديًا، لم يعرف ذلك التطور الذي عرفه تفكير الأشاعرة.
إذ باعتمادهم لمنهج “قياس الشاهد على الغائب” والتنظير له أصبح علم الكلام (الأشعري) يتألف من قسمين، تبرهن قضايا الأول منهما على قضايا الثاني القسم الأول هو دقيق الكلام، أي “ما ينفرد العقل به” وهو المسلمات والنظريات التي تخص عالم الطبيعة (الشاهد). أما القسم الثاني، فهو “جليل الكلام”، أي “ما يفزع فيه إلى كتاب الله تعالى” وهو العقائد الدينية التي ما وراء عالم الطبيعة (الغائب).
والواقع أن ذلك التطور والتنظير، الذي طال منهج “قياس الشاهد على الغائب” لم يكن ليتم إلا لولا اللبنة الأولى التي وضعها أبو الحسن الأشعري بمساعدة من “الأصول الأربعة” للشافعي.