في وقت ظن فيه أن الفلسفة العربية الإسلامية ماثلة إلى زوال، بعد أن قارب معينها أن يجف بعد وفاة ابن رشد؛ ولد في تونس الطفل العبقري عبد الرحمن بن خلدون (732 ـ 808 هـ) ليقدم الدليل الحي، من خلال مقدمته الشهيرة، التي كانت بشهادة “أرنولد تونبي” من أعظم الكتابات التي أبدعها إنسان في كل مكان وزمان – على أن العبقرية العلمية العربية قادرة على تجاوز علماء اليونان وإبداعاتهم.
وإن كان علماء الإسلام في الطب والفلك والبصريات، قد استطاعوا بمنهج استقرائي، وبكشوف عظيمة، تجاوز ما قدمه الإغريق في هذه المجالات بمراحل، فإن ابن خلدون قد حقق قدرًا أكبر من الإبداع والأصالة في مجال الفلسفة والعلوم الإنسانية. فكان مجددًا في الكثير منها، كما كان مؤسسًا للعديد منها. فقد أسس علم وفلسفة التاريخ، علم الاقتصاد السياسي، علم العمران (الاجتماع) ووضع أسس علم النفس السياسي، وذلك بشهادة المؤرخين المتخصصين في تلك العلوم من الغربيين والشرقيين على السواء.
العصبية وفلسفة التاريخ
ولعل أهم ما يمكن التوقف عنده هنا، هو الجانب العلمي في التفسير لدى ابن خلدون، بل عند فكرة واحدة من ذلك الجانب، وهي تلك الفكرة المحورية في فلسفته السياسية وفلسفته للتاريخ، التي بدت فيها عبقريته الفلسفية، أو قل عبقريته العلمية في استخدام المنهج العلمي في التفسير، كما بدا في تدليله عليها وعلى صحتها من خلال الأمثلة الواقعية العديدة.
إنها فكرة العصبية التي رأى فيها أساس الحكم أو الملك؛ فبها يرتفع الحكام إلى حكم دولهم، وما يسري عليها من قوانين النمو والفناء هو ما يسري على الدولة ككل، أي على كافة مظاهر التحضر والمدنية في هذه الدولة. ولقد بدأ فيلسوفنا نظريته عن العصبية بملاحظة سديدة حول الأصل في المجتمعات المدنية.
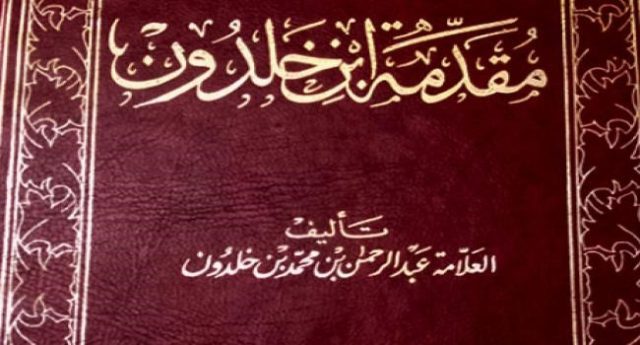
وحسب رؤيته، فإن البدو هم الأصل في العمران البشري وليس الحضر.. والبدو في رأيه هم: “المقتصرون على الضروري في أحوالهم، العاجزون عما فوقه” والحضر هم: “المعتنون بحاجات الترف والكمال في أحوالهم وعوائدهم”. وعنده أن البدو هم الأصل في العمران البشري، لأن “الضروري أقدم من الحاجي والكمالي وسابق عليه”.
بهذه الملاحظة الذكية، ومن خلال المنطق العلمي السلس، انتهى ابن خلدون إلى أن البداية كانت لتلك المجتمعات البدوية، بالمصطلح الخلدوني (الذي يقابل فيه الاصطلاح الحديث: المجتمعات البدائية).
وعلى ذلك، بدأ يميز بين خصال البدوي التي من أبرزها حسب رأيه، النزوع نحو الخير والشجاعة، وبين خصال الحضري (المتمدين) التي من أبرزها الميل نحو الدعة والترف والخضوع للرؤساء والملوك.
وعبر هذا التمييز، ومن خلال تفسيره لضرورة الانتقال من المجتمعات البدوية إلى المجتمعات الحضارية، لضرورة وجود الملك أو الحاكم أو السلطة من أجل حياة آمنة، اهتدى ابن خلدون إلى أساس ذلك الانتقال من خلال فكرة العصبية، التي تشمل كافة الروابط أو كل ما من شأنه تقوية الرابطة بين مجوعة من الأفراد “حتى تقع المنعة والمناصرة” على حد تعبيره.
العصبية وقوى المساندة
ولعل الأمر الواجب الالتفات إليه هنا أن العصبية عند ابن خلدون لا تقتصر في معناها على العصبية البدوية القبلية، بل تشير إلى قوى المساندة، تلك التي تترابط مع الحاكم في دفعه للوصول إلى الحكم. وبهذه النظرة، فإن العصبية كانت وما تزال، هي العنصر الأساس في تولي الحكم أيًا كان نوع الحكم بالمدلول الحديث، سواء كان حكمًا ديمقراطيًا دستوريًا، أو حكمًا استبداديًا. فكل من يشاء الوصول إلى الحكم لا بد من أن يرشحه حزب معين أو كتلة سياسية معينة، أو يستولي عليه بقوة عسكرية تسانده فتكون هي عصبيته.
وهكذا.. فالعصبية ليست مجرد القوة المقرونة بالتغلب عن طريق العنف، وإنما قوة العصبية تمتد من خلال الترابط بين أفرادها، أيًا كان نوع هذه الروابط ـ كما تستمد من الأخلاق الحميدة التي يتمتع بها الرئيس ومن يناصرونه في رئاسته.
ولا يفوتنا هنا، التنويه بأن فكرة العصبية كانت قد اتخذت طريقها إلى أوروبا عبر فلاسفتها، أمثال: نيتشه وميكيافيللي؛ فإرادة القوة التي ذهب إليها ميكيافيللي، باعتبارها أصل الدولة، ترادف فكرة العصبية الخلدونية تمامًا، مع فارق مهم لصالح فيلسوفنا العربي.
إذ إن ابن خلدون لم يذهب في فلسفته السياسية، كما ذهب ميكيافيللي، إلى حد إباحة العنف والقتل والخيانة إذا ما اقتضتها مصلحة الحاكم، لأنه اعتبر أن تلك أعمال شريرة، تعود على الحاكم وعلى الدولة ككل بأسوأ العواقب. ويرجع ذلك إلى أن ابن خلدون لم يفصل بين الأخلاق والسياسة، كما فعل ميكيافيللي، بل أكد على الارتباط بينهما حينما ربط بين قوة العصبية واستمراريتها، وبين قوة أخلاقها وخيرية أصحابها قائلا: “إنما الشرف والحسب هو بالخلال”.
ورغم أن فكرة العصبية هي نقطة الارتكاز، وهي أحد العناصر الأساسية في فلسفة ابن خلدون، إلا أنها ليست العنصر الوحيد. ففلسفة ابن خلدون فلسفة خصبة زاخرة، حيث تمتلئ “المقدمة” بكنوز فلسفية تؤكد أن الفلسفة العربية الإسلامية لم تتوقف عند ابن رشد، بل نستطيع القول بأنه توقف عنده تيار تبعيتها للفلسفة اليونانية الغربية، وانحصارها في مجال المباحث الميتافيزيقية والمنطقية المختلفة.
العقل وإدراك الأسباب
إن المثال الأكثر وضوحًا، الذي يمكن أن نطرحه هنا، هو حديث ابن خلدون عن دور العقل بالنسبة لعلم الكلام؛ إذ ينطلق صاحب المقدمة من أن الهدف الأسمى لهذا العلم هو التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى. لكنه يعطي له أي التوحيد معنى خاصًا لم نُصادفه لأحد قبله.. فالتوحيد عنده هو “العجز عن إدراك الأسباب وكيفية تأثيرها وتفويض ذلك إلى خالقها المحيط بها”.
هنا نلاحظ أن الغزالي وإن كان قد أنكر السببية ليترك المجال للمعجزة؛ فإن ابن خلدون ينطلق من عجز العقل عن إدراك الأسباب، كل الأسباب ليجعل التوحيد اختيارًا ضروريا؛ ذلك لأنه كما يرى لما كان العقل ـ بالتعريف ـ هو نتاج الحس والتجربة، ولما كان العالم كله عبارة عن سلاسل من الأسباب تتشعب طولًا وعرضًا، منها ما هو ظاهر ومنها ما هو خفي؛ ولما كان وجه تأثير الأسباب غير معروف، أي لا يمكن إدراكه بالعقل، فإنه من الخطأ ـ عند ابن خلدون ـ الاعتقاد أن بإمكان العقل الإحاطة بجميع الأسباب، والوصول عبر سلاسل الأسباب إلى مُسبب الأسباب.
ولذلك، ففي رأي فيلسوفنا، يجب التوجه منذ البداية إلى “مُسبب الأسباب كلها وفاعلها وموجدها” وهذا هو التوحيد المطلق. وبالتالي يبدو بوضوح تحيز ابن خلدون للمذهب الأشعري في علم الكلام؛ فهو ينطلق من السببية لإثبات مُسبب الأسباب، ثم يلغي السببية بعد ذلك.. مثله في ذلك مثل الأشاعرة عمومًا.
وهكذا.. حاول ابن خلدون أن يوضح أن الخطأ في علم الكلام إنما يأتي من كونه يزن بميزان العقل ما هو فوق طور العقل، أي حقيقة الذات الإلهية والصفات والنبوة واليوم الآخر.
ولعل المثير للتأمل أن هذا الموقف الخلدوني، يأتي على العكس تماما مع موقف ابن رشد، الذي سبق وأن أخذ على الأشاعرة موقفهم ذلك، قائلا: “فمن جحد وجود ترتيب المسببات على الأسباب في هذا العالم فقد جحد الصانع الحكيم”. وهذا صحيح من الناحية المنطقية.
وفي نظرنا، فإن ابن رشد وإن كان قد توجه عبر العقلانية إلى ما يمكن تسميته علم الكينونة؛ فإن ابن خلدون قد استطاع تأسيس علم الصيرورة في الفكر العربي الإسلامي؛ ونعني به علم التاريخ.









