جابت شهرة أبي الوليد ابن رشد الآفاق في كثير من فروع العلم.. لكن إسهامه في مجال التربية لم يحظ بالقدر الكافي من الاهتمام.. فلقد انصب اهتمام الباحثين على المنجز الفلسفي لابن رشد لكونه الشارح الأعظم لفلسفة أرسطو، وأحد أهم من درأوا بالأدلة العقلية شبهات عديدة أطلقها الفقهاء المتشددون على الفلسفة والمشتغلين بها، وزعمهم الباطل بأن مهمة المتفلسفة الأولى هي هدم المنقول بمعول المعقول.
والطريف أن الاهتمام بالجوانب التربوية، والسعي لوضع منهج جامع لأسسها السليمة – قد شغل ابن رشد مبكرا؛ قبل أن ينشغل بالفلسفة! فلقد رشّحه صديقه الفيلسوف ابن طفيل – صاحب قصة حي بن يقظان المشهورة– للخليفة الموحدي يوسف بن عبد المؤمن حاكم مراكش؛ ليكون ابن رشد عضوا في لجنة شكّلها الخليفة؛ لوضع ما يمكن تسميته بالإطار الثقافي/ السياسي لدولته، وقد وقع على عاتق ابن رشد في تلك اللجنة وضع الجزء الخاص بالتعليم والشأن التربوي.. فلما رأي الخليفة نبوغه وميله نحو الفلسفة؛ طلب منه شرح أرسطو لتقريبه إلى الأفهام.
لم يجمع ابن رشد منهجه التربوي في كتاب واحد؛ بل بثه في عدد من كتبه أهمها: “تهافت التهافت” و”جوامع سياسة أفلاطون” و”فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من اتصال” و”شرح أرجوزة ابن سينا في الطب” لما فيها من حديث عن نمو الأجنّة والعناية بها إلى الميلاد، وما يتبعه من تدبير ورعاية لكافة جوانب النمو النفسية والبدنية.
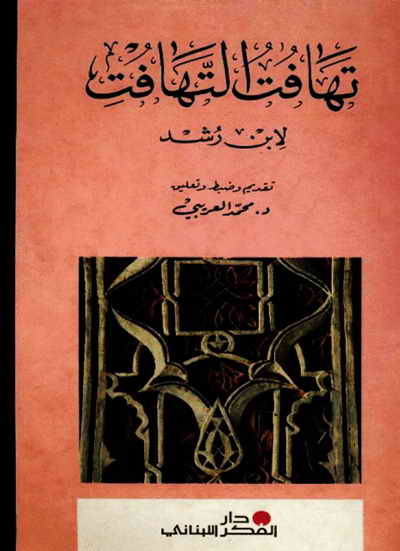
ويعتبر كتابه “جوامع سياسة أفلاطون” وهو ترجمة وشرح وتلخيص لكتاب “جمهورية أفلاطون” وفيه تعرّض لشروط المجتمع الفاضل وسبل بنائه ووقايته وطرق سياسته وتدبيره، ووظائف أفراده – هو الكتاب الجامع لأهم الآراء التربوية لابن رشد، والتي وافق فيها أفلاطون وكذلك التي خالفه فيها، وذهب إلى غير مذهبه؛ موضحا أسباب ذلك والبرهان عليه.
اهتم ابن رشد بتهيئة الناشئة لامتلاك أسباب التفكير العقلاني الذي يمكّن المرء من عرض أفكاره بطريقة منطقية تشف عن قدرة على الكشف عن أسباب الظواهر وجواهرها، ورأى أن ذلك لا يتحقق أبدا بتربية النشء بالقهر والإرهاب؛ بهدف التحكم فيهم والسيطرة عليهم؛ ليسلس قيادهم ويسهل توجيههم، كما حذّر من جذب انتباه الصبيان بالقصص الخرافية المتعلقة بمخلوقات عالم الغيب من ذوي القدرات الخارقة، لما لهذه الخرافات من سيّئ الأثر على التكوين النفسي للصبي يصير ملازما له طوال حياته “وقد يحول دون توافقه الذاتي السليم، ويعرقل اندماجه في مجتمعه ويمنعه من أداء وظيفته الاجتماعية” لما يحدثه ذلك الأثر من مخاوف تحول دون التحلي بالشجاعة الواجبة للقيام بالمهام الضرورية كالجندية ونحوها، وحذّر كذلك من القصص التي تحبب الصبيان في جمع المال واقتناء الثروات، لما في ذلك من باعث على الأثرة والجشع وألوان الطمع.. كما دعا إلى حماية الناشئة من سماع سيّئ الشعر ورديئه الذي يتضمن الدعوة إلى الرذيلة والفسق والفجور واتباع اللذات، وما يتعارض مع الأخلاق الحميدة والعفة ويهدد الفضيلة.. وقد نبّه ابن رشد إلى احتواء الشعر العربي على كثير من هذه “السواقط”.. كما أشار إلى ضرورة حث النشء على محاكاة “الشجعان والأبطال والأتقياء؛ لأن هذه المحاكاة ستجعلها- أي الشجاعة- سَجِيّة في أنفسهم راسخة عندهم” والسبيل إلى ذلك يكون بدراسة سير وتراجم هؤلاء؛ تحبيبا للنشء في حميد خصالهم.. كما يرى أن تربية الجند “وفق ما تقدم يمكّنهم من امتلاك القدرة والمهارة على القتال مع عدم السماح لهم بتملك أي شيء.. سيجعلهم قادرين على القتال بضعفي أو ثلاثة أضعاف عددهم، ويتضح ذلك جليا في الجماعات الفقيرة من أهل الوبر التي نشأت وسكنت الصحراء وملكت الجِمال القليلة.. كيف استطاعت قهر الجماعات والمدن الغنية بسرعة.. مثلما فعل العرب في ملك فارس”!

اتفق ابن رشد مع رأي أفلاطون في مسألة الغاية من التربية وهي “بناء مجتمع عادل يتألف من مواطنين أصحاء البدن والنفس” ومسئولية الفيلسوف المربي عن توجيه “الأفراد نحو الوظائف المناسبة لهم؛ حتى يقوم كل فرد بما هو أهل له” وما يتطلبه ذلك من معرفة بطبائع الأفراد، وعوامل الضبط الاجتماعي، وما يوجبه حفظ التوازن والاعتدال، وهما شرطان أساسيان في المجتمع العادل الذي يقوم على اضطلاع الفرد بمسئولية واحدة ومحددة لا يتعدّاها إلى غيرها؛ ما يكون من شانه صيانة المجتمع من بواعث الخيبة والانهيار.
وقد رأى ابن رشد أن الفضائل أربعة وهي: الفضائل النظرية (العقل الفلسفي) والفضائل العلمية (العلم وتطبيقاته) ولها الأولوية، والفضائل العملية (الأخلاق والسياسة) والفضائل الخلقية (السلوك الأخلاقي).
ويرى ابن رشد أن التربية هي وسيلة الشريعة في ضبط مسار الناس وتوجيههم، وتبصيرهم بما يضمن سلامتهم، ويحقق كمالهم. وتزويد العقل المسلم بمعاييرَ قادرة على التمييز بين الخبيث والطيب، وتشكيل معالم الشخصية المسلمة مع الحرص على تحديد الهوية الإسلامية، وإبراز معالمها وحمايتها من الذوبان في خضم الاحتكاك والتفاعل مع الثقافات الأخرى.. وهو يؤمن إيمانا مطلقا بضرورة الانفتاح على الآخر، وعدم الانعزال والتقوقع على الذات؛ ما يعتبر انحرافا في السلوك؛ تترتب عليه مساوئ وأضرار اجتماعية كثيرة.
ومن الأمور التي رأى ابن رشد أنها من أوجب الشروط للتعليم الصحيح، هو أمر الترتيب.. كما رأى أن عدم مراعاة الترتيب في تلقي العلوم– هو ما أورث البعض كثيرا من الخلل الذي وصل بهم إلى القول بتعارض المنقول والمعقول أو تضاد الفلسفة مع روح الشريعة.. لذلك ذهب ابن رشد إلى القول بضرورة الاهتمام أولا بالرياضة البدنية، والموسيقى لما لهما من أثر طيب في حفز الإحساس بالجمال في النفس الإنسانية، مع ضرورة تلازمهما؛ فالتوافق في نفس الفرد لا يتأتى إلا بهما معا “فالموسيقى بدون رياضة تحمل النفس على اللين، وتصيّرها ضعيفة وفي غاية الخمول والدعة؛ والرياضة تقوي النفس الغضبية؛ أما الموسيقى فتهذبها وتخضعها للعقل.. بل إن الشجاعة لا ترسخ في النفس إلا بالموسيقى والرياضة معا”.

وكان أفلاطون قد ذهب إلى أن الموسيقى تسهم “في غرس حب القانون في النفوس، وفي تيسيرها للعقل لإدراك الفضائل” وأنها باعثة على حب الجمال؛ لذلك نهى عن الابتداع في الموسيقى لأن في ذلك إفسادا للمجتمع وهو ما وافقه فيه ابن رشد الذي ذهب إلى التحذير من الأنغام المائعة والمعبّرة عن الحزن والخوف، مع الحرص على اختيار الأقاويل الشعرية “المحفزة للصدق المحركة للشجاعة وصواب الرأي والتقوى” مشددا على أن إفساد الموسيقى ينتهي إلى “إفساد الشرائع والنواميس”!
وبينما يرى أفلاطون أن تكون المرحلة التالية هي تدريس الحساب بوصفه “أيسر العلوم وأكثرها اشتراكا مع جميع الأشياء (تقبّلها جميعا العدّ) نجد ابن رشد يطرح المنطق بديلا للحساب، ويوضح وجهة نظره فيقول: “فهذا ما يراه أفلاطون فيما يبدأ به في التعليم، وإنما رأى هذا الرأي لأن صناعة المنطق في أيامه لم تكن قد وجدت. أما وقد وجدت هذه الصناعة التي أحكمها أرسطو؛ فإن الأصوب أن يبدأ التعليم بصناعة المنطق، ثم بعدها ينتقلون إلى علم العدد ثم إلى علم الهندسة، فعلم الفلك، ثم إلى علم المناظر، فعلم الأوزان، وبعدها إلى علم الطبيعة، ثم إلى علم ما بعد الطبيعة”.
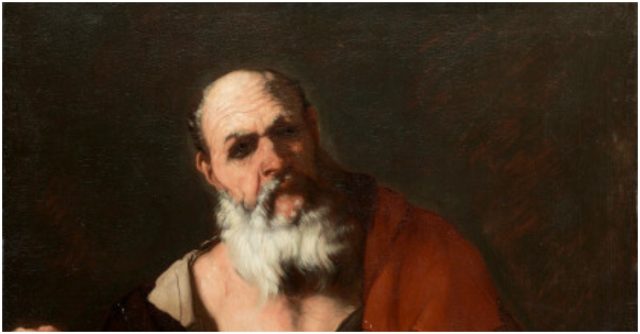
كما رَأَى ابن رشد أن الناس أصنافٌ؛ لا يصلحون كلهم للبرهان العقلي، فمنهم من وقفت به قدراته عند التأثر الخطابي، ومنهم من انتقلت به ملكاته إلى حدود الجدال دون أن يتجاوزه، ومنهم من وصل إلى النظر في الأشياء برهانيا وهم قلة، ومن هذا التصنيف ينطلق إلى أن الإقناع بالحجة لا يفيد مع كثير من الناس الذين نشّئوا على “مشهورات تخالف الحق” أو أن نظرتهم ليست معدّة لقبول البرهان من الأساس، أو أن إقناعهم غير ممكن، في ذلك الزمان اليسير الذي يراد منه وقوع التصديق فيه”.. وربما كان ذلك ما حدا بابن رشد إلى وضع نظرية أخرى في التربية “تصلح لغير الفاضلين وتسمى بطريقة التعليم بالقسر والإكراه باستعمال العقاب الجسدي”.
إن الهدف العام من التوجيه التربوي الرشدي هو أن يتصف أهل المدينة “الفاضلة” بصفات خلقية هي “الحكمة والشجاعة والعدالة والعفة” وهي صفات إذا اتصف بها الفرد انعكست على المجتمع كله، وكانت دافعا له على التقدم والازدهار، ومانعا له من السقوط في مهاوي التخلف والانحدار نحو الرذائل.. ولا يتطرق المنهج التربوي الرشدي لتلك الجوانب فحسب بل يتخطاها إلى جوانب أخرى نتعرّض لها في المقال التالي بمشيئة الله.









