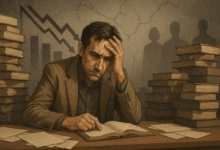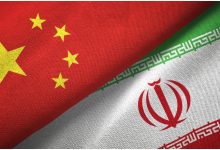دعني في البداية أعرفك بنفسي. أنا رجل متشائم. صحيح أني أعيش وأضحك. ألعب وأسافر. أتسامر وأعشق الموسيقى. لكني مع ذلك كله أبقى متشائما. ولهذا أدعوك من البداية إلى أن تلقي هذا المقال وراءك إذا كان التشاؤم لا يعجبك. لكن واجبي يحتم عليّ قبل أن أترك لك الاختيار أن أقول لك أن تشاؤمي هذا ليس فلسفيا أو وجوديا وإنما منهجي وعلمي. والفارق بين الاثنين كبير. فالتشاؤم العلمي ليس يأسا أو كراهية للحياة؛ وإنما محاولة لكي أعيشها بأسلوب متزن ومرتب، لأن هذا اللون من التشاؤم يعد أعلى وأرقى درجة من درجات ممارسة النقد والشك المنهجي اللذين هما صلب العلم وأساسه.
وأنا أيها القارئ الحمول متشائم للغاية بالتحديد إزاء المشهد السوداني. وحتى لا أطيل عليك سأكتفي بعشرة ملاحظات أضعها أمامك، يؤسفني أن أخبرك مُقدّما بأنها كلها سوداوية. لهذا أرجو لمن سيرمي المقال في هذه اللحظة في سلة المهملات أوقاتا طيبة. أما من سيواصل القراءة فأطلب منه أن يتحمل لأن ما سيقرأه قد يبقى أخف على الورق من كل ما يحتمل أن تشهده الأسابيع والشهور القادمة من عصف وعنف ومن دك وسفك.
الملاحظة رقم (1) العنف في السودان قديم جدا، لم ينفجر هكذا فجأة مع نهاية شهر رمضان، وإنما قامت الدولة السودانية نفسها منذ 1956، عليه وعلى ما نسميه في العلوم السياسية بالعنف الهيكلي structural violence، وهو أخطر ألف مرة من العنف السلوكي. العنف السلوكي مثل القتل والسرقة والتنمر والاغتصاب مصيبة. لكنه يهون أمام العنف الهيكلي الذي هو مصيبة أكبر؛ لأنه عبارة عن فكرة راسخة وقناعة مستقرة في العقل الجمعي للناس، على نحو يجعلهم يميلون إلى التفكير فيه وإلى النزوع إلى حسم أي قضية خلافية بالذراع وليس بالإقناع. والعنف في السودان، سواء قديما أو الآن، ليس مجرد مجموعة تصرفات حمقاء أو سلوكيات منحرفة أو لجوء طارئ لأدوات القوة، وإنما فكرة مستقرة في المخيلة العامة، ومفهوم بنيوي عميق كامن في صميم تكوين البلد نفسه، حيث المظالم الجغرافية والمؤسسية والتاريخية والدينية والاقتصادية والاجتماعية قديمة جدا يعود عمرها لقرون، وُجِدت قبل الدولة الحديثة التي لم تفعل شيئا غير إخفائها وراء ستار من الكلمات والشكليات لتنفخ النار فيها سنة بعد سنة، بدلا من أن تعالجها وتقضي عليها. لهذا فإن ما نراه من اقتتال حاليا في السودان يتجاوز معركة بين جنرالين أو بين فرعين مسلحين، وإنما انفجارٌ كان لا بد أن يقع لتصريف فائض العنف المؤجل منذ 2019، بدعوى استكمال فترة انتقالية أعقبت سقوط حكم البشير، كان يؤمل أن تنتهي باتفاق المدنيين مع بعضهم ومع العسكريين على مستقبل قيل إنه سيكون واعدا للسودان الجديد. لكن السودان الجديد جاء على ما يبدو مماثلا للسودان القديم وفيا بكل أسف لذلك العنف الهيكلي الكامن في جذوره وقواعده.

الملاحظة رقم (2) يقترن بذلك العنف الهيكلي المخزون، استقطاب عجيب مركب ومتشعب أشبه بسلسلة لا نهاية لها. مدنيون ضد عسكريين، وعسكريون ضد عسكريين، ومدنيون ضد مدنيين، وأصوليون ضد علمانيين، وقبليون ضد قبليين، ومناطق ضد مناطق. وقائمة طويلة من الانقسامات اللغوية والعرقية والسياسية التي تجعل التناقضات في السودان جوهرية وليست ثانوية. والتناقضات الجوهرية بطبيعتها لا تتعايش مع بعضها وإنما تنفجر مهما تأجلت في وجه بعضها. والغريب في المشهد السوداني أن التناقض بين البرهان وحميدتي ليس جوهريا وإنما ثانوي لأن الرجلين يتحاربان على السلطة وصراعهما داخل نفس المؤسسة. لكنهما مع ذلك، وبحماقة متناهية، فتحا الباب أمام كل التناقضات الجوهرية في السودان لتنفجر مع انفجاريهما. فالرجلان برغم عدائهما الشخصي المستطير تعاونا دون قصد ليفتحا بنفسيهما صندوق “باندورا” بطول السودان وعرضه أمام تناقضات قبلية واثنية جوهرية تخلع قلب أشجع رجل لو فكر في مساراتها وتداعياتها المحتملة.
الملاحظة رقم (3) الهدنة التي يتردد كل يوم الحديث عنها كلام فارغ. نعم فارغ. ولنفترض معا -على سبيل التفاؤل- أن الهدنة التي تم التوصل إليها مؤخرا برعاية الولايات المتحدة والمملكة السعودية باتت مقبولة ومقنعة وأن أطرافها ستلتزم ببنودها. لنفترض ذلك من باب حسن الظن. فهل يعقل أن يكون وزن أكبر دولة في العالم وأكبر دولة في الإقليم لا يزيد عن 72 ساعة؟ ثم يجب ألا ننسى معنى الهدنة. فهي ليست أكثر من وضع مؤقت كما أنها لا تمثل مرجعية يمكن أن تجري على أساسها أية تسوية. الهدنة في التعريف العلمي ليست جزءا من صناعة السلام وإنما هي جزء من أعمال الحرب. هي من صميم إدارة المعارك وليست لإنهائها لأنها تعقد لتعطي أطراف الصراع وقتا لتعويض الخسائر وإجراء مزيد من التدريبات ولرفع الكفاءة القتالية وإعادة الانتشار ولحشد العتاد وتحسين خطوط الإمداد وللنظر في بنك الأهداف.

الملاحظة رقم (4) الأسوأ من هشاشة الهدنة، أن السودان يبدو اليوم -بوضوح- تائها وضائعا لا يملك نموذج أو خطة عمل سياسية للتسوية. بلد كان من الطبيعي عندما تعطلت فيه آلة السياسة أن تنفجر فيه أرتال المدافع. أين هو -بالله- الإطار السياسي للحل؟ هل يعرف أحد منكم جوابا؟ لا أظن. فمن يجرؤ على التفكير في السياسة والأصابع تضغط بقوة على الزناد. الحل السياسي الآن وَهْمٌ وسيكون مرفوضا من الجنرالين معا. فلا أحد منهما مستعد ليسلم بالسياسة للآخر، والاثنان غير مستعدين معا ليسلما بالسياسة.. السياسة بأكملها إلى المدنيين ليس فقط خوفاً على رقبتيهما من المحاسبة ولكن ازدراءً منهما كذلك للمدنيين.
الملاحظة رقم (5) أنا لا أصدق أن الجنرالين خاضا الحرب لأن كلا منهما كان على ثقة في أنه سيقضي سريعا على الآخر. العكس هو الصحيح. لقد خاضا المعركة بعد أن رتبا واستعدا لها طويلا ووضعا خططا قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لعملياتهما العسكرية. للرجلان قواعد داخلية وتحالفات إقليمية وشبكة مصالح دولية يعول كل منهما عليها. ربما حلم كل منهما عندما اشتبكت قواتهما بنصر سريع، لكن كلا منهما وبحسه المتشكك في الآخر كان مستعدا لمعركة استنزاف طويلة، وربما باتا الآن مستعدين لما هو أسوأ من الاستنزاف بكثير بعد أن أصبحت بينهما ضغائن كثيرة ودماء أكثر.
الملاحظة رقم (6) بجانب العنف الهيكلي والاستقطاب الشديد، تحوَّل التاريخ السوداني نفسه من حكايات مؤلمة إلى قواعد مؤسسية حاكمة للحاضر وربما للمستقبل. فالتاريخ على أي أرض لم يعرف نزف الدماء لينساها وإنما لتكون بوصلة تحذر مما قد يجري اليوم وغدا. وتاريخ السودان تحكمه فيما يبدو قاعدة لم تتغير وهي أن المدنيين كلما حاولوا رفع رؤوسهم؛ سارع العسكريون لقطعها. فبعد أن استقل السودان في 1956، انقض الجنرال عبود بعدها بعامين على السلطة المدنية الوليدة، ليسقط هو نفسه بعد ست سنوات عندما عاد الحكم المدني للسودان في 1964. لكن ذلك لم يرض العسكر الذين قادهم جعفر نميري في 1969، في انقلاب جديد ليعيد رقاب المدنيين مرةً أخرى تحت المقصلة. ولما وصل نميري بالسودان إلى طريق مسدود، هبت ضده في 1985، ثورة شعبية أعادت المدنيين للواجهة، لكنهم كعادتهم وبسبب انقساماتهم العبثية فتحوا الباب أمام عودة العسكر للحكم في 1989، ليعيش السودان تحت حكم عمر البشير فترة ربما كانت الأسوأ في تاريخه الحديث كله. وقبل أربع سنوات تقريبا هبت ضده ثورة مدنية لم يمر عليها وقت طويل إلا واسترد العسكر من بعدها غنيمتهم التي لم يكن أحد جنرالاتهم يتخيل أنها ستعود من بعد البشير إلى المدنيين. هذا المسار الزجزاجي العجيب بين العسكريين والمدنيين يبدو كقاعدة حاكمة لتاريخ السودان. لا المدنيون يطيقون العسكريين، ولا العسكريون يقبلون بمدنية الدولة. لهذا وبعد أن انقلب المكون العسكري في 2021، على المكون المدني لم يتبق أمام العسكريين إلا شيء واحد، وهو حسم اسم رئيس السودان الجديد لواحد من بينهم. ويشهد تاريخ السودان العسكري بأن العسكريين لم يحسموا مرةً صراعاتهم عبر صناديق الانتخاب وإنما بالبنادق والحراب. وهذا تماما ما يحدث هذه الأيام، ويفتح باب التشاؤم على مصراعيه. ولنفترض جدلا أن الرجلين سيسقطان معا وأن الحل المدني سيؤخذ به، فهل سيكون ذلك هو الخلاص؟ الجواب بشكل قاطع هو “لا”. فالعسكريون ربما يقبلون بحل مدني لكن ليس عن اقتناع وإنما عن اضطرار انتظاراً إلى أن تُعمل القاعدة التاريخية السودانية الجهنمية مفاعيلها من جديد ليزيحوا المدنيين عن السلطة. الصورة -يا سادة- بائسة للغاية. فأي حل يعتمد الآن على إعادة المدنيين إلى السلطة سيؤجل فقط الأزمة ولن ينهيها طالما أن العسكريين يؤمنون بأن الدولة غنيمتهم وخصوصيتهم وملكيتهم.

الملاحظة رقم (7) كل ما في الخطاب السياسي السوداني الراهن خطير ولا يبشر بخير لأنه تصعيدي وعنيف وتوعدي ودموي. ولننسى الآن المدنيين بالكامل، فهؤلاء اليوم هم يتامى المشهد السوداني، ولنركز فقط على خطابي قوات الدعم السريع والجيش. الخطابان مترعان بالعداء والتصعيد والوعيد والتهديد، يواصلان حرق كل الجسور الممكنة حتى لو كانت بضع كلمات تخفف وتلطف لكي تبقي باب الأمل في التسوية مفتوحا. كل ما نسمعه من الجانبين لا يخرج عن اتهامات متبادلة بالغدر والخيانة والخداع والتمرد وانتهاك الشرعية والعمالة وإثارة الفوضى واللجوء إلى تكتيكات العصابات والميليشيات وبث الفرقة وإشاعة الخوف وترويع الآمنين. ولأن الحرب تبدأ بالكلام ووقفها أيضا يبدأ بتصحيح الكلام، فإن الكلام الطائش في السودان هذه الأيام لا يغذي شيئا آخر غير طيش الرصاص.
الملاحظة رقم (8) يبقى مشهد إجلاء الرعايا الأجانب مقلق بامتياز. فالسودان بلد مملوء بأجهزة استخبارات من كل أركان الأرض. وهذه تقوم بمهام عديدة من بينها اثنتين رئيسيتين: إعداد التقديرات، وبناء التحالفات. ولم يكن سحب رعايا بلدان عربية وغربية وآسيوية وأوروبية بسرعة فائقة إلا لأن التقديرات كانت سوداوية مثلها ربما مثل سوداوية هذه الورقة. ناهيك عن أن بعض عمليات الإجلاء التي تمت ستبقى -لأجل مفتوح- محلا مشروعا للاستغراب والتعجب. فلماذا بعثت بعض الدول إلى جيبوتي بعشرات الآلاف من قواتها بحجة الإشراف على إجلاء ما بين 100 إلى 150 فقط من رعاياها من السودان؟ فهذا ليس بتصرف للإجلاء وإنما أقرب لاستجلاء الحقائق قبل لحظة قد تكون مطلوبة للتدخل. أما عن بناء التحالفات فأمر أخر حققته بالفعل قوى إقليمية ودولية عندما بنت علاقات متينة مع أطراف سودانية، عسكرية ومدنية على السواء. لهذا دعك من التباكي الدبلوماسي على السودان وأحاديث التعاطف مع الحل السياسي. فهي لغة مراوغة تخفي وراء ملمسها الناعم مخططات إقليمية ودولية خشنة تشتري الوقت إلى حين. لقد استثمر الخارج في السودان في كل شيء وضده بما في ذلك الاستثمار الثقيل في النقيضين البرهان وحميدتي.

الملاحظة رقم (9) الأخطر من صخب السلاح ذلك الفراغ الهائل الذي يتسع في السودان ساعةً بعد ساعة. فالدولة تعطلت، وأصبح المواطن بلا سند أو علاج أو دواء أو ماء أو غذاء أو تعليم أو رواتب. والمواطن عنما تتلاشى أمام عينيه الدولة إلا ويعود إلى حالة الطبيعة الأولى عنيفا وشرسا ومقاتلا. لا يرى أمامه فراغ إلا ويمد يده إليه. وهو نفس ما يجري في العلاقات الدولية. فالدول ما أن ترى أمامها فراغا إلا وتتكالب وتتزاحم عليه لكي تشغله. الفراغ لا بد أن يستدعي من يملأه، والسودان بكل حسرة وأسى وهو يتفرغ لصراع داخلي مسلح إنما يفرغ نفسه لدائرة لا حصر لها من الذئاب المتربصة.
الملاحظة رقم (10) يزيد الطين بلة أن الجيش، وكل مركب القوة في السودان، وقع في مصيدة فتحوّل من عمق للبلد إلى عبء عليها. وهذا وضع في غاية الخطورة. فالجيش الذي لا يحمي وطنه إنما يجلب الذل لوطنه. فكيف بالله عليكم والسودان يقف الآن عاريا أمام العالم بلا جيش موحد أو تنسيق بين مكوناته أو قيادة متوافق عليها أو استراتيجية دفاعية مركزية أن يتصدى لأي عدو صغر أو كبر سواء من دول الجوار الاقليمي، أو من بين القوى الكبرى المتنافسة في شرق أفريقيا أو حتى أمام جماعات العنف الطائشة والمتعطشة إلى ملاذات آمنة جديدة؟ لقد انكشف السودان بكل أسف استراتيجيا، بل ودخل مرحلة تعري جيوسياسية كاملة. والتعري يجب أن يكون مُحرما في السياسة كما هو محرم في الدين لأنه يشجع كل من تسول له نفسه أن يقترب ليلامس بل ويغتصب الأوطان.
هل عرفتم لماذا أنا متشائم؟.. يا زول: احذر فبلدك قد يزول.