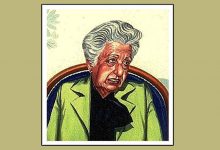في ذكرى ميلاده التي ستكمل العام القادم تسعمئة عام- مازال الفيلسوف الفقيه ابن رشد، يثير الجدل في أوساط المهتمين بالفلسفة العربية، والمناوئين لها على حد سواء.. فابن رشد هو من بنى جسر التواصل بين الحكمة (الفلسفة) والشريعة الإسلامية في كتابه فصل المقال.
ورغم أن الفلسفة -في بلادنا- صارت إلى أسوأ حال، بالنبذ والإهمال والاتهامات بمناصبة الدين العداء، والقدح في أسسه وثوابته- إلا أنها ما زالت هدفا لمزيد من كل ما سبق، وما سمعناه عن إبعادها عن المناهج الدراسية في التعليم ما قبل الجامعي، وإثارة اللغط حول وجود أقسام لها في الكليات؛ تُخرّج أعدادا كبيرة ممن لا يحتاج إليهم سوق العمل- ليس ببعيد عما طرحناه.. ليس هذا فحسب؛ بل إن بعض المتفلسفين – من بني جلدتنا- يحلو لهم الزعم بأن الفلسفة أمر غربي خالص، وأن لغتنا العربية، لا قدرة لها على حمل المعنى الفلسفي- وهو في الحقيقة افتراء على اللغة والفلسفة كلتيهما.
كنت قد تناولت أعمال ابن رشد وآراءه في عدة مقالات سابقة، واليوم ألقي الضوء على بعض من أهم ما أورده ابن رشد في كتابه “فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من اتصال”.
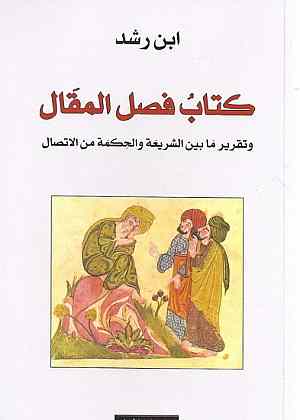
في هذا الكتاب ينبري ابن رشد مدافعا عن الفلسفة، داحضا فرية تعارضها مع الشريعة الإسلامية.. مشيرا إلى أنه ليس ثمة تعارض؛ حقيقي بل متوهم ويشرح ابن رشد ذلك قائلا: “إنَّ الحكمة هي صاحبةُ الشريعة والأختُ الرضيعة، مع ما يقع بينهما من العداوة والبغضاء والمشاجرة. وهما المصطحبتان بالطبع، المتحابتان بالجوهر والغريزة.. فالصواب أن تعلم فرقة من الجمهور التي ترى أنَّ الشريعة مخالفة للحكمة، إنَّها ليست مخالفة لها، وذلك بأن يعرف كلُّ واحدٍ من الفريقين أنَّه لم يقف على كنههما بالحقيقة، اضطررنا في “مناهج الأدلة” أن نُعرِّفَ أصول الشريعة، فإنَّ أصولها إذا وُجِدَت أشدَّ مطابقة للحكمة، مما أُوِّلَ فيها، وكذلك الرأي الذي ظن في الحكمة أنَّه مخالف للشريعة، لم يُحِط علمًا بالحكمة ولا الشريعة، ولذلك اضطررنا –نحن أيضا– إلى وضعِ قولٍ “فصل المقال” في موافقة الحكمة للشريعة”.”. لذلك فالفلسفة والشريعة هما طريقتان متكاملتان للوصول إلى الحقيقة، وأن التعارض الظاهري بينهما ناتج عن سوء الفهم أو التأويل الخاطئ للنصوص الدينية.
ويؤكد ابن رشد على شرعية الفلسفة محتجا بآيات إعمال العقل مثل قوله تعالى” فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَار” الحشر: 2، وقوله “أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ” (الأعراف: 185). فلا مانع إذن من النظر العقلي والتأمل في الكون، والتماس الحكمة الإلهية في الخلق. فالفلسفة إذن ليست بدعة؛ بل هي فرض كفاية على المسلمين المتمكنين عقليًّا.
ويذهب ابن رشد إلى أن درء التعارض الظاهر يكون بالتأويل الذي هو “إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المجازية، دون الإخلال باللسان العربي” وقد جمع ابن رشد بذلك بين “المعقول والمنقول”.
على ذلك يرى ابن رشد وجوب تأويل النص بما يتوافق مع البراهين الفلسفية، لأن الشريعة لا تُخالف العقل. مثلًا: يُؤوَّل النص الذي يتحدث عن “يد الله” أو “استوائه على العرش” تأويلًا مجازيًّا يتناسب مع البرهان الفلسفي.
ولا يرى ابن رشد أن كل الناس يصلح لتناول تلك الأمور، والناس عنده ثلاث مراتب من حيث الفهم: الجمهور العام: يفهمون النصوص بحسب ظاهرها دون تأويل. علماء الكلام (المتكلمون): يستخدمون الجدل والمنطق البسيط. الفلاسفة: يستخدمون البرهان العقلي العميق. ويجب ألا يُكشف التأويل الفلسفي للجمهور حتى لا يتسبب في التشكيك في عقائدهم.
كما يرى أن الفلسفة تُعين على فهم المقاصد العميقة للشريعة، مثل إثبات وجود الله عبر دراسة الكون، وهو ما يتفق مع الغاية الدينية.
لكن التوفيق بين الحكمة والشريعة الذي قصده ابن رشد لم يذهب بعيدا عن محاولات سابقيه، برغم محاولاته المضنية في إثبات أنَّ فهم أحدهما لا يكتمل إلا بالآخر.
وقد ألمح الكثيرون- بعد ملاحظة تلك المراوحات- إلى وجود تعارض واضح بين التراث الفقهي لابن رشد، وآرائه الفلسفية التي استفاض فيها في شروحه لأرسطو؛ لكن ذلك الأمر لا يعدو كونه فرية أخرى، إذ من الصعب التحدث عن فلسفة “أبي الوليد” بمعزلٍ عن رؤيته الفقهية والأصولية، كما أنَّه ليس من المقبول، أن تُقرأ كتب ابن رشد الفقهية دون استحضار المقدمات الفلسفية التي صدر عنها الموقف الرشدي برمته.. كما يقول د. إبراهيم بورشاشن.
“الحق لا يضاد الحق، بل يوافقه ويشهد له”. وهذا الكتاب كان محاولة جريئة لربط العقل بالوحي، وتأكيد أن الإيمان الحقيقي لا يكون إلا بفهم عميق يجمع بين نص الشريعة، ومنطق الحكمة.
رحم الله أبا الوليد فما زال فكره حاضرا وفضله غير منكور، وما زالت الحاجة إليه ماسّة، كما هي الحاجة إلى الفلسفة .. ولو كره الكارهون.