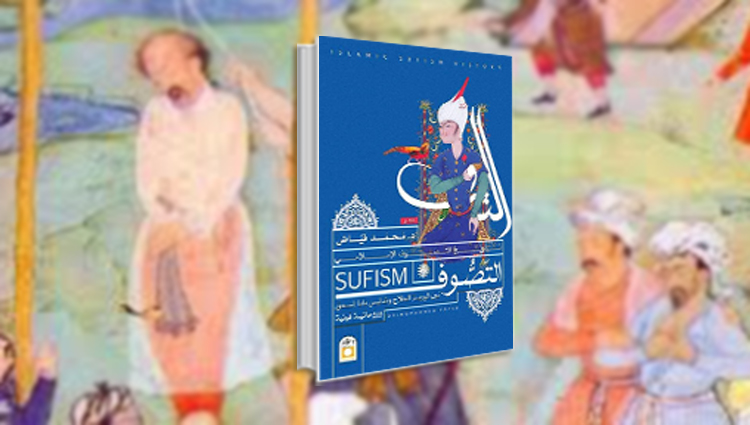روي عنه العديد من الأقوال التي كانت سببا في تكفيره، وإهدار دمه كقوله ( ما في الجٌبة سوى الله)، وزعمه حلول اللاهوت في الناسوت، وإدعاء الألوهية وغيرها من الأقوال التي شاعت عنه في زمانه، وتناقلها المؤرخون وكتاب الطبقات والتراجم جيلا بعد جيل. ورغم ذلك بقي في شخصية الحلاج شيء أو سر ما جعله قريبا من قلوب العامة والنخبة على حد سواء، وحملت السيرة الشعبية لشخصه وتجربته ما جعله فريدا متميزا حتى بين أقرانه من المتصوفة.
وقد اختلف الكثيرون حول الحلاّج حتى إنك لتجد من بين المتصوفة من أنكر عليه أقواله، كالشبلي الذي خاطبه أثناء صلبه بقوله (ألم ننهك عن العالمين) على الرغم من أنه روي عنه في موضع آخر قوله ( كنت أنا والحسين بن منصور الحلاج شيئا واحدا غير أنه أظهر وكتمت). في المقابل كان من بين كبار المتصوفة أيضا من يدافع عنه ويبرر أقواله كشيخ الطائفة الجنيد، والشيخ الأكبر محي الدين بن عربي، فهل كان ما بدر من الحلاج من كشف لأحواله ومواجيده السبب الحقيقي وراء تعرضه للقتل والصلب على ذلك النحو الشنيع الذي لم يشهد التاريخ مثله؟ أم أن قضية الشطحات هذه لم تكن سوى لبوسِ واهية لأسباب أكثر عمقا وجدية؟

هذا السؤال هو ما حاول الدكتور محمد فيّاض الإجابة عليه في كتابه (التصوف بين ثورية الحلاج وتدليس بابا إسحق وروحانيات قونية) الصادر حديثا عن دار مصر العربية للنشر والتوزيع. ففي هذا الكتاب يذهب الدكتور محمد فياض إلى أن الحلاّج كان واحدا من الشخصيات الإشكالية أو القلقة – بتعبير الدكتور عبدالرحمن بدوي- في التاريخ الإسلامي، وتتنوع إشكالات شخصيته ما بين انتماءاته الفكرية والمذهبية، وتوجهاته ومواقفه السياسية ،وعلاقته وموقفه من السلطة. بالإضافة إلى تجربته الروحية والذوقية الغريبة والتي ظلت تميزه حتى بين أقرانه من المتصوفة. وقد انتهي هذا اللغط حول شخصيته ، كما يشير المؤلف، حين اتخذ الخليفة المقتدر(295ه- 320ه) قرارا بإعدامه، فصُلب وقُطّعت أطرافه وسٌملت عيناه، وقُطعت رأسه، وأحرق جسده في واحد من أكثر المشاهد مأساوية في التاريخ، وكان ذلك سنة 309 هجرية.

الدكتور محمد فيّاض
وبحسب فياض- كان الحلاّج خطيبا مفوها، ينحاز للبسطاء والعامة الذين كان واحدا منهم، حيث كان حلاّجا ماهرا يعمل في الأسواق التي كانت بمثابة منبر له بعدما اجتذب إليه الكثيرين من العمال والحرافيش في أسواق بغداد، وقد تجّمع الناس من حوله، ولم يعد فردا، وإنما بات -كما وصف نفسه -(رأس مذهب ومن خلفه الآلاف) حتى أنه ليهدد أحد الوزراء بأن (يقلب عليه الأرض)، وبدا طوال الوقت مناوئا للسلطة.
وقد كانت سياحات وأسفار الحلاّج، والتي كثيرا ما يخرج فيها مضطرا هاربا من اضطهاد السلطة – سببا كفيلا لأن يكون له الكثير من الأتباع والأنصار لا سيما في خراسان، وما وراء النهر وسجستان وكرمان وبلاد فارس، وقد حاز في كل واحدة من تلك البلدان لقبا يؤكد توقيره وتبجيله، كحلاُج الأسرار، وأبى عبدالله الزاهد، والمغيث، وصاحب الزمان، والناموس الأكبر، ما جعل البعض يتحدث عن الحلاجية كتيار دون معرفة أهدافه، فهل كان لهذا التيار أغراض ومشروع سياسي مناوىء للسلطة؟ أم كان مجرد مجموعة من المريدين والمحبين – على عادة مشايخ المتصوفة ومريديهم- هذا مالم يتضح في الكتاب على الرغم من أن كثيرين من هؤلاء المريدين تعرضوا للاعتقال والاضطهاد في خضم سخط السلطة على سيدهم ومولاهم الحسين بن منصور الحلاّج.
بعض الرسائل السرية التي نسبت اليه وأنه أرسلها إلى أنصاره، يبدو من خلالها الحلاّج صاحب مشروع موال للخلافة الفاطمية المناوئة للعباسيين، مثلما ورد في بعضها من قوله “وقد آن الأوان للدولة الغراء، الفاطمية الزهراء المحفوفة بأهل الأرض والسماء، وأذن للفئة الظاهرة، مع قوة ضعفها في الخروج إلى خراسان ليكشف الحق قناعه، ويبسط العدل باعه”. غير أن نصوصا أخرى تقول إن الحلاج كان يدعو كل قوم بحسب معتقداتهم. وبحسب الكاتب- فإن الانتماء السياسي والأيديولوجي للحلاّج أمر ملغز، والحقيقة أن صيحته المدوية كانت تنشد عودة الناس إلى الإسلام كما جاء توحيدا صافيا، بينما قال بعض من تناولوا سيرته إنه كان داعيا لذاته وليس أداة لأحد غيره.
لكن نفوذ وتأثير الحلاج لم يتوقف عند حدود العامة بل امتد إلى بلاط الخليفة العباسي، فالسيدة “شغب” والدة الخليفة كانت متعاطفة مع الحلاج، وتدخلت في غير مره لحمايته من بطشه، وهو نفس موقف “نصر القشوري” حاجب الخليفة المقتدر، وكان يسميه العبد الصالح.. لكن من ناحية أخرى كان في بلاط الخلافة من يبغض سطوة ونفوذ الحلاّج لاسيما مواقفه المنحازة لعامة البسطاء ضد جشع الوزير الفاسد حامد بن العباس الذي اشتكى العامة من إفراطه في فرض الضرائب بالإضافة إلى ممارساته الاحتكارية ، خاصة في السنوات العجاف التي سبقت مقتل الحلاّج ،حيث كثرت المجاعات، وهاجم الغوغاء والفقراء مخازن واقطاعات حامد بن العباس، حتى أقسم على قتله بيده لو ظفر به، ولم يتوقف عن التحريض ضده عند الخليفة موغرا صدره عليه ومخوفا له من تحريك الحلاّج للعامة ضده والتآمر على ملكه حتى أذن له بقتله على ذلك النحو البشع.
وقد تعددت الاتهامات التي وجهت للحسين بن منصور الحلاّج، كالزندقة التي ربما جاء بعضها لبسا مع شخصية ملحد شهير معاصر له في زمانه يدعي (الحسن بن منصور الحلاّج)، كما اتهم بالانتماء للطائفة الزيدية الشيعية، وبكونه من الروافض على الرغم مما بين الفريقين من تعارض وتضاد فى اطار الاختلافات والخلافات الكثيرة بين الفرق الشيعية، كما اتهم بالدعوة إلى الخلافة الفاطمية سرا في مواجهة الخلافة العباسية السنية التي كان يعيش في كنفها، وبانتمائه إلى حركة القرامطة. وقد قُبض عليه وحُمل إلى بغداد في عام 301 هجري –أي قبل قتله بثماني سنوات- وأقاموه مصلوبا على جذع نخلة، ونودي بأن هذا أحد دعاة القرامطة فاحذروه.
الكتاب يميل إلى أن اغتيال الحلاّج كان لأسباب سياسية محضة سيقت لها بعض المبررات الدينية. لكن أيا ما كان الأمر فقد بقيت أسطورته تداعب خيال المثقفين والأدباء والشعراء عبر قرون طوال، فنظمت فيه القصائد، وتناقل الزهاد وأهل الطريق مخاطباته وتضرعاته، وقصائد حبه الإلهي التي لم يعرف لها مثيل، ونظمت في مأساته الدواوين والمسرحيات. بينما تغافل التاريخ الشعبي عن سيرة قاتليْه المقتدر ووزيره حامد بن العباس.