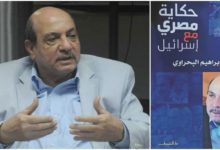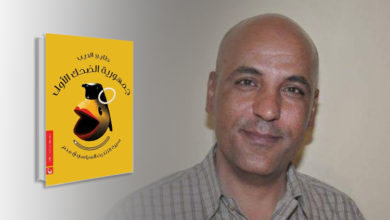محمد سيد احمد
أما بالنسبة للدكتور «أسامة الباز» فقد كان «محمد سيد أحمد» مّنبعاً لا ينضب من التحليل الدقيق للسياسة الخارجية «خارج الصندوق» كما يقول أبناء اليوم، فضلاً عن مشاركاته في الكثير من الفعاليات والمؤتمرات العالمية والدولية في العديد من عواصم العالم ومعرفته المباشرة بالمئات من دبلوماسيي الشرق والغرب على حد سواء، وكذلك إسهاماته الفكرية في صحف عالمية ومنصات إعلامية دولية مثل «لوموند» الفرنسية و«نيويورك تايمز» الأمريكية، و«صنداي تايمز» البريطانية، مما يُعد مكسباً كبيراً واطلالة حية لـ«أسامة»، والتي أعتقد أنه استفاد منها في عمله طوال حياة «محمد سيد احمد».
لكن أهم ما جمع بين محمد سيد أحمد وأسامة الباز هو طبيعة تفكيرهما، فكلاهما لم يكن أسيراً لمدرسته، فلا «أسامة» كان حبيس حجرات وكواليس وتقليدية وزارة الخارجية التي كان يعمل بها ويتقلد مناصبها الرفيعة، ولا كان «محمد» أسيرا لليسار الشيوعي المصري بالمعنى الأيديولوجي والثقافي للكلمة.

أسامة الباز
كان محمد سيد أحمد مُفكراً خارج القوالب الجامدة والعتيقة لبعض رموز اليسار الماركسي. فكتابه الرائد «بعد أن تسكت المدافع» الذي صدر في بيروت عام 1975، وضع سيناريو تفصيليا لحتمية «الصلح مع إسرائيل وإبرام اتفاقية سلام معها، وتحديداً بين مصر وخصمها التاريخي»!
لم يكن هذا التصور هو ما يتمناه، لكنه وهو الخبير بالديالكتيك الماركسي، أي المنهج الجدلي في قراءة الظواهر الطبقية والسياسية، كان يرى أن المصير سينتهي إلى ذلك. فقيادة «السادات» البراجماتي المُغامر، غير رؤية «عبد الناصر» الثائر والمبدئي صاحب المشروع الوطني والقومي، فضلاً عن تغيرات عديدة أفرزتها نتائج حرب أكتوبر على أكثر من صعيد، جميعها كانت تصب في صالح خيار التسوية واستبعاد العودة إلى نهج الحرب. وفي هذا يقول بكلمات تحذيرية، بدت سابقة لعصره وعصرها: «إن العالم يتحول بسرعة، ولا يّرحم المُتخلف، علينا أن نتعلم كيف نتصدى لما يصدمنا، وألا يشل تفكيرنا ما يواجهنا».
أما الدوافع عند «أسامة الباز»، بالاعتزاز بصداقة «محمد سيد أحمد»، فترجع إلى طبيعة عمل الأول، ففي نهاية اكتوبر عام ١٩٧٣، أو الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، ذهب الأستاذ «هيكل» إلى الرئيس «السادات» والذي كان مُقيماً بصفة دائمة في قصر الطاهرة شرق القاهرة، حيث أدار الحرب، بورقة كتبها الدكتور «أسامة» حول كيفية التعامل السياسي مع نتائج حرب اكتوبر، وكيفية التفاوض مع وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي الأمريكي «هنري كيسنجر» حيث تتلمذ الدكتور «أسامة» عَلى يديه عندما كان طالباً في جامعة «هارڤارد» الأمريكية في مطلع الستينيات من القرن الماضي للحصول عَلى درجة الدكتوراه، وعندما كان «كيسنجر» مُحاضراً بها….

محمد حسنين هيكل
وقد قدم الدكتور الباز هذا التصور الدقيق والمُحكم، الذي كتبه بخط يده إلى الأستاذ هيكل، ليقدمه بدوره إلى الرئيس السادات، قبل أيام قليلة من زيارة كانت مُقررة لـ«هنري كيسنجر» إلى مصر، وكانت الأولى من نوعها.
كانت الورقة تضم تصوراً كاملاً للمعالجة الحضارية والثقافية والسياسية للصراع مع إسرائيل بما يحقق المصالح الوطنية والقومية «كانت الورقة وثيقة» رائدة بكل المقاييس، فهي لم تقف عند حدود ما وصلت إليه النتائج العسكرية لحرب السادس من أكتوبر فقط، بل تخطت ذلك إلى آفاق أبعد، إلى آفاق التسوية بشروطها المصرية والعربية، حتى أن تلك الورقة أثارت اهتمام الرئيس «السادات»، فسأل عن صاحبها، فأجابه «هيكل» بأنه: «أحد ألمع الدبلوماسيين في وزارة الخارجية المصرية، فضلاً عن تعاونه مع الأهرام، وتحديداً مع «مركز الدراسات السياسية والفلسطينية»، كما كان يُسمىّ وقتها.
تضمنت هذه الوثيقة ثمانية جوانب منهجية تحدد كيفية التعامل مع كيسنجر، والوصول معه الى أكبر قدر من المكاسب التي يمكن تحقيقها، وستة اقتراحات هامة، وبالغة الذكاء والوضوح، من بينها الاقتراح الثالث الذي ينص عَلى:
«..لا نبدأ معه، أي مع كيسنجر، من منطلق المواقف التي قبلناها حتى الآن، وإنما نبدأ بمواقف أكثر شدة، لأن ما قبلناه في الماضي كان يتوقف على شرط واحد هو استجابة اسرائيل والتقاؤها معنا في منتصف الطريق، لأننا إذا بدأنا من حيث انتهينا حتى الآن، فسوف يتوقع منا أن ننزل الى حد أدنى.. وهكذا».

كانت تلك الأفكار التي قدمها الأستاذ «هيكل» إلى الرئيس «السادات»، نيابة عن الدكتور «أسامة» هي الأساس الذي استندت اليه وجهة نظر مصر في أول مباحثات جرت بين السادات و «هنري كيسنجر»، والتي أسفرت عما عُرفّ وقتها بـ «النقاط الست» التي تبناها الجانبان المصري والأمريكي.
لكن تلك النتائج لم تكن مُمثلة ولا مُجسدة لروح التكامل التي أرادها الدكتور «أسامة»، ولا تشّجُّع وتحمُّس الأستاذ «هيكل» لها. لقد أخذ اعلان «النقاط الست» الصادر في ٥ نوفمبر عام ٧٣ من ورقة الدكتور «أسامة» الجرأة، ولم يأخذ منها الضوابط السياسية والاستراتيجية بل والوطنية والقومية والتي شعر بمخاطرها وأدركها على الفور الأستاذ «هيكل»، وكانت سبباً في كتاباته الأخيرة والخطيرة والحاسمة التي نشرها في أعقاب الحرب على صدر صفحات الأهرام ضمن مقاله الاسبوعي «بصراحة»، والتي أوقفها السادات في الثاني من فبراير عام ٧٤ فور صدور آخر مقال له بعنوان «الظلال والبريق». كان هذا المقال والإقالة آخر عهد الأستاذ «هيكل» بالصحافة اليومية المكتوبة، فقد خرج الأستاذ ولم يعد إلى قلعته بعد ذلك اليوم، إلا بعد حين.
كانت تلك المقالات التي جمعها الأستاذ هيكل بعد ذلك في كتابه «في مفترق الطرق» بداية مرحلة جديدة في حياة «هيكل»، بقدر ما كانت ورقة الدكتور «أسامة» حول التصور الاستراتيجي للتعامل مع نتائج حرب أكتوبر، تدشيناً لمرحلة بالغة الثراء والصداقة بينه (الباز) وبين «محمد سيد أحمد».
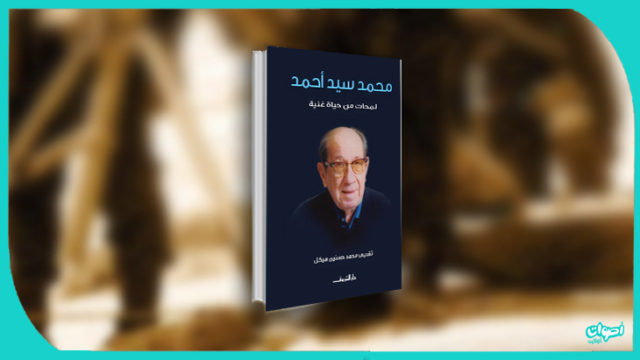
لم يكن «محمد سيد أحمد وأسامة الباز» يُمثلان هاتين المؤسستين التي كانا ينتميان اليهما بأي حال من الأحوال،فالطابع الأنيق والسلوك البرجوازي الذي حرص الاستاذ «هيكل» أن يُسبٍغُه عَلى الأهرام، لم يكن يحمل منه «محمد سيد أحمد» شيئاً، فهو البسيط في مّلبسه ومأكله، والمتواضع الى حد النُدرة، رغم انتمائه الطبقي الذي يؤهله لأن يكون بحق سليل إقطاعيي وباشوات عائلته. والحال كذلك بالنسبة للدكتور «أسامة الباز»، فرغم الانتساب لوزارة الخارجية المصرية، فلم يُعرف عنه المبالغة في الملبس أو المباهاة بوظيفته ومركزه الرفيع في وزارة ،ظلت حكراً لعقود طويلة على أبناء الباشوات وأصحاب المعالي وكبار الأسر الإقطاعية والرأسمالية، حتى جاء «عبدالناصر» وحطم التقاليد الطبقية لهذه القلعة العتيقة. فقد كان «أسامة الباز» ابن إحدى قرى محافظة الدقهلية، وسليل أسرة متوسطة الحال، هو التعبير الأخلاقي والسلوكي لهذه القرية، ولتلك الأسرة التي تنتمي الى الطبقة الوسطى بامتياز.
الأيقونتان «محمد سيد أحمد وأسامة الباز» كانا تجسيداً مُتطابقاً لشخصية واحدة، فكل منهما حمل كل صفات التواضع والبساطة في المسلك والحياة، غير أنهما كانا أيضاً، وفي نفس الوقت، تجسيداً لعقلية غير تقليدية في التفكير، وصاحبى منهج في التحليل والرؤية والاستشراف المنهجي بصورة لا يقدر عَلى منافستهما إلاّ القليل.. رحلا وبقيت سيرتهما العطرة حاضرة في الحياة والفكر.. رحمهما الله.