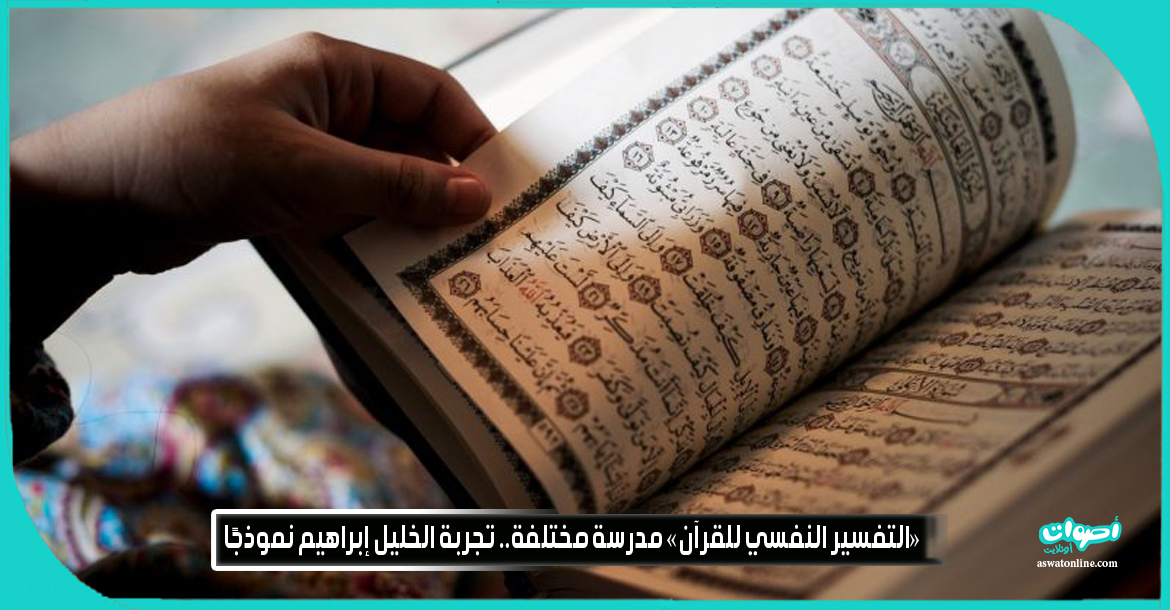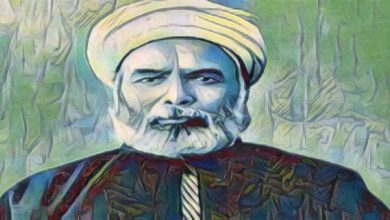في المدرسة التاريخية – وتعرف كذلك بمدرسة التفسير بالرواية أو التفسير بالمأثور – يعتمد المفسر في تفسيره للقرآن على القرآن نفسه (ما يُعرف بتفسير القرآن بالقرآن) أو على ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة، فالمفسر هنا يستند عادة إلى سلطة خارج النص القرآني، الذي لا يتكلم بذاته و«إنما يتكلم به الرجال» كما ورد عن الإمام علي ابن أبي طالب، والسلطة هنا تتمثل عادةً في الرسول صلى الله عليه وسلم بوصفه خير من يفسر القرآن، وفي صحابته رضي الله عنهم لقربهم من الرسول ومعاصرتهم زمن نزول القرآن. ومن أبرز تفاسير هذه المدرسة تفسير الطبري وتفسير القرطبي وتفسير ابن كثير .. وغيرهم.

وفي المدرسة اللسانية أو اللغوية المجازية يعتمد المفسر اعتمادًا أساسيًا على لغة النص القرآني ذاته، وطبقًا لهذه المدرسة تنقسم الدلالة اللغوية للنص إلى حقيقة ومجاز، فما كانت دلالته حقيقية لا يحتاج إلى تأويل، بخلاف ما كانت دلالته مجازية فهذا يحتاج إلى تأويل يصرف المعنى الظاهري إلى معنى آخر. ومن أبرز تفاسير هذه المدرسة تفسير الزمخشري وتفسير الرازي وتفسير البيضاوي .. وغيرهم.
أما في المدرسة الرمزية فيعتمد المفسر على التفسير الميتافيزيقي للنص خارج إطار اللغة كما يعرفها متحدثوها، كالتفسير بالإشارة لدى المتصوفة والتفسير الباطني لدى بعض الشيعة. ومن أبرز التفاسير بالإشارة تفسير ابن عربي وتفسير الألوسي، ومن التفسير الباطني تفسير الطبرسي وتفسير القمي.
وتسعى المدرسة الموضوعية إلى تحديد مواضيع عامة للقرآن يمكن تصنيف سوره وآياته طبقًا لها وبالتالي تفسيره – ومن ثم فهمه – في سياق تلك الموضوعات العامة بحيث يمكن إسقاط تلك المواضيع على كل مكان وزمان وتجديد فهمها مع تجدد الزمان. ومن أبرز التفاسير الموضوعية، أى التي تبدا من الموضوع، تفسيرات محمد عبده ورشيد رضا ومحمد عابد الجابري.)

محمد عبده، ورشيد رضا، ومحمد عابد الجابري
والمتأمل في هذه المدارس الأربعة يجد أنها على اختلاف مناهجها وأهدافها تدور جميعها حول المعنى المعجمي للفظة «التفسير»، فالتفسير بمعناه المعجمي هو «كشف المغطى» أو «كشف المراد عن اللفظ المشكل» كما ورد في لسان العرب، إلا أنه كانت هناك محاولات فردية سعت لتجاوز التفسير بمعناه المعجمي المذكور آنفًا، فانتهجت نهجًا آخر لا يندرج بالضرورة تحت أيٍ من مدارس التفسير السالف ذكرها، أذكر هنا من هذه المحاولات محاولة تتبع «الفن القصصي للقرآن» بهدف تسليط الضوء على الدرس الأدبي أو البلاغي الفني للقصص القرآني، حيث الفن القصصي هدفًا في ذاته وليس وسيلة (فقط)، وبهدف تفادي المأزق الناتج عن التعارض في بعض الأحيان بين الفن القصصي في القرآن والحقيقة التاريخية[2]، والمثال الأبرز هنا هو محاولة محمد أحمد خلف الله.

تحليل ذات المتكلمين في القرآن
وفي مقالي هذا أسعى إلى إلقاء الضوء على نوع آخر من أنواع التفسير أُسميه «التفسير النفسي للقرآن»، ينطلق من ظاهرة تعدد الأصوات في القرآن الكريم[3]. يتتبع هذا المنهج تلك الأصوات ويحاول تحليل نفسيتها، ليس بهدف الوصول إلى حقائق جازمة أو غير جازمة حتى، بل إن الأمر برمته لا يدور حول مفهوم الحقيقة إذ ليست هي المطلب والغاية هنا، وإنما المطلب هو التحليل الذاتي لنفسية المتكلمين في القرآن، والقراءة المنتجِة لآفاق أكثر رحابة يحتملها النص القرآني وتضيف بعدًا جديدًا إلى أبعاده العديدة، هو البعد النفسي. ولا أجد مثالًا للبعد النفسي في القرآن الكريم أوضح من قصة إيمان إبراهيم عليه السلام ومروره خلالها بمراحل مختلفة تعكس لنا مكنونات نفسيته الباحثة عن الله بطريقة خاصة، نفسية إبراهيم الباحثة عن الله وعن الحقيقة بحثًا ذاتيًا وفي حدود الإطار المعرفي المتاح لإبراهيم عليه السلام دون الاعتماد على المعجزة الخارقة كأساس للإيمان.
حيث يبدأ إبراهيم رحلة إيمانه بالبحث عن الله عن طريق التأمل في الكون من حوله وفيما تصل إليه معرفته، فيرى الكوكب عظيمًا ومتجليًا في عتمة الليل، فيفترض فيه الإله الذي يبحث عنه، وعندما يختفي الكوكب يصل إلى الكوجيتو الإيماني الأول وهو أن الله الذي يبحث عنه لا يمكن أن يظهر ثم يختفي، فهذا أمر يعتري الحوادث ولا يليق بمقام الله المتنزه عن الحوادث، «فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا ۖ قَالَ هَٰذَا رَبِّي ۖ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ[4]».. ويواصل إبراهيم رحلته في البحث، فعندما يتراءى له القمر بازغًا يعاود الفرضية مرة أخرى، ولكن هذه الفرضية لم تلبث إلا سواد الليل حتى تدحضها ذات المنهجية التي دحضت الفرضية الأولى، «فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي ۖ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ[5]»، وكأن إبراهيم هذه المرة يطلب من الله المساعدة في الوصول إليه بعد أن أعياه البحث، وكأن الله مستمتع برحلة إبراهيم الذاتية في البحث عنه ويأبى إلا أن يتركه يكمل رحلته بذاته دون أي تدخل منه، فيواصل إبراهيم رحلته ويتدرج في الفرضيات حتى يصل إلى الشمس بنورها الساطع الذي يطمس ما عاداه من أجرام، فلما تتوارى هي الأخرى يصل إبراهيم إلى الكوجيتو الإيماني الثاني وهو أنه يبحث عن الله في المكان الخطأ، وأن الإله الذي يبحث عنه لابد أن يكون متعالياً إلى أبعد حد، بحيث لا تدركه عين ولا يحيط به حيز كما هو الحال بالنسبة للأشياء والأمور الحادثة، ولابد أن يكون هو السبب النهائي ولا أسباب بعده تنازعه ملكه، فيحسم أمره أمام الجميع ويقول «إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا ۖ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ[6]».

ومع مرور الزمن لا يهمل إبراهيم دور عقله الساعي دومًا إلى المعرفة والباحث أبدًا عن الحقيقة، حتى بعد أن وصل إلى هدفه الأسمى وهو الوصل إلى الله، فيخاطب ربه سائلًا إياه «رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ»، فيسأله ربه «أَوَلَمْ تُؤْمِن»، فيجيب «بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي»، ولأن الله هو الأعلم بما في نفس إبراهيم، «ألا يعلم من خلق»، ولأنه يعلم أن سؤال إبراهيم نابع من نفس باحثة عن الحقيقة باستمرار رأيناه يعذر له فضلوه ويصور له ولنا مشهدًا بديعًا من إحيائه للموتى وعظيم قدرته التي لا حدود لها، «قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا ۚ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ[7]».
عندئذٍ يصل إبراهيم في رحلة إيمانه إلى اليقين المطلق، بعد أن سلك في هذه الرحلة كل سبل التأمل والتساؤل والبحث، فيريد الله أن يختبر ذروة يقين إبراهيم فيضعه تحت أصعب اختبار يمكن أن يتعرض له بشر وهو أن يذبح ابنه. كان اليقين الذي قد وصل إليه إبراهيم يستحيل أن يخالطه أي قدر من الشك في رحمة الله وحلمه، وأنه لن يدعه يذبح ابنه فعلًا، ولأن هذا الاختبار لم يكن قاصرًا على إبراهيم ولكنه كان متعديًا إلى ابنه رأيناه يفصل بحسم بين تحمله تبعات يقينه وبين فرض يقينه هذا على غيره، حتى وإن كان ابنه، فقد ترك له القرار قبل أن يشرعا في أي فعل قائلًا «فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ»، ولأن الابن كان متيقنًا من يقين أبيه فقد أجابه «يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ»، ولأنه كان مدركًا أن الأمر لا يتطلب إلا الصبر على الاختبار حتى النهاية ذيَّل كلامه بقوله «سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ»، فمنحهما الله الصبر حتى اجتازا اختبار اليقين بنجاح وتأكد لهمها يقينهما في رحمة الله.
ولأن رحلة إبراهيم الإيمانية كانت متفردة فقد حباه الله مكانة خاصة بين خلقه، مكانة تفوق مكانة الأبرار، بل وتفوق مكانة المقربين أيضًا، مكانة نستطيع أن نطلق عليها مكانة مقربي المقربين، «وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا»[8].
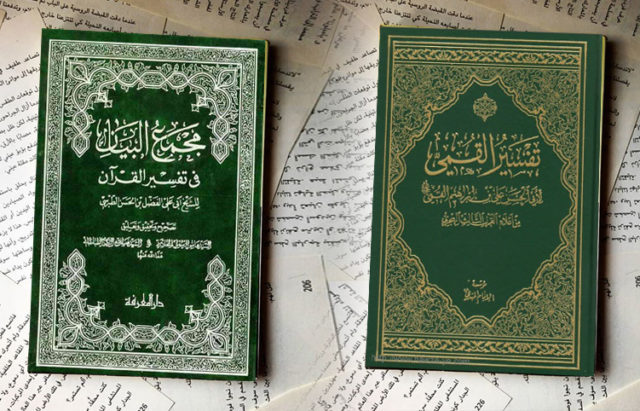
[1] Elsaiad, Karim (2017). Ontologie der Koranauslegung. Eine phänomenologische Annäherung an die islamischen exegetischen Methoden. Dissertation, Universität zu Köln.
[2] خلف الله، محمد (1951). الفن القصصي في القرآن الكريم. النهضة المصرية، القاهرة.
[3] «أصوات القرآن المتكلمة من الخالق جل وعلا إلى الإنسان والجان: توجيه صارم بالتعددية والتسامح»
[4] الأنعام (76)
[5] الأنعام (77)
[6] الأنعام (79)
[7] البقرة (260)
[8] النساء (125)