يرجح أن مصطلح “السياسة الشرعية” لم يكن متداولا بين مفكري الإسلام خلال القرون الخمسة الأولي، ويبدو أن أول من استعمل هذا المصطلح من الفقهاء المتقدمين كان ابن عقيل عام 513هـ، وقد ثبت ذلك بما نقله عنه ابن القيم من قوله “جرى في جواز العمل في السلطنة بالسياسة الشرعية، أنه هو الحزم”. وقد أصبح المصطلح بعد ابن القيم شائعا.
وقد تعددت تعريفات المصطلح، ونستطيع أن تقول وفقا لما اطلعنا عليه منها أن السياسة الشرعية هي: القيام على شأن الرعية من قِبَل ولاتهم بما يصلحهم من الأمر والنهي والإرشاد والتهذيب، وما يحتاج إليه ذلك من وضع تنظيمات أو ترتيبات إدارية تؤدي إلى تحقيق مصالح الرعية بجلب المنافع أو الأمور الملائمة، ودفع المضار والشرور أو الأمور المنافية.
ويرى ابن خلدون أن السياسة “إذا كانت هذه القوانين المفروضة من العقلاء وأكابر الدولة وبصرائها كانت سياسة عقلية، وإن كانت مفروضة من الله بشارع يقررها ويشرعها كانت سياسة دينية”.
وإذا كانت السياسة الشرعية في صدر الإسلام قد انضبطت بضوابط التنزيل، وبهدي خاتم المرسلين، واستمرت ما شاء الله لها أن تستمر، ثم أنَّها تحولت من نهج التنزيل إلى منزلق التبديل، حتى جعلها البعض قاصرة على فترتها الأولى، حيث كانت ضرورة لتمام نعمة الإسلام، الذي ما إن كَمُل؛ صارت السياسة وفق قواعد المصلحة العامة، تقدر بقدرها وتهتدي بالمبادئ والأطر الواضحة لما أوردته النصوص الشرعية قطعية الثبوت قطعية الدلالة.

لذلك توجب في البدء أن تقوم للإسلام دولة تشيد صرحه وتعلي رايته و تمنعه صولة الأعداء، وبغير الدولة ما كان للإسلام بقاء ولا انتشار، فما كانت تعاليمه منذ البدء إلا تقويضا وهدما لما هو قائم بغية تشييد بنائه الخاص وفق المنهج الإلهي، على هَدْي محمد – صلى الله عليه وسلم – لا هَدْي سواه؛ إذ أعلن الرسول منذ البداية أنَّ الأمر بالغ تمامه “ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز أول بذل ذليل”.
كانت قيمة الدولة وأهميتها القصوى لوجود الإسلام وبقائه لدى السابقين الأولين من الصحابة- قيمة عظمى، لا تحولهم عنها أجل الخطوب، ولا تثنيهم عن صيانتها والذود عنها أشد المصائب، فهاهم قد انفضوا من حول الجسد الكريم المُسجَّى في بيت أم المؤمنين عائشة؛ لينظروا أمر السقيفة في بني ساعدة وما يدور فيها، وفي مشهد لا يخلو من الحبكة الدرامية يحسم الأمر على خلاف ما غردت به بلابل الأوهام في رءوس البعض!
ربما لم تسمع دولة الإسلام بمن هو أوعى بها، وبما يقيمها وما يلزم لمنعتها من الأسيف أبي بكر الذي ما إن ولي الأمر حتى أبان عن معدن من الرجال قلما وجد له نظير؛ إذ أدرك تماما أن انفراط الأمر من يده يعني نهاية الإسلام الذي تهددت دولته بالردة وامتناع بعض القبائل عن أداء الزكاة، وما كان لرجل كأبي بكر وهو من هو أن يفرق بين عُرى الإسلام إن أرادوا لها فصما ولترتو الصحراء العربية بدمائهم جميعا وإن كان فيهم من فرق بين الزكاة والصلاة.. ورغم رأي عمر.
وخلال عامي حكم الصديق استوت دولة الإسلام بدعائم الغلبة وأسباب التمكين، وخرجت من ضيق المخاطر وتربص الأعداء إلى سعة الفتوح والتمدد على أطراف جزيرة العرب؛ ليبني لها عُمَرها- بعد ذلك- مجدها الأعظم، الذي ما طاول شأوه مجد من بعد، وبحسب حديث حذيفة فإن مقتل عمر كان كسر لذلك الباب الذي حال بين الأمة والوقوع في الفتنة الكبرى التي ما زالت تمتحن الأمة وتمحنها إلى يومنا هذا.
بمقتل عمر انتهت – برأينا- تلك السياسة الشرعية القائمة على التنزيل؛ لتبدأ وفق متغيرات الواقع سياسة أخرى اعتمدت نهجا هو أبعد ما يكون عن ضوابط السياسة الشرعية وفق التنزيل ويرى الدكتور حاكم المطيري في كتابه “الحرية أو الطوفان” أنَّ السياسة الشرعية لم تنزلق إلى التبديل إلا بعد أن مرت بمرحلة التأويل، وهي مرحلة لا تقل خطرا عن تاليتها، وقد اعتورها الخلط بين المفاهيم والنظرة الاجتزائية للتاريخ، وشيوع أحاديث الفتن والخشية من الوقوع فيها، ما أشاع الروح الفردية وإيثار الاعتزال، كما شاعت روح الجبر من جهة والإرجاء من جهة أخرى، وكان أخطر ما اتسمت به المرحلة الغلو في تعظيم طاعة السلطان؛ لذلك وصم الخروج السياسي بالمروق العقائدي برعاية فقهاء السلطان!
كان الخطاب المؤول إذن هو الحاضنة التي أنتجت هذا الانحراف، لكن ثمة ما يشير إلى أن قابلية الانحراف باتباع الهوى والأثرة بالسلطة وتغليب الخاص على العام- يعد مكونا أصيلا فيها إذ يقول ابن القيم: “وهذا موضع مزلة أقدام، ومضلة أفهام، وهو مقام ضنك، ومعترك صعب، فرط فيه طائفة فعطلوا الحدود، وضيعوا الحقوق، وجرءوا أهل الفجور على الفساد، وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد محتاجة إلى غيرها، وسدوا على نفوسهم طرقًا صحيحة من طرق معرفة الحق والتنفيذ له وعطلوها.. وأفرطت فيه طائفة أخرى قابلت هذه الطائفة، فسوغت من ذلك ما ينافي حكم الله ورسوله، وكلتا الطائفتين أتيت من تقصيرها في معرفة ما بعث الله به رسوله وأنزل به كتابه”.
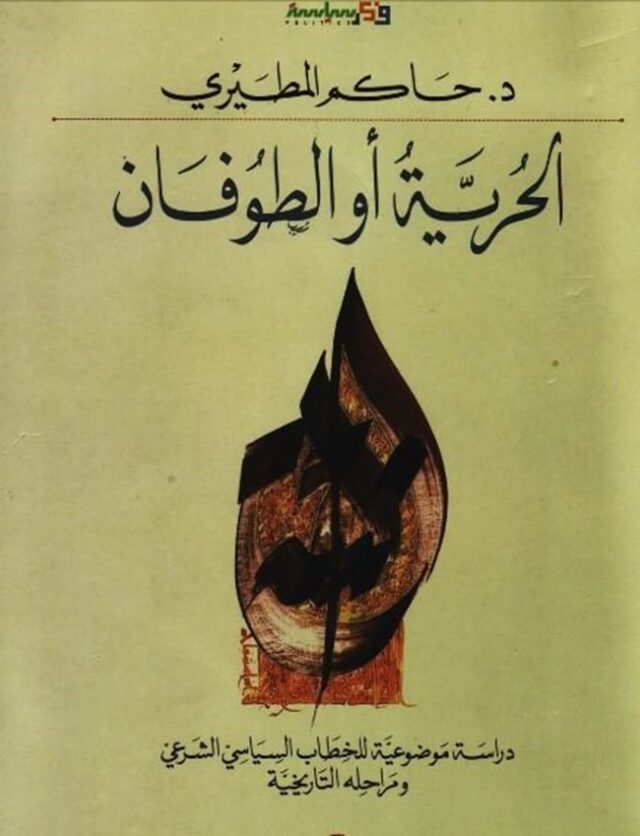
والأمر هنا يزداد خطورة وكأنه حبل مشدود فوق الجحيم، فلا قطع فيه بقين إذ هو في أحسن الأحوال اجتهاد يسأل الناس منه الله السلامة، وهو يحتاج إلى معرفة –ربما– أحالت الواقع إلى صعوبات لا يمكن التعامل معها، ولكن الخير في تجنب كل تلك المهاوي، بإرجاع الأمر إلى أهله كما يقول المطيري في خاتمة كتابه “إنَّ ما تعيشه الأمة اليوم من انحطاط وتخلف هو نتيجة طبيعية للانحراف الذي طرأ على الخطاب السياسي الشرعي، الذي جرّد الأمة باسم الدين والسنة من حقها في اختيار السلطة ومحاسبتها ومقاومة طغيانها وانحرافها، وإصلاحها عند فسادها، حتى شاع الظلم والاستبداد، وظهر الفساد، فكانت النتيجة الهلاك كما أخبر بذلك القرآن في قوله تعالى: {وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ 117}هود، أي ما كان الله ليهلك الأمم بسبب الشرك وحده؛ حتى يتجاوزوا ذلك إلى التظالم فيما بينهم”.
وهو ما يوافق القول بأن الدنيا تدوم مع العدل والكفر، ولا تدوم مع الظلم والإسلام! فلمن ألقى في روع الناس أنَّ الصبر على الظلم خير من مواجهته، دون إدراك لخطورة الظلم نفسه على المجتمع وأنَّه السبب الأول في انهيار الأمم وسقوطها- نقول لهؤلاء أنَّكم قد أصبتم هذه الأمة في مقتل إذ روجتم لوجوب السمع والطاعة حتى ” ………وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك ” وهي زيادة على حديث ورد بصحيح مسلم، والغريب أنَّها برغم شيوعها لم تصح عند أحد من القدماء ولا المحدثين!
ويختم المطيري حديثه في هذه النقطة قائلا: “لقد تغير الخطاب السياسي الشرعي إلى خطاب مشوه ممسوخ، لا علاقة له بالخطاب الأول المنزّل، وتحوّل إلى آصار وأغلال تحول بين الأمة ونهضتها، والشعوب وحريتها، والإنسانية وكرامتها، فما لبث الناس أن خرجوا من الإسلام أفواجا كما دخلوا فيه أفواجا، ولم يخرجوا من الإسلام الحق؛ إذ لا يعرف الإسلام أحد حق المعرفة فيخرج إلى سواه، وإنَّما خرج الناس من الدين الباطل الذي يدعو إلى الوثنية والخرافة باسم التبرك بالصالحين؟! ويدعو إلى إلغاء العقل بدعوى اتباع النقل؟! ويدعو إلى الخضوع والعبودية للرؤساء والملوك والعلماء باسم طاعة أولي الأمر؟! وإلى الطبقية بدعوى أهل الحل والعقد؟! وإلى الاستسلام بدعوى الإيمان بالقضاء والقدر؟!
فما أبطلها من دواع تحتاج إلى كثير جهد حتى تنزع من رءوس الناس نزعا، وليس إلا الحرية طريق لذلك، وليس إلا التخفف من غلواء نظرات القوم ورؤاهم، وليس إلا أن نقطع الطريق إلى نهايته التماسا للقيم الكبرى التي لا يجب أن تكون أيضا محل خلاف.













