يشير كثير من الباحثين في مجال الفلسفة العربية إلى عدد من نقاط الالتباس، في فكر أبي الوليد ابن رشد، يظنها البعض من قبيل المتناقضات.. ويذهب آخرون إلى أن ثمة تعارض “ظاهري” رصده ابن رشد بين بعض جوانب الشريعة والنظر الحِكَمِي.. وأنه حاول التوفيق بين تلك الأمور؛ فجرّ على نفسه الكثير من البلايا.. ليختلف عليه الناس اختلافا كبيرا، فهو ملحد في نظر البعض، عميق الإيمان عند البعض الآخر، عقلاني لا تحد اجتهاده العقلي حدود، نَصّي أعلى من قيمة النص، ووقف معه عند حدود الشرح، وهو في “فصل المقال” يُكثر النقل للاستدلال، ويقنع في أحيان كثيرة بالوقوف عند ظاهر النص، وبالرغم من أن ابن رشد هو صاحب التصنيف القائل بأن الفيلسوف هو من قال بالبرهان، أما المتكلم فهو الذي يعتمد الجدل باعتبار أنه عرف الحق مسبقا، بوصفه اعتقادا خاصا لاشك فيه؛ فيحاول نقد الخصوم والتشكيك فيما يعتقدون- برغم هذا سنجد “أن كل مؤلفات ابن رشد أقرب إلى القول الجدلي منها إلى القول البرهاني، الشروح والملخصات والجوامع في كثير من جوانبها حجاج مع الشُّراح يونان ومسلمين، ودفعا لسوء تأويلهم؛ ويتضح ذلك بجلاء في مقالاته في المنطق والعلم الطبيعي”. وهذا رأي الدكتور حسن حنفي.
وقد يعتقد البعض أن ابن رشد هو إمام التأويل، بل إن التأويل الفلسفي يعتبر “توجها رشديا” عند البعض؛ إلا أنه في “الكشف عن مناهج الأدلة” يختم بما يسميه قانون التأويل، وهو الذي يؤول النظر في آيات القرآن الكريم على أنها الحكمة، غير أنه في نفس الوقت لا يرفض التأويل المُفضي إلى قدم العالم كقوله “وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاء” وقوله “ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء وَهِيَ دُخَانٌ” وهو في كل ذلك يلتزم رأيه بأن التأويل هو “إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المجازية، دون الإخلال باللسان العربي” وقد قصد من ذلك كما يقول حنفي إلى “الجمع بين العقول والمنقول”.
والتأويل عند ابن رشد مشروط، فهو قاصر على العلماء المجتهدين الذين تنضبط اجتهاداتهم بالضوابط الشرعية، التي تجعل لمن أصاب منهم أجرين وللمخطئ أجرا واحدا، وهم ما يبتعد بهم عن تُهم التكفير والزندقة والمروق، إذ تكون القناعات لدى العامة أن هذه المسائل النظرية شديدة الصعوبة، ومن الواجب بحثها في ضوء كثير من الاعتبارات الفكرية والعقدية.
لذلك يُشكّل مفهوم التأويل عند ابن رشد طريقا آمنا للهروب من التقيد بما تمليه الاتجاهات النصية الظاهرية، ولكنه لا يُصرّح مطلقا بتحرره من قيود تفرضها النصوص، وما لها من سطوة، لكنه أيضا لا يفصح عن مواجهةٍ مع النص؛ بل مع الشروح التي ضيّقت كل واسع، حتى صارت هي نفسها حوائط تحول بين النص والمعنيين به.
وكما يذهب محمد يوسف موسى في كتابه عن فيلسوف قرطبة؛ فإن ابن رشد لم يترك أمر التأويل فوضى دون ضوابط “بل جعل لكل ذلك قانونًا يعلم منه ما يجوز تأويله وما لا يجوز، وما جاز تأويله فلمن؟ هذا التأويل، الذي جعل – في رأيه- كل شيء في موضعه”.
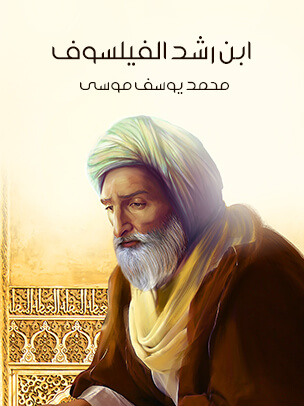
ويذهب الشيخ الأزهري المُجدِّد إلى أن ابن رشد أراد أن يضع حدا للتأويل الذي كان التوسع فيه بغير علم سببا مباشرا في تفرق الأمّة إلى فرق متباينة “يكفِّر بعضها بعضًا.. وهذا كله جهل بمقصد الشرع وتعدٍّ عليه حسب رأيه”.
كما رأى فيلسوف قرطبة ألا يُصَرَّحَ بالتأويل – وبخاصة ما يحتاج منها إلى برهان- لغير أهلها، وهم القادرون على البرهان والاستدلال بالمنطق، كما يجب ألا نثبت شيئًا منها في الكتب الخطابية والجدلية الموضوعة للعامة ومن إليهم من الجدليين. إننا إن فعلنا غير هذا أثمنَا، وكنا سببًا في إضلال كثير من الناس.
ويرى موسى أن “نظرة فيلسوف قرطبة هذه نظرة عملية صادقة؛ فإن تمثيل نعيم الجنة للعامة بأنه مادي من جنة فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مُصفَّى، وفيها مع هذا كله من كل الثمرات – هذا التمثيل يدفع للخير ويحث على الفضيلة، وإنه خير لهم من تشكيكهم في هذا الجزاء المادي “المُحَس” ومن محاولة تفهيمهم أن ما جاء به القرآن والحديث دالًّا على مادية الثواب، إنما هو رموز وأمثال، وأن هذا الثواب الذي وُعد به الفضلاء الأخيار لن يكون إلا معنويًّا للنفوس وحدها التي ليس لها إلى التنعم بتلك اللذات المادية من سبيل”.
ويرى ابن رشد أنه “في جميع الحالات يؤدي النظر البرهاني إلى معرفة الموجود، في حالة سكت عنه الشرع، فهنا وجب البحث فيه؛ كما هو الشأن في الاستنباط الفقهي بالقياس الشرعي، وإذا كان الموجود قد نطق به الشرع، فلا يخالف ظاهر هذا النطق مع ما يدعو إليه البرهان، وإذا ظهر تعارض بين ما وصل إليه البرهان وما بيّنه الشرع، هنا وجب أن نطلب التأويل”.
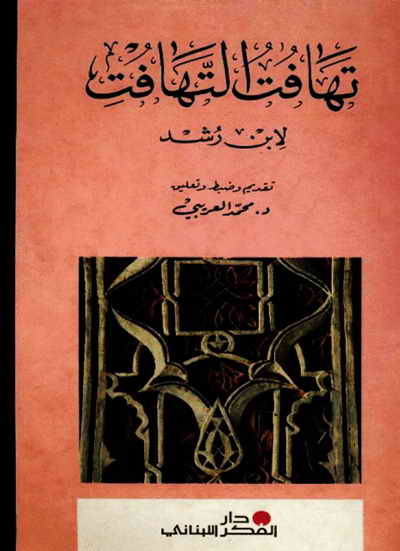
لكنَّ التوفيق بين الحكمة والشريعة، الذي قصده ابن رشد؛ لم يذهب بعيدا عن محاولات سابقيه، برغم محاولاته المضنية في إثبات أن فهم أحدهما لا يكتمل إلا بالآخر وفي ذلك يقول: “إن الحكمة هي صاحبة الشريعة والأخت الرضيعة مع ما يقع بينهما من العداوة والبغضاء والمشاجرة، وهما المصطحبتان بالطبع، المتحابتان بالجوهر والغريزة.. فالصواب أن تعلم فرقة من الجمهور التي ترى أن الشريعة مخالفة للحكمة، إنها ليست مخالفة لها، وذلك بأن يعرف كل واحد من الفريقين، أنه لم يقف على كنههما بالحقيقة، اضطررنا في مناهج الأدلة أن نعرف أصول الشريعة، فإن أصولها -إذا وجدت- أشد مطابقة للحكمة مما أُوّل فيها، وكذلك الرأي الذي ظن في الحكمة أنه مخالف للشريعة، لم يحط علما بالحكمة ولا الشريعة، ولذلك اضطررنا نحن أيضا إلى وضع قول فصل المقال في موافقة الحكمة للشريعة”.
ومع ذلك فليس لأحد أن ينكر ما قدّمه ابن رشد من جهود لمواجهة الدغمائية التي كانت في أَوْجِها، وكانت تقصر الأمر على رؤية واحدة وتفسير واحد للنص.. كان ابن رشد يعمل ويجاهد المتربصين له، ويدعو ويعلم ويقضي بين الناس، ويصل الليل بالنهار، في أجواء لم تكن لتسمح له بالتنفس بحرية كاملة؛ لكنه استطاع أن يُنجز، وأن يحقق مشروعه، برغم ما لاقاه من عَنَتٍ طوال رحلته، وبالقطع فإن الواقع قد فرض عليه كثير من المواءمات التي نقطع بأنه ما كان ليلجأ إليها في ظروف طبيعية؛ وربما كان وعيه بخطورة أن يقف الدين والفلسفة موقف تضاد هو ما دفعه إلى العمل على تحقيق هذا الاتصال، الذي تجلى في فصل المقال المُوجَّه إلى الفقهاء، وفي الكشف عن مناهج الأدلة الذي وجهه للعامة، ثم كان تهافت التهافت لأصحاب البرهان، وهو في كل ذلك يسعى لفتح الآفاق نحو تحرير العقل؛ ليصبح أكثر قدرة في التعامل مع النص وفق ما تمليه متغيرات الواقع.













