حين ناقشت مع صديق العمر الأستاذ حسين عبد الغني في المساحة التي يراها مناسبة للكتابة عن أستاذنا محمد عودة، (وحسين فضلاَ عن كونه مؤسس موقع «أصوات أونلاين» فهو قبل ذلك وبعده واحد من تلاميذ وأصدقاء الأستاذ عودة والمقربين إليه)، قال لي: «تمنيت دائماً لو نستطيع تقديم الأستاذ عودة كواحد من أهم التنويريين التقدميين في أفكاره (موقفه من المرأة، ومن المواطنة، ومن تواصل أجيال الحركة الوطنية. الخ الخ) بالإضافة إلى تمثله تلك الأفكار في سلوكه الحياتي».
وكان ردي عليه: « كأننا نقرأ على شيخٍ واحد، فقد وضعت المخطط الرئيسي للكتابة عنه وفي تقديري أولاً: أن نعطيه ـ نحن تلامذته ـ بعض حقه علينا، وأن أقدمه ثانياً: كواحد من ورثة رفاعة الطهطاوي وجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده، ثم كواحد من مؤرخي الشعب، تبنى قضية الثورة الوطنية المصرية في كل حلقة من حلقاتها من أول ثورات القاهرة ضد الاحتلال الفرنسي مروراً بثورة التحديث وبناء الدولة القومية العربية الكبرى مع محمد علي وابنه إبراهيم باشا، وبعد ذلك الثورة العرابية فالثورة الشعبية في سنة 1919 وحتى الثورة الكبرى في 1952، ويبقى الجانب الثالث الذي لا يمكن تجاهله عند الكتابة عن محمد عودة وهو الحديث عنه كإنسان لا يُشبهه أحد».

محمد رشيد رضا جمال الدين الأفغاني رفاعة الطهطاوي
في معرض استعراضي لبعض ما كُتب عن الأستاذ عودة فوجئت بمقال قصير وبليغ كتبه الدكتور عبد الوهاب المسيري (صفحة 31 من كتاب: «في حضرة محمد عودة») افتتحه بالتأكيد على أن لكل مرحلة رموزها، «ثمة رموز سياسية وعسكرية لكل مرحلة، ففي مرحلة التصدي لممالك الفرنجة كان رمزها هو صلاح الدين الأيوبي، وأما مرحلة التصدي للغزوة المغولية كان رمزها هو قطز، ثم الظاهر بيبرس، وكانت رموز التصدي للاستعمار الغربي في العصر الحديث عديدة من بينها عرابي ومصطفى كامل وسعد زغلول والنحاس وجمال عبد الناصر والفريق عبد المنعم رياض رحمهم الله جميعاً.

جمال عبد الناصر عبد المنعم رياض أحمد عرابي
ويؤكد المسيري على وجود رموز فكرية لكل مرحلة ويشير إلى أن «أهم الرموز الفكرية في المرحلة الأولى من تاريخ مصر الحديثة رفاعة الطهطاوي ومحمد عبده ورشيد رضا، ومن أهم رموز مرحلة ما بعد ثورة 1919 عباس العقاد وطه حسين وأحمد أمين ومحمد حسين هيكل، ومن أهم رموز مرحلة ما بعد ثورة 1952 نجيب محفوظ وزكي نجيب محمود وحامد ربيع ومحمد شاكر ومحمود أمين العالم وأنور عبد الملك ومحمد حسنين هيكل، ولا شك في أن أستاذنا محمد عودة من أهم رموز تلك المرحلة الأخيرة».

محمد حسنين هيكل محمود أمين العالم زكي نجيب محمود حامد ربيع أنور عبد الملك نجيب محفوظ
كانت المفاجأة السارة بالنسبة لي أن يُلحق الدكتور المسيري ـ وهو من هو ـ بكل هؤلاء الأستاذ محمد عودة، وبالطبع لم تكن المفاجأة في أن يقول الدكتور المسيري ما قاله عن الأستاذ عودة، فقد كان واحداً حسب اعترافه ممن فُتحت طاقة من النور أمام ناظريه لدى قراءته لكتاب عودة الأول عن «الصين الشعبية» يقول: «تعلمت منه معنى الثورة والقومية ومعنى إمكانية مواجهة الظلم وعدم السقوط في اليأس»، ولكن الحقيقة أني كنتُ أخشى أن أكون ممن غلبته عواطفه تجاه رجل علَّمنا الكثير، وكان بالنسبة لجيلنا ـ ولأجيال أخرى سبقتنا وأخرى لحقت بنا ـ أكبر من أستاذ، وأقرب إلى الأب بأفضل صور ومعاني الأبوة، خشيتُ أن تغلبني عاطفتي تجاه أستاذي محمد عودة فأشتط في مدحه، ومن ثَمَّ سررت بأن يأتي مفكر في قيمة وقامة الدكتور المسيري ليؤكد على الفكرة نفسها التي نظرتُ عبرها إلى الأستاذ عودة باعتباره واحداً من هؤلاء التنويريين العظام الذين مروا من هنا وتركوا آثارهم باقية على مر الزمان.

عبد الوهاب المسيري
ولست أشك في أن قارئ تاريخ الفكر المصري في العصر الحديث سوف يلحظ هذا الخط الواصل بين رفاعة الطهطاوي وبين محمد عبده ثم رموز ما قبل ثورة يوليو سنة 1952 وما بعدها، بمن فيهم الأستاذ محمد عودة.
الطهطاوي كان يبشر بالتحديث والعلم والتقدم في لحظات ساد فيها التخلف والانحطاط والبحث عن طريق الخلاص، ومحمد عودة كان اللسان البليغ والصادق المتحدث باسم الدفاع عن تراث أمةٍ يُراد لها أن تتوه بها الطرق، فراح ينعش ـ عبر كتاباته وكتبه وكلها شاهدة على ذلك ـ الذاكرة التاريخية حتى لا تمحى ذاكرة الأمة في زمن العولمة وتضيع هويتها.
وقد فعل ذلك بطريقة تفرد بها وحرص عليها طول الوقت، وكان أشرس ما يكون في الرد على أفكار مخالفيه، وكان أرق ما يكون في التعامل مع أشخاص هؤلاء المخالفين.

محمد حسين هيكل أحمد أمين عباس العقاد طه حسين
كتب محمد عودة في العدد الوحيد الذي صدر من «مجلة اليسار الإسلامي» بتاريخ يناير 1981 والتي أشرف عليها صديقه الدكتور حسن حنفي وحوى خمسة مقالات واحدة للأستاذ عودة وأخرى للمفكر الإسلامي على شريعتي وثلاثة مقالات كتبها الدكتور حسن حنفي، وهي جميعها أقرب إلى الدراسات الموسعة، جاءت تحت العنوان العام الذي اختير ليتصدر هذا العدد من المجلة: «كتابات في النهضة الإسلامية».
وفي التقديم تم التأكيد على أن «اليسار الإسلامي» هي استمرار لمجلة «العروة الوثقى» ولجريدة «المنار» نظراً لارتباطها بالمشروع الإسلامي كما حدده جمال الدين الأفغاني في: «مقاومة الاستعمار والتخلف، والدعوة إلى الحرية والعدالة الاجتماعية وتوحيد المسلمين في الجامعة الإسلامية أو الجامعة الشرقية».
وللحق فإن هذا العدد اليتيم من مجلة اليسار الإسلامي قدم «وجبة دسمة» في التعريف باليسار الإسلامي كما رآه صاحبا المشروع الدكتور حسن حنفي والأستاذ محمد عودة، وتحديد توجهاته والأسس الفكرية التي ينبني عليها مشروعه.
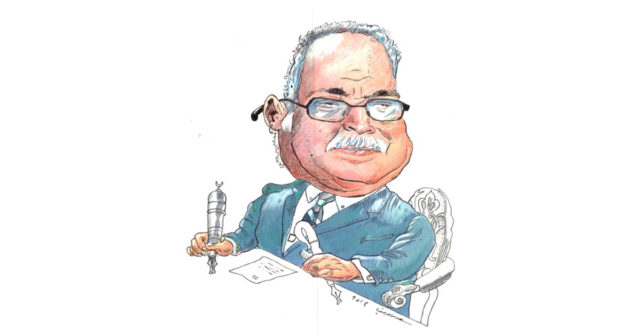
حسن حنفي بريشة: سعد الدين شحاته
ويمكنك أن تخمن أن التقديم الذي جاء بتوقيع الدكتور حسن حنفي حوى بعضاَ من أفكار وصياغات الأستاذ عودة، (وقد عاينت بنفسي مناقشاتهما في بيت الدكتور حسن بمصر الجديدة)، خاصة حين يؤكد التقديم على أن دور «اليسار الإسلامي» أن يحقق أهداف الثورات الوطنية ومبادئ الثورة الاشتراكية، وذلك من خلال تراث الأمة، واعتماداً على وعي الجماهير، وبالتالي تحقق أهداف حركتنا الثورية الأخيرة دون مثالبها وأوجه قصورها».
هذا النص هو في الحقيقة تلخيص يمكن اعتماده لتوصيف الدور الذي لعبه باقتدار محمد عودة وجعله دائماً نصب عينيه وموضع اهتمامه في أول كتاب له حتى آخر كتبه.
محمد عودة أستاذ أجيال، ولا تقتصر أستاذيته على جيلنا ويكفي أن نذكر في هذا المجال ما كتبه المستشار طارق البشري من أن شباب جيله تعلموا من محمد عودة درسين في غاية الأهمية: الأول عبر كتاب «الصين الشعبية»، الذي فتح وعيهم على أن الأصل هو ثورات التحرر الوطني، وأنه لم يتكلم عن ماوتسي تونج زعيم الثورة الناجحة بقدر ما تكلم عن صن يات صن الزعيم الوطني السابق لثورات الصين السابقة، فقد تحدث عن الثورة الناجحة من خلال الحديث عن الثورات الفاشلة، وأن الفشل السابق هو سبب النجاح التالي.

طارق البشري
والدرس الثاني ـ حسب شهادة البشري ـ جاء مع كتابات محمد عودة في أعقاب هزيمة يونيو سنة 1967، حيث كانت مشاعر القلق واليأس وفقدان الرجاء فألزم محمد عودة نفسه بأن يسكب في القلوب الثقة والرجاء لا في حكومة ولا في نظام ولكن في الشعب، وفي الايمان العميق بمستقبل هذا الوطن. يقول البشري: «ما كان أروع محمد عودة في تلك الأيام القاسية جداً من أشهر يونيو ويوليو وأغسطس 1967 وما تلاها».
محمود السعدني لا يتورع عن اعتبار عودة أستاذه الأول الذي لم يكن يقابله إلا وهو يحمل معه مجموعة من الكتب والمجلات الأجنبية وأنه كان أحد أهم مصادر معرفته، وغير هؤلاء كثيرون، ولعل أستاذية محمد عودة هي الصفة الغالبة التي ظهرت في كل كتابات الذين رثوه بعد وفاته (18 أكتوبر سنة 2006) من تلاميذه ومجايليه، ومحبيه، أجمعوا كلهم على «أستاذيته» التي كانت تفيض منه فيضان الماء السهل في جداول منسابة بالرِي والنماء.
إلى جانب «الأستاذية» صفته الأولى، كان محمد عودة بالنسبة إلى كل قرائه هو «مؤرخ الشعب»، وهي الصفة الألصق بكل كتاباته وتحليلاته سواء في مقالاته أو في كتبه، ومن موقعه وموقفه هذا كان شديد التفاؤل بالآتي، عميق الايمان بقدرة الشعب في اللحظات الحاسمة على وضع البوصلة في الاتجاه الصحيح.
قارئ التاريخ لا تتوه بوصلته، ومحمد عودة هو الذي لقننا منذ بدايات التعرف عليه، أن «من لا يعرف التاريخ لا يمل من تكراره» وكان يردد: «هذا الذي لا يعرف ما وقع قبل مولده يبقى طفلاً طوال عمره».
من أول كتاب له «الصين الشعبية» وحتى آخر كتاب «ليبراليون وشموليون» كانت تؤرقه قضية الثورة والتغيير في مصر، وهو يكتب كتابه الأول عن الصين كانت عينه على مصر، يقدم لها تجربة ثورية شديدة الثراء، وحين خط قلمُه رحلة في قلب نهرو كأنها محاولة للسباحة في نهر النيل، وقدم ثورة العراق ومن بعده الطريق إلى صنعاء باعتبارهما حلقات لا يمكن فصلها عن الثورة العربية الواحدة والتي تقف في القلب منها الثورة المصرية التي قادت وأمدت كل حركات التحرير وعمقت أشواق الانعتاق من ربقة الاستعمار.

اهتم محمد عودة بتاريخ بعض الشعوب ليقدم لنا تجربتها الثورية، واللافت أنه احتفظ حتى النهاية بعلاقات مميزة وخاصة جداً مع تلك الدول التي سافر إليها حاملاً معه رغبة واعية في التعرف على تجاربها وثوراتها، وما زلت أذكر أنني دُعيت معه ـ وعلى شرفه ـ إلى عشاءات خاصة في بيوت سفراء الهند وفيتنام والعراق واليمن وغيرها البلاد التي كوَّن فيها علاقات مودة ومحبة، ولم تكن تلك العلاقة الودودة تمنعه في أي وقت من توجيه النقد لسياسات تلك الدول أو لبعض إجراءاتها التي يراها تحيد عن الطريق الصحيح.
هناك خيط متين يربط بين كل كتب محمد عودة، هو دراسة وإعادة كتابة تاريخ مصر على مسطرة واحدة، كان يرى أن مهمته هي تخليص التاريخ من الزيف، ودائماً ما كان يوجهنا ـ ونحن في بدايات الطريق ـ إلى أن الاستعمار وأعوانه ـ والذين التحقوا بالعمل وفق رؤيته ـ حاول ـ وحاولوا معه ـ تقديم تاريخنا إلينا مشوهاً ومزيفاً، وكان يشير في هذا الصدد بما فعله الانجليز في مصر والهند وهو الأمر الذي دفعه إلى تأليف كتابه «كرومر في مصر».
قصة الثورة المصرية على مر التاريخ هي أعظم أعمال الأستاذ عوده من أول كتابه «ميلاد ثورة » مروراً بكتاب أحمد عرابي ـ قصة ثورة، وكتاب الديمقراطية العرابية ـ قصة دستور فبراير 1882 ثم كتاب «ليبراليون وشموليون (قصة الديمقراطية والحزبية في مصر) ثم كتاب «كيف سقطت الملكية في مصر»، وكتاب «فاروق بداية ونهاية» عن السنوات الاخيرة في حكم فاروق آخر من جلسوا على عرش مصر من أسرة محمد علي، وكتابه الرائع «سبع باشوات» الذي كتب مقدمته يوسف ادريس، وقال ادريس في تقديم الكتاب «أعترف أني من مدة طويلة لم أقرأ كتابا انفعلت به الى هذه الدرجة. ان قصة قادة الثورة العرابية في المنفى… كلها كنوز حية كانت مخبوءة. حافلة وغنية ودسمة ورائعة ومحبوبة. وجاء هذا الكتاب ليكشف عنها الغطاء ويجسدها حية نابضة أمام أعيننا نتأملها ونستوحيها ونقف أمامها طويلا وأن يجيء هذا الكتاب من الصديق الفنان محمد عودة ليس بالأمر الغريب فهذه ثاني مفاجأة يفاجئني بها في حياته. كانت مفاجأته الاولى لي كتابه عن الصين الشعبية. بل كانت المفاجأة الاولى في الحقيقة هي محمد عودة نفسه».

احتل محمد عودة مكانة متقدمة في قائمة رموز التنوير، وعلمته خبرة الاطلاع الواعي على التاريخ درسه الباقي وهو: «تفاءلوا بالشعب تجدوه»، كانت ثقته بالشعب لا حدود لها، وكان يردد أمامنا مقولة حكمدار مصر وحاكمها لمدة 30 سنة “«جون راسل باشا»: «المصريون مثل رمال الصحراء الناعمة، تستطيع أن تمشى فوقها مسافة طويلة، ولكنك لن تعرف متى تفاجئك، وتتحرك، وتبتلعك».
وكان وعيه الحاضر دائماً بيننا هو الذي يقينا مصارع «الوعي المفقود» لدى نخبة رآها دائماً أقل مما تحتاجه مصر، وهم نصيبها الذي ظل يبكي عليه، كانت مصر عنده تستأهل أكثر مما هي فيه، تستأهل نخبة أكثر ارتباطا بالناس، بعموم الناس، لا بخواصهم، بفقراء الناس لا بأغنيائهم، وكان هو غنياً بالاستغناء.

حين كانت شياطين اليأس تجتمع عليَّ، وتحوم حول رأسي غربان التشاؤم، كنت أبادر بالذهاب إلى الأستاذ محمد عودة في شقته المتواضعة بعمارات الأوقاف بحي الدقي، كان الله يرحمه يمتلك مقدرة فطرية على التفاؤل، قادراً على بث الأمل، وبعثه من جديد، وكان تفاؤله بتغيير الأحوال يفوق قدرتنا على فهم دواعيه وأسبابه الخفية التي يحتفظ بخلطتها السرية لنفسه.
لم أجده خارج منطقة التفاؤل، حتى في أصعب اللحظات، وأحلك الظروف، وأسوأ الأحوال، كنتَ تجد محمد عودة قادراً على رؤية الجانب الآخر، ذلك الذي لا تراه العين العادية، ولا تدركه العين التي لم تدرب على التقاط أشعة الأمل، تلك التي لا تُرى بالعين المجردة، ولا يمكن قياسها بالأجهزة العادية لقياس الأشعة، ولكن عين محمد عودة «الجاحظة» المدربة على التقاط بصيص الأمل من بين ظلمات الواقع وظلاميته كانت دائماً ترصد لنا النور الآتي من بعيد.
شيء واحد أتصور أنه هو المفتاح الذي احتفظ به محمد عودة ليفتح أبواب الأمل إذا أوصدت في وجه النخبة السياسية التي سرعان ما تفقد الأمل في إمكانية التغيير في ساعات الظلمة، هذا الشيء أنه كان يؤمن بثقة في قدرات هذا الشعب، كان يؤمن بعظمة الشعب وجدارته، ولا زلت أذكر كيف كان يأخذني بدون مقدمات ولا أسباب ليطوف بي في شوارع مصر الفاطمية، أو يدفعني دفعاً إلى التجول معه مستنداً على كتفي في حواري «بولاق الدكرور».
كأنه كان يتلقى الوحي من أنفاس الذين عاشوا داخل أسوار القاهرة القديمة، وكأنما كان يتلقى الأمل من الذين يعيشون في حواري الأحياء الأكثر شعبية وفقراً، كان يحسب نفسه عليهم، لم أره يوماً ينظر من بلكونة شقته التي تطل على شارع «حديقة الأورمان»، ولكني رأيته عشرات المرات وهو يتطلع إلى الجانب الخلفي لشقته ذلك الذي يطل على بيوت «داير الناحية»، كأنه يطمئن على أهلٍ له هناك، لا يمل من النظر في وجوه أتعبتها مشقة البحث عن لقمة العيش.
في بلاط صاحبة الجلالة تعرفت عن قربٍ بكبار في عالم القلم والأوراق، كان لكلٍ منهم بصماته على جيلنا الذي التحق بالصحافة، ولكنه وحده محمد عودة الذي كان بالنسبة لنا «الأسطى» والأستاذ الذي لقننا أن القلم انحياز للتقدم، وأن الحرف مسئولية تجاه الوطن، وأن الصحافة هي بالأساس صوت الشعب، وليست صوتاً للحاكم، تعلمنا على يديه أن أصوات الحكام دعاية و«بروباجندا»، وأن صوت الشعب وعي وفكر واستنارة.
صورة الغلاف بريشة الفنان سعد الدين شحاتة













