من أين جاءت مقولة “القومية نوع من أنواع العصبية المرفوضة في الإسلام” هذه المقولة التي استطاعت أن تَسْكُنَ الفكر الإسلامي طوال عقود.. منذ أربعينات القرن العشرين.
في كتابه “الدين والدولة، 1986” يقول محمد عمارة “لحسن الحظ، فإن الذين قرأوا فكر المرحوم الأستاذ أبو الأعلى المودودي (1321/ 1399هـ ـ 1903/ 1979م) أمير الجماعة الإسلامية في الهند وباكستان، ثم قرأوا فكر المرحلة الأخيرة للأستاذ سيد قطب، يدركون ـدون عناءـ كيف جاء فكر سيد قطب، في كتابه “معالم في الطريق” صورة طبق الأصل من فكر المودودي، حول القضايا التي عرض لها هذا الكتاب، ومنها علاقة الإسلام بالقومية”.
بناءً على ذلك، نصل إلى أن المصدر الأساسي للمقولة المشار إليها، هو أبو الأعلى المودودي، وأن هذه المقولة كانت قد انتقلت على يد تلميذه سيد قطب، إلى فكر التيارات الإسلامية على الأرض العربية.
المودودي والمشكلة القومية
ولأن “الفكرة هي ابنة واقعها الاجتماعي”.. لذا، لابد لنا من العودة إلى الواقع الاجتماعي (من حيث المكان، ومن حيث الزمان) الذي صاغ فيه المودودي فكره عن “علاقة الإسلام بالقومية”. إذ ربما نستطيع أن نكتشف من أين جاء الخطأ الذي أدى إلى هذه المقولة.
من حيث الزمان.. صاغ المودودي فكره عن القومية خلال الفترة من (1937ـ 1944) وهي نفس الفترة التي شهد فيها العالم الحرب العالمية الثانية (1939ـ 1945) وعندها كانت القومية قد أصبحت عند المودودي “عصبية عدوانية إطلاقًا” ولعله ـ في هذا ـ كان متأثرًا بحملة العداء للقومية التي شنها الحلفاء خلال هذه الحرب، وسخّروا لها ما لا يحصى من الكتب والكتَّاب، لتسهم بدور مرسوم في هزيمة ألمانيا النازية.

ومن حيث المكان.. صاغ المودودي فكره عن القومية؛ خلال الفترة التي كان حزب المؤتمر الهندي يسعى فيها، لبناء الهند الموحدة المستقلة الديموقراطية العلمانية.
وإذا كان المودودي قد تأثر ـ في ما يبدو ـ بالمضمون الدعائي العدائي للقومية، وهو يكتب ويبشر خلال الحرب الثانية وويلاتها، فإنه قد تأثر ـ دون شك ـ بالصراع الطائفي بين الهندوس الذين كانوا يمثلون 75 % من السكان، والمسلمين (الذين كانوا يمثلون باقي السكان).. فهو يسمى كل طائفة منهما أمة والانتماء إليها قومية، ثم يعمم خبرته بذلك الصراع، فيقول “إن كل قومية هي عصبية عدوانية”.
وأيًا كان الأمر، فبهذا الفهم الخاص للقومية، لم يتصور المودودي إمكان قيام دولة إسلامية وقومية معًا.. لأن الدولة – حينئذ– سوف تكون عدوانية في سياستها الخارجية، استبدادية في سياساتها الداخلية، لمجرد أنها قومية، حتى ولو كانت إسلامية.
اتساقًا مع هذا الفهم، عارض المودودي بقوة ما كان يدعوا إليه حزب المؤتمر الهندي، الذي كان يؤسس دعوته على مقولة “القومية السياسية الواحدة” للهند؛ إذ رأى في هذه القومية السياسية، سبيلًا لسيطرة الأغلبية الهندوسية على الأقلية المسلمة. هذا بالإضافة إلى أنه رآها ـ بمحتواها العلماني ـ أيديولوجية معادية للإسلام.
ضد هذه القومية بعينها كان هجوم المودودي؛ فقال عنها “إنها دين جديد” يناقض الدولة الفكرية الإسلامية، ويحول بين أصحابها وبين النزعة الإنسانية، وهي تعني “أن يحل الشعب محل الألوهية”.. ولذلك فليس لها مكان ولا حظ في “إيجاد دولة الإسلام الفكرية وتركيبها”. ثم، يمضى الرجل فيسوق ضد هذه القومية، التي رأى أنها ستمكن الهندوس من السيطرة على الأقلية المسلمة في الهند، كل الاتهامات.
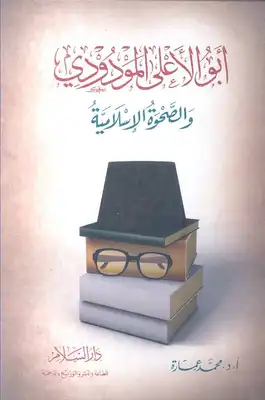
المودودي وتناقض الرؤى
هذه الاتهامات، هي نفسها التي جاء سيد قطب، فانتزعها من ملابساتها، ودوافع الواقع الاجتماعي الذي نشأت فيه فكرة المودودي، ووظفها في إطار الأمة العربية، ذات القومية الواحدة، والتي يكون المسلمون فيها أكثر من 95% من تعداد أبنائها.
وبصرف النظر عن سيد قطب، الذي تتلمذ على أفكار المودودي، والذي أفردنا له نصيبًا في نقد مقولاته، أثناء دراستنا لـ”الإسلام والحاكمية” التي نُشرت في سبع حلقات في هذا الموقع.
ويمكننا القول هنا، أنه إذا كان الواقع الاجتماعي الهندي المتعدد القوميات، والواقع الدعائي العدائي للقومية إبان الحرب الثانية.. قد أثّرا –دون شك– في تبني المودودي لمقولة “القومية عصبية عدوانية”.. نجد أنه حينما تقوم دولة باكستان في أغسطس 1947، سيلائم المودودي بين بعض أفكاره وبين نظم الحكم في الدول الحديثة.
بل، وسيشهد قبل وفاته أن الدولة الإسلامية التي قامت وتحمل اسم باكستان على أساس من وحدة الانتماء إلى الدين، لم تلبث كما يذكر عصمت سيف الدولة في كتابه “عن العروبة والإسلام، 1986” بعد ربع قرن من الزمان “أن انشقت إلى دولتين إسلاميتين في النظام أيضًا، على أساس من وحدة الانتماء القومي.. فينفصل شعب البنغال (نحو خمسين مليونًا يتكلمون اللغة البنغالية)، بإقليمها الشرقي مكونًا دولة بنغلاديش، ويبقى شعب البنجاب (نحو خمس وأربعين مليونًا يتكلمون اللغة الأردية) دولة مستقلة باسم باكستان في إقليمها الغربي (1972)…”.
وهكذا، تثبت التجربة الحية ـ لمن يعقلون ـ أن “وحدة الانتماء إلى الدين” لا تلغي “وحدة الانتماء القومي” وأن اختلاف الانتماء القومي لا يعارض ولا يناقض وحدة الانتماء الديني، وأن تجاهل أو إدانة أو مناهضة القومية من أجل إقامة دولة إسلامية لا يؤدي إلا إلى إخفاق هذه الدولة الإسلامية في المحافظة على وحدتها.

بقي أن نقول: إن المودودي، الذي تم الاستناد إليه في تلك المقولة عن القومية.. هو نفسه، وفي كتابه “الإسلام والمدنية الحديثة” يقول عنها “… أما القومية، فإن أريد بها الجنسية فهي أمر فطري لا نعارضه، وكذلك إن أريد بها انتصار الفرد لشعبه، شريطة أن لا يستهدف تحطيم الشعوب الأخرى، وإن أريد بها حب الفرد لشعبه فنحن لا نعارضها كذلك، إذا كان هذا الحب لا يعني معنى العصبية القومية التي تجعل الفرد يحتقر الشعوب الأخرى، وإن أريد بها مبدأ الاستقلال القومي، فهو هدف سليم كذلك، فمن حق كل شعب أن يقوم بأمره ويتولى بنفسه تدبير شؤون بلاده.. أما الذي نعترض عليه ونعتبره شيئًا ممقوتًا نحاربه بكل قوة، فهو القومية التي تضع ذاتها ومصالحها ورغباتها الخاصة فوق جميع الناس ومصالحهم ورغباتهم، والحق عندها هو ما كان محققًا لمطالبها واتجاهاتها ورفعة شأنها، ولو كان ذلك بظلم الآخرين وإذلال أنفسهم”
هنا.. نقف لنتساءل إلى أي من رأيي المودودي ننحاز؟ هل ننحاز إلى نفيه للقومية وربطها بالعصبية، ووضعها كنقيض معادٍ للإسلام.. أم إلى رؤيته الإيجابية للقومية التي تدعو لمبدأ الاستقلال وانتصار الفرد لشعبه والانتماء للوطن؟!.
قطعًا، لا نتأدى من هذا التساؤل محاولة إظهار التناقض الداخلي الكامن في رؤية المودودي إلى القومية، بقدر ما نتغيا وضع اليد على مكمن الخطأ الأساسي الذي أدى إلى مقولة إن “القومية عصبية عدوانية” وانتشارها طوال فترة طويلة من الزمن دون ما تدقيق نظري.
ولا نغالي إذا قلنا إن الخطأ المشار إليه ينبع من الخلط الحاصل في ما بين المسألة السياسية، والواقع الاجتماعي التاريخي، في ما يخص القومية عمومًا، والقومية العربية على وجه الخصوص.
وبعد.. فما كان كل هذا الحديث عن الإسلام والقومية، إلا من أجل محاولة تجاوز واحد من أهم عوامل تعثر المسيرة النهضوية لهذه الأمة العربية، التي كتب الإسلام لها تاريخيًا وحضاريًا شهادة ميلادها.. وهو العامل الخاص بالصراع السياسي الداخلي، الذي نجح البعض في إلباسه ثوبًا عقائديًا… يتبع.













