كيف أصبح ملياردير العقارات الذي لا يمتلك أي خبرة سياسية رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية؟ وكيف صوتت بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوربي؟
يناضل المحللون السياسيون على جانبي الأطلسي لتقديم إجابة ناجعة على هذه الأسئلة منذ عام 2016. بدرجة كبيرة، ترتكز التفسيرات على دوافع الناخبين، وبدرجة أكبر تبدأ الإجابات وتنتهي عند الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
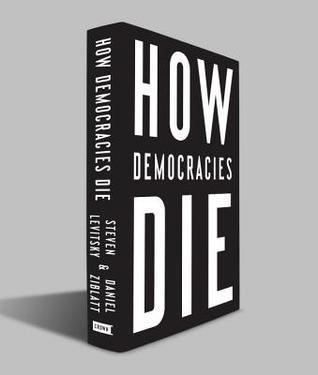

ستيفن ليفيتسكي ودانيل زيبلات، أستاذا العلوم السياسية في جامعة هارفارد – أفزعهما بشدة وصول ترامب إلى سدة البيت الأبيض، شأن غيرهما داخل وخارج الولايات المتحدة، يحاولان عبر كتابهما How Democracies Die الذي نشر في يناير 2018 أن يأخذا بالقضية إلى آفاق أبعد، والبحث عن إجابات بين أطناب التاريخ.
رغم ذلك، لا يمثل هذا الكتاب بحثا تاريخيا ممنهجا؛ إذ ينتقل من محطة تاريخية إلى أخرى ليثبت فرضيته؛ فيتجول بين دعوى “الزحف إلى روما” في الفترة الفاشية، وصعود ألبرتو فوجيموري إلى سدة الحكم في بيرو، وموت الديمقراطية على يد سلفادور أليندي في تشيلي، وصولا إلى عهد ما بعد الديمقراطية وما بعد الحداثة في روسيا بوتين.
بالنسبة إلى ليفيتسكي وزيبلات، تعود أهم تجليات الكارثة الديمقراطية الآنية في الولايات المتحدة إلى العام الأخير من حكم أوباما، ففي أعقاب موت أنطونين سكاليا، قاضي المحكمة العليا الأمريكية، المحسوب على تيار المحافظين، في بداية عام 2016، قام الرئيس السابق أوباما بترشيح ميريك جارلاند، الليبرالي المعتدل، ليحل محله، وأصبح مجلس الشيوخ، وفقا للدستور الأمريكي، مخولا بقبول هذا الترشيح أو رفضه، لكن المجلس فعل ما لم يفعله على مدى 150 عاما؛ فقد رفض حتى مجرد عقد جلسة استماع لجارلاند.

لم يكن للأمر علاقة بترامب على الإطلاق؛ حيث كان أغلب الجمهوريين في مجلس الشيوخ آنذاك متوجسين بشدة، وربما رافضين، لوصول ترامب إلى سدة البيت الأبيض؛ وإنما كان يتعلق برؤيتهم المشتركة بأن أي مرشح جمهوري لعضوية المحكمة العليا الأمريكية سيكون أفضل من أي مرشح ديمقراطي، حتى لو كان الثمن هو تطبيق سياسة ’الأرض المحروقة‘.
يطلق ليفيتسكي وزيبلات على هذا النموذج في الممارسة السياسية “تآكل المعايير”، وهو ما يعتبرونه الخطر الداهم الذي يتهدد الديمقراطية المعاصرة. يعًرف الكاتبان ’المعايير‘ بأنها حزمة القواعد والاتفاقيات غير المعلنة التي تحافظ على البناء الديمقراطي حتى لو جاء ذلك على حساب بقاء الحزب الحاكم في السلطة.
رغم ذلك، يشخص الكاتبان ما فعله مجلس الشيوخ في عام 2016 بأنه “لم يكن بحال مخالفة قانونية أو انقلابا على الدستور، وإنما – وهنا مكمن الأزمة–عدم امتثال صارخ لقواعد اللعبة”. في هذا السياق يحاول ليفيتسكي وزيبلات حلحلةالفكرة الراسخة التي تربط بين تطبيق الدستور وازدهار الديمقراطية، ويمثلان لذلك بانهيار التجربة الديمقراطية في جمهورية فايمار في ألمانيا أمام الزحف النازي، ويخلصان إلى “أن الاعتقاد بقدرة المؤسسات القويمة على استيعاب السياسيين المنحرفين ضرب من السذاجة السياسية”.
يمضي الكاتبان أبعد من ذلك، إذ يؤكدان أن البناء الديمقراطي يقوم في جوهره على ركيزتين أساسيتين، هما “التسامح المتبادل” و”الأناة المؤسسية”؛ إذ تؤديان في نهاية المطاف إلى النتيجة نفسها: مقاومة إغراءات إنفاذ الحيل الرخيصة للتشبث بالسلطة”، ويخلصان إلى أن هذا تحديدا هو ما لا يفعله ترامب.
ما حجم السوء الذي يمكن أن تؤول إليه الأمور؟ يعرض الكتاب الذي يقع في 320 صفحة دراسة مقتضبة عن السياسات الاستبدادية في العالم ليجد أن ثمة نموذجا واحدا يكرر نفسه: “لم تعلق الأنظمة الاستبدادية في القرن الحادي والعشرين الدستور، ولم تستبدله بالدبابات في الشوارع … إنهم يمتدحون الدستور، بينما يتجاهلونه كأنه غير موجود”.

لقد استبدل الرئيس بوتين رسميا أدوار رئيس الدولة ورئيس الوزراء حتى يتمكن من التلاعب بالقواعد دون مخالفة الدستور، كما انتهج فيكتور أوربان في المجر، ونيكولاس مادورو في فنزويلا، وناريندا مودي في الهند، وغيرهم كثيرون سياسات قمعية مشينة ضد معارضيهم السياسيين، ولا يختلف ترامب كثيرا عن هذا النموذج.
يسبر الكتاب بعد ذلك أغوار التاريخ ليستمد منه استراتيجيات الزود عن المعايير الديمقراطية في الوقت الذي تواجه فيه خطر التقويض، ويخلص إلى إمكانية المقاومة، فالأحزاب الرئيسة يمكن أن تتحالف ضد النظم الاستبدادية، على غرار ما حدث في ثلاثينيات القرن الماضي عندما تعرضت الفاشية الناشئة في بلجيكا للهزيمة بعد انضمام الحزب الكاثوليكي اليميني إلى صفوف الليبراليين. وبعد نهاية الحرب العالمية الثانية، أبدت الأحزاب اليسارية واليمينية في ألمانيا استعدادا للعمل معا للحيلولة دون تمكين الأحزاب المتشددة، وفي تشيلي، تعرض بينوشيه للسقوط أخيرا في عام 1989 على يد تحالف ضم الديمقراطيين المسيحيين والاشتراكيين الذين أعلنوا التزامهم المشترك بالمحافظة على الديمقراطية.

يخلص الكتاب إلى أن ديمومة الديمقراطية تقتضي تولد رغبة صادقة لدى النخبة السياسية في تقديم الاستقرار طويل المدى على المصالح قصيرة المدى. رغم ذلك، تكمن نقطة الضعف الرئيسة في الكتاب في نظرته إلى التاريخ باعتباره حزمة من الدروس التي يجب استلهامها، دونما اعتبار كاف للسياق. فالكتاب يقدم مجلس الشيوخ الأمريكي في خمسينيات القرن الماضي كنموذج للمؤسسات التي اتكأت على “التسامح المتبادل” باعتباره حجر الزاوية الذي تقوم عليه قواعد اللعبة الديمقراطية، بينما – وهو الثابت التاريخي الذي يعرفه المؤلفان جيدا – كان هذا المجلس نفسه هو المؤسسة التي رسخت بقوة للنظام العنصري في الجنوب الأمريكي.
ينتقد الكتاب المفكر السياسي الفرنسي، مونتسكيو، لإصراره على أن الصياغة المحكمة للدستور تكفي لكبح جماح القوة المفرطة في العمل السياسي، لكن الكتاب نفسه يتجاهل أن العملية السياسية ليست عملية جامدة، وإنما تتأثر بالأوضاع الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وحتى المناخية المحيطة بها، كما يتجاهل الأسباب التي تثير حالة السخط الشعبي العام الراهن على الأعراف الديمقراطية، بما في ذلك تأثير التكنولوجيا الرقمية، والطبيعة المتغيرة للعمل، ومخاطر تصاعد عدم المساواة، وإعادة تشكل العلاقات الجندرية، وغيرها.
*هذه المادة مترجمة













