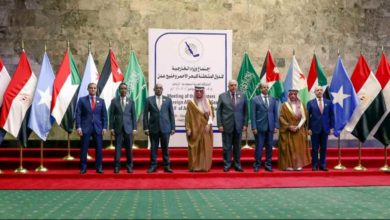لم يطف بخيالي يومًا أن أكون ضيفًا على إيران، وأنا المولود في نفس عام ثورتها، لأجد وجداني ترعرع متوازيًا مع سنوات العداء المرير الممتد بين دولتي المصرية ودولة آيات الله هناك.. هل تسافر ضمن وفد من الصحفيين إلى طهران؟.. كانت الإجابة على الفور: نعم ولم لا؟!. اعتدت كسر المحظور، وكشف المطمور.. لقد تهاوى في لحظة ما راكمه الوجدان في سنين طوال.

أوشكت طائرتنا على الهبوط في مطار “الخوميني”.. فتهادى إلى مسامعنا صوت يطالبنا بشد الأحزمة.. فهرولت فتيات ذوات ملامح فارسية، في اتجاه غرفة الحمام، ثم عدن وقد غيرن ملابسهن، إذ تحشمن، وغطين رؤوسهن بقطع من القماش.. لم يفاجئني ذاك المشهد فكنت قد سمعت عنه من قبل، لكن غمامة الحزن التي كست وجوههن هي التي استحضرت التأمل حيث توقفت موجات الضحكات المنبعثة من أفواههن مذ ركبن معنا الطائرة المقلعة من “أبو ظبي” في اتجاه طهران… ساد الهم وخيمت الكآبة.
لم يكن المشهد الأول ليمكث في قاع الذاكرة لولا أن انضم إليه مشهد المغادرة فربط معه ولم يفترقا.. فبعد أن مكثنا أحد عشر يومًا عدنا أدراجنا إلى مطار طهران، قاصدين أبو ظبي مجددًا، فصعدت معنا فتيات من ذوات الملامح الفارسية إلى سلم الطائرة، كن يرتدين نصف حجاب يكشف عن نصف رؤوسهن، وما إن أقلعت الطائرة، حتى دخلن غرفة الحمام، فغيرن ملابسهن، وجلسن بجوار عدد من الشبان الإيرانيين، ثم تعالت الضحكات، وانخرطوا في حوارات حميمية.
هبطت الطائرة في مطار أبو ظبي، وبدأ الركاب في النزول، تكاد عيناي لا تفارقهن، حتى نزلن أمامي من مدرج الطائرة، فانطلقت صيحاتهن متعالية بلهجة عربية متكسرة (أبو ظبي أبو ظبي)… كانت فرحتهن عارمة.. كأنهن كن في سجن فتحت أبوابه للتو للخروج منه.. كأنها فرحة الانعتاق من القفص المحكم… هل يعشقن أبو ظبي لهذا الحد، أم ضاقت عليهن أرض فارس بما رحبت؟

ها أنا ذا في العاصمة الإيرانية، تشبه السيارات بعضها بعضَا، وتنتشر الحدائق في كل مكان، إنها مدينة جميلة ونظيفة، لكن سحائب الحزن تخيم على كل جوانبها، لم أكن أعرف مبعث ذلك، هل يمكن أن يكون شعورًا داخليًا، أفرزه ما هو ما ذاتي ومتراكم؟.
كان المرافقون في انتظارنا في الفندق فرحبوا بنا وبالغوا في كرم الضيافة، ومنحونا شرائح للهاتف المحمول إيرانية عوضًا عن المصرية، فأسر إلينا أحد رفقائنا بأنها شرائح للتجسس أعدت لمراقبتنا من قبل الحرس الثوري، أخذ بعضنا ذلك بسخرية والآخر بجدية، لكن في النهاية رفض معظمنا التعامل معها، واكتفي بشريحة الجوال المصرية.. أطبقت على صدورنا الهواجس الأمنية.
انقطع اتصالنا بالعالم الخارجي، ولم نعد نشاهد إلا عددا من القنوات باللغة المحلية، ولم تكن مواقع التواصل الاجتماعي التي درجنا على استخدامها في بلادنا متاحة، فقد حجبتها السلطات تقريبًا، فشعرنا بتداعيات الحصار الداخلي.. فضلا عن مظاهر الحصار الخارجي البادية آثاره في كل مكان، إنه شيء مزعج للغاية لنا، نحن القادمين من فضاء مفتوح، إلى آخر مغلق، ساهم في إغلاقه ما فرضته الثورة الإيرانية من قيود والتزامات مجتمعية تزايدت على النظام العام.. كان مجتمعا يشبه مجتمعنا المصري في وقت ما، حتى حاول الملالي أن يسمته بسمته، فبدت قطعة القماش الصغيرة التي تكشف من رأس المرأة أكثر ما يستر دالة على الخوف من تطبيق القانون ورغبة المواطن الكامنة في التحرر.
هنا تندفن الرغبات غير المشروعة تحت مسميات مشروعة وأخرى ليست كذلك.. فمن سائقي التاكسي الذين ينتشرون حول المطار قليل الامكانيات، تلتقط أعينهم الغرباء، فيقتربون منهم خفية وينطقون بكلمة بالعربية”متعة متعة؟” إلى الفتيات التي انتشرن في بهو الفندق، يرسلون النظرات في انتظار وريقة مدون بها رقم الغرفة.
حاول أحد الرفقاء أن يستجلب “الحشيش” إلى داخل فندق “صفا” في مدينة قم “المقدسة”، رغم أنه لم يكن يدخن سوى السجائر في العادة، إلا أنه حاول تحدي النظام، فطلب من النادل استجلاب المخدر مقابل بعض الأموال ففعل ذلك، وأصر على تعاطيه داخل غرفته قائلا أنا أدخن الحشيش في المدينة المقدسة.
يجيد مرافقنا الإيراني التحدث باللغة العربية بطلاقة، كاشفنا بأنه ينتمي لعرب الأهواز، إلا أن بعض رفقائنا كان يكاشفه بالقول أنه مخابرات إيرانية، وبعدها يضج الجميع بالضحك، إلا أبو محمد فكان مغرقا في الالتزام والجدية الصارمة، ومنضبطا في مواعيده وانصرافه يحاول أن يفرض علينا جميعا ذلك، فتمرد عليه عدد منا ضاربين بقوانينه عرض الحائط… أبو محمد وهو اسم حركي لم يكشف لنا عن مسماه الحقيقي.
في كل مرة يستقل معنا أبو محمد الباص الصغير البائس، كان يشير إلينا صائحا بفخر “هاي نفق نفق”، حتى أخذها عليه رفقاؤنا فكلما اقتربوا من النفق صاحوا “أبو محمد هاي نفق نفق، لدينا في مصر منه الكثير” فضج أبو محمد بالضحك.. أخيرا ضحك أبو محمد.. استطاع المصريون أن يحطموا جدية أبو محمد، حتى بات ينفجر من الضحك في كل مناسبة.. ومن غير مناسبة.

كنا نتعرض لحصار شبه مطبق عبر المرافقين الذين انتدبتهم جامعة المصطفى لمرافقتنا، وكانت الحجة الخوف على أمننا الشخصي، لكننا كسرنا الحصار في عدة مرات. كانت السيارات في الخارج تشبه بعضها إلا فيما ندر، سألنا سائق التاكسي، ما صنع تلك السيارة؟، فأجاب وهو يهز رأسه في سخرية: صناعة إيراني.. عرفنا بعد ذلك أن تلك السيارات كورية الصنع، واستطاعت الحكومة الإيرانية، أن تحصل على ترخيص بتصنيعها محليا.
هربنا من الفندق في اتجاه شوارع لا نعرف لها مداخل من مخارج، حتى وجدنا مقهى يشبه المقاهي المصرية، فطلب مرافقي النرجيلة فاكتشفنا أنها تشبه حد التوافق النراجيل المصرية .. هل أنتم مصريون؟ .. نعم .. ماذا أتى بكم إلى هنا.. جئنا كي نرى حضارتكم العظيمة؟ ضج الرجل بالضحك.. أي حضارة؟ إن الملالي المجانين يهدرون خير بلادنا على غيرنا.. كيف لهذا الرجل أن يتحدث لنا بمثل ذلك الحديث؟.. يعلو كل شارع صورة لشخص مكتوب عليها اسمه مسبوقا بلقب الشهيد، كأن النظام يلح على تذكرة الشعب بالموت في سبيل ثورته.