في بحث كتبته في السجن حاولت التعمق في أسباب ظهور الإحياء الإسلامي المعاصر، هل هو الموقف من الغرب باعتباره حاول فرض التخلف والتبعية علي بلادنا، وجاءت ظاهرة الإحياء تعبيرا عن مقاومته حتي يتحقق لبلداننا التقدم والنهوض؟ أما أنها نتاج جدل داخلي بين السلطان والقرآن؟ بمعنى أن السلطة حين تبعد عن الاحتكام للقرآن تخلق مشكلة شرعية تدفع لظهور حركات غضب واحتجاج تقول للسلطة أن تستقيم على منهج القرآن كما في الحديث: “ألا إن القرآن والسلطان سيفترقان فكونوا مع القرآن حيث كان”. أو أنها تعبير عن فشل المشروع القومي مع هزيمة 1967 الكارثية، باعتبارها في جوهرها بحث عن بديل مختلف.
الباحث الفرنسي “فرنسوا بورجا” في كتابه “الإسلام السياسي.. صوت الجنوب” اعتبر الإحيائية الإسلامية المعاصرة تعبيرا ثقافيا بالأساس، يختلف عن التعبير الثقافي لمشروع القومية العربية “أمة واحدة ذات رسالة خالدة”. الصديق والباحث اللبناني المخضرم رضوان السيد كشف لي عندما التقيته في أحد مؤتمرات كلية الاقتصاد والعلوم السياسية أنه وثلة من الباحثين كانوا يناقشون بحثي عن “الإحياء الإسلامي” في مؤتمر بالكويت عن الإحيائية الإسلامية، والشاهد هنا أن حالة الإحيائية الإسلامية المعاصرة تلك كانت موضع الاهتمام في كل جانب من أصقاع الأرض.
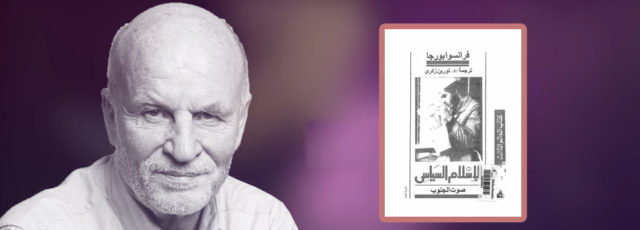
فرنسوا بورجا، وكتابه “الإسلام السياسي.. صوت الجنوب”
وأذكر أنني بحكم تخصصي في العلوم السياسية كنت أتابع النقاش حول هذه الظاهرة وسجلته في بحثي المشار إليه، وكنت حتى ذلك الوقت من منتصف عام 1986 أستخدم الكنية في التعبير عن ذاتي وفق الطريقة السلفية القديمة، فكتبت في نهاية البحث “كتبه الفقير إلى عفو ربه أبو عبد الرحمن” ما جعل المستشار طارق البشري في أحد لقاءاتنا يسألني من هو أبو عبد الرحمن هذا؟ كان الاستبشار كبيرا بالظاهرة وكان العالم يفتح ذراعيه لها، وكنت أرى الظاهرة الإحيائية ذات منزع فطري في مجتمع يريد أن يعود إلى الجذور الأصيلة الصحيحة للدين الإسلامي باعتبار الدين أساس التقدم وأساس مواجهة المشروع الصهيوني وتحقيق الاستقلال ومقاومة التبعية.
كان الجيل المعبر عن الظاهرة الإحيائية الجديدة مبشرا، معبرا عن تواصل مع تدين آبائه وأمهاته الذين ورث عنهم هذا التدين وأحب لأجله الدين، وكانت أولي المشكلات التي واجهت تلك الطاقة الكبيرة من الشباب ما تعرض له من عملية سطو حقيقية، مرة من الدولة حين حاولت توظيفه في صراعها مع قوي اليسار، ومرة أخرى حين هجمت عليه التنظيمات القديمة بعقدها ومشاكلها ومراراتها مع السلطة السياسية والنظم الحاكمة، فأدخلته في أقفاصها وهو بعد لا يزال غضا طريا رقيق العظام والأفكار، فحولته من التدين الفطري الذي ورثه عن مجتمعه إلى تدين التنظيمات الأيديولوجي الذي يقسم الناس إلى فئات وجماعات وفرق ومذاهب، وكان أخطر ما واجهته ظاهرة الإحيائية الإسلامية الجديدة أن أعتبرت السلطة أداتها في تحقيق رجائها المأمول والمتوهم بقيام خلافة إسلامية.
وبعد أن كانت الإحيائية الإسلامية الجديدة جزءًا من أمتها ومجتمعها كما بدأت، راحت تنفصل عنها وتقف منها موقف المخاصم الناقد القاسي الشديد عليها وتذهب إلى اعتبار تلك المجتمعات جاهلية وديارها ديار كفر وسكانها ليسوا مسلمين، لأنهم جاهلون بمعني “لا إله إلا الله” ولا يُعذر أحد منهم بجهل ولا تؤكل ذبائحهم ولا تصح الصلاة في مساجدهم، لأنها مساجد سلطة وضرار والأئمة الذين يصلون بالناس فيها لا تجوز الصلاة خلفهم، والأصح أن تتخذ البيوت قبلة للصلاة.
هنا أصبحت الإحيائية الإسلامية الجديدة قوة مبددة وليست رأسمال اجتماعي ورمزي لأمتها، وأخطر شيء وقعت فيه أنها وضعت نفسها في مواجهة أمتها، ورأت أنها لكي تتجاوز تلك الأمة الراكدة الفاسدة عليها أن تبني أمتها هي عبر ما أطلق عليه سيد قطب “الطليعة المؤمنة” التي تنهج وفق ما عبر عنه في كتاباته “الاستعلاء الإيماني”.
وهكذا وجد الإحيائي المعاصر نفسه يبني عالما موازيا لعالم من يعيش بينهم، ويدخل في مواجهة معهم سعيا لتأكيد نفسه ووجوده وهويته، ما يعني أن يصبح خصما لأمته لا يضيف إليها جديدا، بل يبذر الشقاق والتنازع والاختلاف داخلها، وبدلا من أن يكون إضافة لأمته أصبح عبئا عليها ومنزعا للشقاق والاختلاف والتمزق داخلها.












