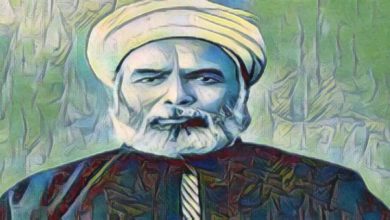ربما يُدهِش بعض المراقبين ما آلت إليه أوضاع حركة النهضة التونسية في المشهد السياسي المحتدم هناك، خاصة ما أثبتته الحركة من قدرة مشهودة على تجنب آثار موجات تسونامى ضرب كل حركات الإسلام السياسي في المشرق والمغرب. لكن الدهشة ربما تختفي عندما نرى كتابات نقدية عميقة انطلقت قبل عقود، وتحديدا فى منتصف الثمانينيات، تؤكد التباين الواضح بين تجربة الإسلام الحركى فى المغرب عنها فى المشرق، فالأولى انطلقت وتطورت من أرضية المقاصد، بينما تكلست الثانية بفعل الالتصاق المرضي بالطقوس والنصوص.
من تلك الكتابات الجديرة بالتوقف في متابعتنا لمشهد الإسلاميين في المغرب، ما كتبه صلاح الدين الجورشي أحد أهم منظري وناقدي الحركات الإسلامية، وأحد رواد حركة اليسار الإسلامي في المغرب انطلاقا من تجربة حركية وفكرية لافتة.
يؤكد الجورشي في دراسته التى تحمل عنوان “الحركة الإسلامية مستقبلها رهين التغييرات الجذرية”، أن ثمة عيوب جذرية في بيئة عمل الحركة تستلزم تغييرات عميقة.
يلفت الكاتب فى بداية دراسته إلى ان الاهتمام بالظاهرة الإسلامية الحركية وصل مداه مطلع الثمانينيات من القرن الماضي، إلى حد أن المخابرات الأمريكية مولت فى العام 1983 فقط، بشكل كامل أو جزئى، أكثر من عشرين مؤتمرا وندوة فى موضوع ظاهرة “الصحوة الإسلامية” حسب تسميته. وهنا يبادر الجورشي بالسؤال: هل الحركات الإسلامية واعية بأدوارها؟ وهل هي قادرة على ضمان مستقبلها؟ هل ترشحها أوضاعها الداخلية ومرتكزاتها النظرية وطبيعة علاقاتها ببعضها وببقية الأطراف الفكرية والسياسية إلى استدراك آفاتها؟

ويجيب أنه ينبغي أولا إدراك أن الحركة الإسلامية ليست كتلة مصمتة متجانسة، بل هى تتباين في الحجم والأهمية والتأثير من قطر لآخر ومن تجربة لأخرى، وإن اختلافها هذا لا يمنع من التقائها على أرضية واحدة، يجزم أنها أرضية “هشة”، ثم يفصل فى تعديد مظاهر العافية أو الضعف التي يراها من واقع تأمله فى مسيرتها واستشرافه لمستقبلها.
ينقد الجورشي خطاب تلك الحركات ويصفه بأنه خطاب معبأ يلح على اعتبار الإسلام منهج حياة يتوخى استعادة وترميم الأمة وإعادة الاعتبار لها ولمشروعها الحضارى، بالإحالة إلى الشعار بديلا عن المضمون أو البرنامج. ورغم يرى أن تلك الحركات تتسم بـ”صلابة أخلاقية” تركز بشكل كبير على الجوانب السلوكية والأخلاقية للأفراد والمجتمعات.
وفي تقديرى أن هذا التركيز لم يترجم فعليا في قشرة أخلاقية سميكة تصمد للتغييرات أو تسعف بالحلول الناجزة، حيث كشفت تجربة خروج الإخوان من الحكم مثلا عن حالة من الكراهية والحنق على المجتمع والسلطة، تجلت في مشاهد عنف متباين بالشكل الذي يكشف أن تلك القشرة الأخلاقية هشة الى حد بالغ، وأن الأخلاق لم تكن سلوكا أصيلا بقدر ما كانت لونا من ألوان التقية التي تأتى ضمن مستلزمات غزو القلوب والعقول، تمهيدا لفكرة التمكين التي سيطرت على عقل الجماعة المعتل، الذى جسده ما سماه الكاتب التنظيم الدفاعي. ويشير الكاتب هنا إلى أن المعارضات التى نشأت في التاريخ الإسلامي منذ أواسط القرن الأول الهجري اختار معظمها صيغة التنظيم المحكم والمنغلق على نفسه، وكلما اشتد قمع السلطة واتسع سلطانها زادت تلك التنظيمات المخالفة انغلاقا وسرية، لافتا إلى تمايز تجربة الشيعة، حيث حافظوا على تقاليدهم التنظيمية كفرقة مستقلة لها هويتها وهياكلها، مقارنة بأهل السنة كأغلبية حاكمة نمت ضمنها الجماعات والطرق الصوفية كأشكال متميزة لتأطير الأفراد الباحثين عن حماية تعزلهم عن بطش السلطة، كما ساهم التصاق الحركات الإسلامية بالتراث التنظيمي للفرق الإسلامية في إكسابها نوعا من الجاذبية والهلامية فى ذات الوقت.

عنف جماعة الاخوان
لم تهتم الحركات الإسلامية بتجذير وجودها عبر اكتشاف القوى الاجتماعية التي تمثلها، والاقتراب من فهم التاريخ باعتباره تاريخ صراع الطبقات الاجتماعية، فهي لم تهتم سوى بتقسيم حدي يعرف العالم على أنه عالم الصراع بين الخير والشر، الإيمان والكفر، ما حرم تلك الحركات من وجهة نظره من تلمس الجذر الاجتماعي لدورها ووجودها.
وفي معرض انتقاده لحجم التوقعات التي يعتقدها هؤلاء في تأثير خطابهم، يقول: “يخطىء الإسلاميون عندما يعتقدون أن الصدى الذي يلقاه خطابهم مرجعه قوة الخطاب الذي أنتجوه، وينسون أن الاحتماء بالمسجد هو بحث عن الذات ودفع للخطر وتجديد للحلم وتحد للأزمة. ويضيف: هم في النهاية يستفيدون من أوضاع لم يصنعوها، وأتصور أنهم شاركوا فى صناعة تلك الأوضاع التى استفادوا منها إذا أنصفنا بالقول، فقد كانوا دوما تناقضا مع مسيرة الدولة الوطنية عبر عقود، وامتصوا حيوية الشعوب فى قضايا فرعية، عبر التركيز العقيم حول سؤال الهوية بديلا عن سؤال التحديث، لافتا إلى أن تراجع القوميين والماركسيين فى عالمنا يمنح الإسلاميين فرصة ترشحهم للقيام بالدور المجمع للتناقضات.
يعترف الجورشي أنه بالرغم من ضخامة التضحيات التي قدمتها تلك الحركات والعدد الهائل من الشباب والكتل البشرية التي اصطفتها وربتها، إلا أن معظم الأهداف التي نادت بها هذه الحركات خاصة فى الرقعة السنية لم تتحقق، حيث تبقى الأزمة هيكلية وليست عرضية، فهذه الحركات تقوى بالأزمات وتضعف عندما يخف الضغط عليها.
واعتبر أن “عوامل القوة فى خطابها هى ذاتها عوامل الضعف، حيث لا تتوازن المكاسب أبدا مع التضحيات، ما دامت تملك جهاز تبرير الأخطاء وتفسيرها في سياق يحفظ التوجهات العامة لها ويحافظ على مسارها كما هو”، مستعرضا في دراسته مقومات هذا الخطاب التبريري.