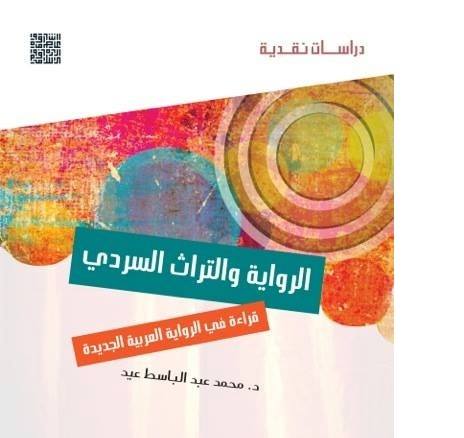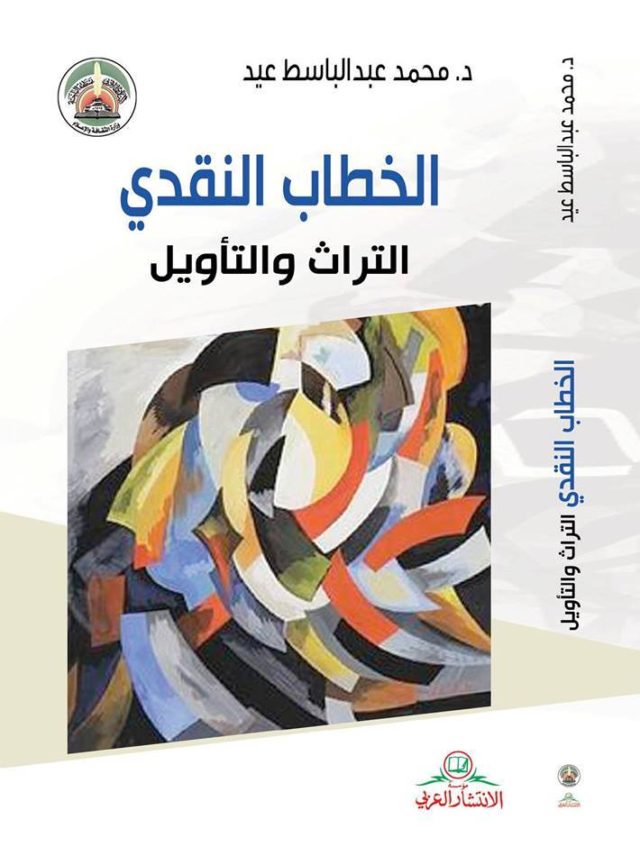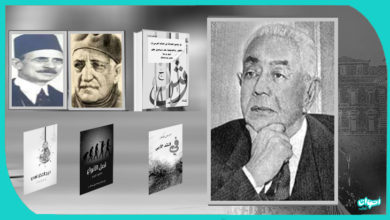محمد عبد الباسط عيد واحد من النقاد الذين لم يتخلوا عن دورهم في الاشتباك بالنقد مع راهن المشهد الثقافي دون التخلي عن أدوراهم الأكاديمية في البحث النقدي والتدريس، لذا لم يكن غريبا أن نرى اسمه على قائمة ترشيحات جائزة الشيخ زايد، فرع الفنون و الدراسات النقدية، عن كتابه “الخطاب النقدي.. التراث والتأويل”.
في حوارنا معه هنا يسلط عيد الضوء على أزمة النقد العربي، الذي يشكو البعض عجزه وكسله وإغراقه في الأكاديمية، فيما نشهد انسحاب أسماء واعدة في هذا المجال، سواء بالهجرة أو الانزواء في الظل، لغياب فرصة حقيقية لظهور إسهاماتها. ويشدد عيد على ضرورة تسلح الناقد العربي بالاطلاع على النظرية الغربية بجدية مع تقديمه مقاربات مستمرة لتراثه.
لماذا اخترت أن تبدأ مشوارك مع علوم القرآن؟
لم أذهب إلى التراث بتخطيط مسبق، المصادفة وحدها قادتني إلى التراث، أو قادته إلىّ، عبر قراءة غير منتظمة في كتب أدارها الأقدمون حول الإعجاز القرآني، من أهمها كتاب السيوطي “مُعْتَرَك الأَقْرَان فِي إعْجَازِ الْقُرْآن”. بدأت ذلك المشوار في فترة الانتظار التي قضيتها بعد إنجاز أطروحة الدكتوراه وقبيل مناقشتها، وكنت مشغولا وقتها ببلاغة الخطاب كما قدمتها النظرية الغربية.
والحقيقة أن السيوطي صاغ في هذا الكتاب عدة نصوص قصيرة لفتت انتباهي بنافذ عمقها، وموجز صوغها، وإحاطتها بجوهر ما انتهى إليه النظر المعاصر في نظريات الخطاب واستراتيجيات تحليله. ودفعني نفوري من حرص جُلِّ الباحثين على تأصيل كلِّ جديدٍ وافد بالبحث عن جذوره في التراث، يتلمسون لذلك أوهى الصلات وأوهن العلاقات، وكأنَّ العالم كله قد توقف إزاء تراثنا، وكأن شرعية التراث رهنٌ بأن ينطق بهذه النظرية أو تلك.
هل تعني أنك رجعت لقراءته مرة أخرى؟
نعم، ونتيجة لذلك النفور لم أمنح هذه النصوص ما تستحق من أهمية، على وضاءتها، واعتبرتها حينئذ مجرد إشارات عابرة، لم يقصد بها “السيوطي” على وجه الدقة ما أدركته أنا فيها من أبعاد تتعلق ببلاغة الخطاب، وبدت لي مجرد إشارات وقع عليها ذهنٌ موسوعيٌّ نافذُ البصيرة خطِرُ الإدراك، ولكن قراءة أخرى أكثر انضباطًا وتأنيًا كشفت لي عن رسوخ هذا النظر، وأنه يشكّل مستو متطورًا آل إليه البحث في قضية “إعجاز القرآن”؛ القضية الأم التي تفرَّعَتْ عنها جلُّ مجالات البحث التراثي، فكان علىَّ أن أبحثَ في هذه النصوص، وأن أتتبعها في سياقاتها المختلفة.
وما إن تقدَّم البحث قليلا حتى قادني “مُعْتَرَك الأَقْرَان” إلى كتاب آخر يدور مدارَه، هو “أسْرَار تَرْتِيب الْقُرَآن” الذي يعزى إلى “السيوطي” أيضًا، أسرني هذا الكتاب بمنهجيته ودقته واقتصاره على الجانب التطبيقي وحده، فكان ضروريًا أن أقرن هذا بذاك، محاولا تبين الأسس المعرفية التي شكلت جوهر هذا البحث؛ وتأكد لي أنَّ “السيوطي” وضع في كتابيه المذكورين ما يمكن وصفه بالمرتكزات القارَّة في النظر الموسع للخطاب؛ فقد تجاوز البحث في ترابط الآية الواحدة إلى الآيات، والسورة الواحدة إلى السُّور المتعددة، وهذا النَّظر يلتقي مع نظريات تحليل الخطاب المعاصرة.
وماذا بعد الفراغ من الكتابين قراءة وبحثًا؟
شرعت بالفعل في إنجاز قراءة الكتابين، وما إن تقدمتُ وكادت بعضُ المحاور أن تكتمل، حتى دلتني فروعُها على جذورها التي سبقت “السيوطي” وغذته، فكان ضروريا أن يأخذ البحث وجهة أخرى أكثر اتساعًا، وهنا تبدت لي منظومة العلوم التراثية التي دارت حول النص الكريم مترابطة الأجزاء منسجمة الغايات، وتكونت لي من البحث والتنقيب كلياتٌ بالغة الحداثة والدقة، أكبر مما انتهى إليه “السيوطي”، ما فرض عليّ التوسع في القراءة لأضع “السيوطي” في سياقه الأكبر، في إطار ما اصطلح على تسميته تراثيا بـ”علوم القرآن”، والذي يلتقي مع جهود المفسرين والبلاغيين التي تلتقي مع ما قَرَّرَته مقولاتُ علم النص واستراتيجيات تحليل الخطاب.
وهكذا وجدت نفسي، وأنا أبحث في “علوم القرآن”، أمضي باتجاه الكشف عن جوانب الإعجاز وتدقيقها موضوعيًا وتنمية الوعي بها معرفيًا، آخذا بعين الاعتبار ما سطره الباحثون في الإعجاز كـ”الرُّمَاني” و”الخَطَّابِي” و”عَبْد الْقَاهر”، وما انتهى إليه علماء الكلام وبعض المفسرين الذين انشغلوا بوجه خاصٍ ببحث التناسب والتماسك بين أجزاء النَّصِّ الكريم كـ”الإمام” برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي” في تفسيره الموسَّع “نظم الدُّرر في تناسب الآيات والسور”، دون أن نغفل الإشارات اللافتة التي توصَّل إليها الزمخشري في “الكشاف”، أوفخر الدين الرازي في “مفاتيح الغيب”، وهكذا وضعتنا نصوص “السيوطي” في أفقٍ معرفي بالغ الثراء، بالغ التركيب.
من خلال ما توصلت إليه هل ترى أن هناك ظلم وقع على السيوطي؟
ليس السيوطي تحديدًا، ولكن بدا لي إهمال هذا الحقل المعرفي من قبل النقاد تقصيرًا غير مبرر، فما يمتاز به هذا الحقل هو قدرته على تجاوز الأفق التراثي الضيق الذي اعتادت القراءة المعاصرة أن تتوقف إزاءه، حتى وقع في ظننا أنها قد استغنت به- أو كادت- عن سواه، والذي انحصر معرفيا Epistemology في مجموعة محددةٍ من المدونات، وزمنيًا فيما عُرِفَ بالعصر الذهبي للحضارة الإسلامية.
ولا خلافَ حول قيمة المقروء وأهميته، ولكننا نختلف قطعًا حول قدرته على استيعاب التـراث النقدي في كليته، ولعَلَّ هذا ما أومأ إليه التواتر القرائي لهذه المدونات من قِبَل المحدثين، الأمر الذي أضاع علينا مَوَارِدَ ثَرَّية، كان بمقدورها أن تمنحنا إمْكَانًا أوسع ومعرفة أوفر بتراثنا.
فقراءتي لعلوم القرآن، قراءة ناقد وباحث فيما أنجزه أسلافه، ما يمكنه أن يثري أدوات الناقد، كان من أهداف هذه القراءة أن تدل على هذه المدونات، وأن تشير إليها، وكان غريبًا أن يهتم ناقد بعلماء القرآن ومفسريه.
وأي منهج قرائي تراه الأنسب لمقاربة علوم القرآن؟
قدم النقاد المعاصرون نظرات منهجية مهمة وأنجزوا قراءات معتبرة للتراث، وكان بدهيا أن أبني فوق ما أنجزوه، ويمكن تلخيص هذه المنهاجية في ثلاث خطوات:
الأولى: ضرورة الوعي بالواقع التاريخي للنص المقروء، وهذا يعني أن علينا الإلمام بالسياقات المختلفة للنص، في تداخلها وتراكبها، وتوازيها وتعارضها، وتقابلها وتوافقها، ما صرَّحت به وما سكتت عنه، فلا تحجزنا رؤية السطح عن مباطنة العمق؛ وبذلك لا تغدو صفحة التُّراث ملساءَ المعطى، هزيلةَ الفحوى، بل متداخلة الأبعاد، متعددة الدلالات تعدد القرَّاء والناظرين.
الثانية: من الضروري أن تنشغل القراءة بأسئلتها وشرطها، تحفزها إجابات المقروء على منح تساؤلاتها مزيدًا من النمو، ومنح شرطها مزيدًا من الكثافة. وهذا لا يعني أنَّ العَلاقة بين القارئ والمقروء ذات طابع ثنائي؛ يقف فيها المقروء على مسافة من القارئ، ولكنَّها عَلاقة تتسم بِجَدلٍ فاعلٍ- أو هكذا يجب أن يكون- غَيْرِ منحاز، يذوبُ فيه الطرفان في وَحْدَةٍ تنتجُ طرفًا ثالثًا لا هو إلى الأول، ولا هو إلى الآخر، ولكنه محصلة هذا الذَّوْب لحاضر القارئ وحاضر النص في آن واحد.
وإذا كانت قراءة التراث تعني نظريا، خروجًا من الذات وانقسامًا عليها، كي تقارب موضوعًا هو إياها، أو أسهم في تشكيلها، فإنَّ هذا يعني ازدواج وعي القارئ، فهو” ذات وموضوع في آن، بحيث يتمكن هذا الوعي من تأمل نفسه، في علاقته بمعطيات التراث المقروء، وكيفية إدراكه لها وسيطرته عليها”.
ومن البدهيّ أن تكون الذات المشار إليها واعية بحاضرها المعيش، واعية بمنجزها في الوقت نفسه، وإلا فلا معنى للقراءة ولا فائدة منها، وبهذا وحده يغدو التراث فعلا ناجزًا نشطًا، قادرًا على التأثير، مسهمًا في وصل ماضينا بحاضرنا؛ “فتحقيق التراث لا يتمُّ بالتقوقع فيه والوقوف عنده”.
الثالثة: تجاوز فكرة الإدلاء بالتراث، فنزعم سبقه للنظر المعاصر في هذه المقولة أو تلك، فمثل هذا المسعى لا مبرر له ولا جدوى منه، خاصة ونحن نُقِرُّ: أننا نتقدمُ صوبَ التُّراث برؤى الحاضر ومنجزاته. وبهذا يمكننا أن نتجاوز سذاجة التأصيل إلى البحث فيما يصفه د. مصطفى ناصف بـ”حيوية الثقافة الإسلامية”، وهذه الحيوية معناها كشف العناصر التي تمكننا من مواجهة تيارات العصر بطريقة فكرية إيجابية أي أننا في الحقيقة نحاول باستمرار خلق ثقافة جديدة، فالعَلاقة بين القارئ والنص ليست علاقة تقابل وتضاد، وإنما النص جزء من وعي القارئ، وجزء من بنية تفكيره.
هل غياب نظرية نقدية عربية هو السبب في تراجعنا الثقافي مقارنة بالمشهد الإبداعي العالمي؟
ما الذي نقصده بهذا السؤال في ظل العولمة والعالم الذي غدا – حقيقة وليس مجازا – قرية صغيرة، الذين يطرحون هذا السؤال تزعجهم حالة التبعية للنقد الأورو أمريكي، وهذا بالفعل أمر مزعج، وما يزعج فيه هو هذه الطريقة الصماء في نقل المنهاجية الغربية، لقد استشعر المتلقي في النقد غربة، وبالتالي اضطر إلى الانصراف عنه، ومن المؤسف اليوم أن تجد نقاشا بين النقاد يتباهون فيه أن فلانا هو أول من نقل البنيوية، وأن فلانا أول من نقل النقد الثقافي….الخ، ما نحتاجه اليوم أكبر من ذلك، وما يستحق المباهاة حقا هو تقديم قراءات حقيقية لهذه النظريات.
وماذا عن إشكالية وقوع الناقد العربي في التبعية في ظل العولمة؟
اطلاع الناقد العربي على المنجز العالمي ضرورة لا مفر منها، لكن ما يجب أن نجادل فيه هو الكيفية التي نتلقى بها هذه المنهاجية، واعتراضي هو حول نقلها وزرعها في ثقافتنا دون أن نتحاور حولها. هذا ما فعله أسلافنا في تلقيهم للثقافة اليونانية والفارسية والهندية، وهذا ما تفعله كل ثقافة حية، فأنت تحاور الوافد بما لديك، وما لدينا هو تراثنا، وهذا كله لا يمكن إنجازه عبر قراءات استعادية صماء، وإنما عبر قراءات تحويلية، يقوى بها وجودنا عبر هذا الجدل الخصب، فهذا هو السبيل لتجاوز حالة النقل المعرفي إلى المشاركة في إنتاج المعرفة، وهذا هدف جدير بأن نسعى إليه.
وكيف يمكن لنا امتلاك لياقة معرفية لمقاربة صحيحة للتراث؟
امتلاك التراث لا يتم دون الوعي به، الوعي بخصائص إنتاجه ومضمامينه ومقاصده، بالإضافة إلى الوعي المنهجي، فمشكلتنا مع التراث إذن تتعلق بهذين الأمرين: الموضوع والمنهج.
هذا ما أشرت إليه أكثر من مرة، في قراءتي لمدونة “علوم القرآن” وفي قراءتي لغيرها من مدونات مثل كتاب المعاني الكبير لابن قتيبة، وشروح ابن جني، ومعاني الشعر للأشنانداني وديوان المعاني لأبي هلال العسكري. وهنا، وفي مرحلة تالية، بدا لي أن التراث لا يقتصر على فترة زمنية دون أخرى، وأخذت في البحث عن مفهوم التراث.
ما الذي نقصده بهذا المفهوم؟
من الباحثين من يرى أن التراث هو كل ما ورثناه تاريخيا، سواء من الماضي البعيد أو القريب، ومنهم من يحدده بزمن مُحدَّد يفصل بين ما يعتبر تراثًا وما لا يعتبر كذلك، كما اختلف الباحثون حول مقومات التراث، فمنهم من يقصره على الجانب الفكري، كالعقيدة والشريعة واللغة والأدب والفن والكلام والفلسفة والتصوف، ومنهم من يتوسع في المفهوم فيرى أن التراث يضم إضافة إلى ما سبق أبعادا اجتماعية كالتقاليد والعادات، وأخرى مادية كالعمران.
التراث إذن مفهوم إشكالي، يستوعب الموروث الثقافي والاجتماعيّ والماديّ، المكتوب والشفويّ، الرسميّ والشعبيّ، اللغويّ وغير اللغويّ، الذي وصل إلينا من الماضي البعيد والقريب. وهذا يعني أن التراث يتسع ليشمل كلَّ ما شكَّل وجداننا، وكوَّن مفهومنا للعالم من حولنا، وحدَّد وعينا به ونظرتنا إليه.
وهنا يلتقي تراث الجرجاني والزركشي والسيوطي والفخر الرازي مع تراث العقاد وطه حسين وأمين الخولي وعبد المنعم تليمة ومصطفى ناصف.. إلخ. كل هؤلاء شكلوا وعينا، وكل هؤلاء في حاجة إلى أن نقدم لهم قراءات “تحويلية” وليست استعادية، وفق المنهجية التي أشرت إليها، وهذا ما أحاول القيام به حاليا، وقد أنجزت جانبًا منه. وبالفعل قدمت قراءة في منجز عبد المنعم تليمة تحت عنوان “البحث في علمية الأدب”، وطه حسين في “المنهج…النص..الواقع..قراءة في حديث الأربعاء”، وأمين الخولي في ” البلاغة والتفسير والهوية الجمالية”، بعض هذه القراءات نشر وبعضها سينشر في دوريات علمية محكمة. ما أريد أن أخلص إليه أن الناقد العربي مطالب اليوم بالاطلاع على النظرية الغربية على نحو جاد وأمين، مع تقديم مقاربات مستمرة لتراثه، والوعي باشتراطات اللحظة الحالية وهي لحظة تاريخية إشكالية.
وكيف ترى المسافة بين النقد الانطباعي والنقد الأكاديمي؟
التقدم المعرفي يرتبط بشكل قوي بالمنهاجية، والنقد الانطباعي كان مرحلة سريعًا ما تجاوزتها المعرفة، ودعني أصارحك القول إن ثقافتنا تحتاج إلى الناقد الوسيط الذي يمكنه تبسيط النقد الأكاديمي إلى عموم القراء، خصوصًا بعد أن غدا فلاسفة اليوم نقادا، وغدا النقاد فلاسفة. هذا الدور الوسيط قد يضطلع به الناقد الأكاديمي نفسه، ويجب ألا يأنف نقادنا من مثل هذا الدور، وهذا ما قام به الرواد خير قيام، ولك أن تعرف أن أحاديث الأربعاء التي أملاها السيد العميد كانت مقالات توجه بها إلى عموم القراء في الصحف اليومية، ولاقت من النجاح والشهرة ما نالت. هذا الدور الاجتماعي أو لنقل المسئولية الاجتماعية واجب الوقت، خصوصا ونحن نعيش حالا من التراجع الحضاري، ويجب أن يتحمل الجميع مسئوليته تجاه ذلك.