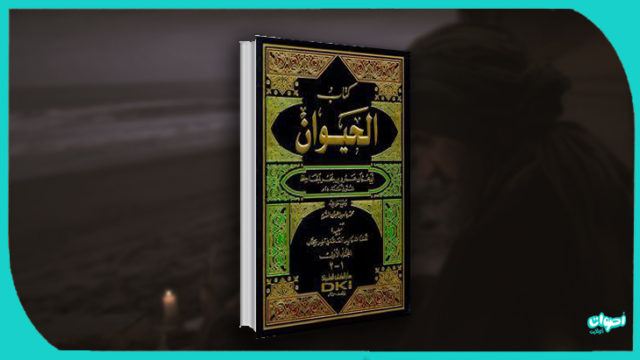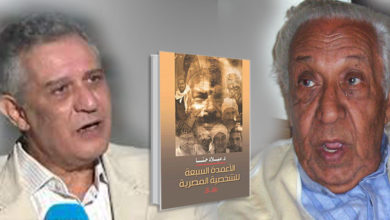كان انتقال الفكر المعتزلي من مرحلة علم الكلام إلى مرحلة الفلسفة، أمرًا مفروغا منه، لا سيما بعد بزوغ نجم شخصيات معتزلية، ذات ثقافة موسوعية شاملة، مؤثرة في حقل الثقافة الإسلامية، بالتزامن مع اهتمام نظام الحكم في الدولة الإسلامية بحركة الترجمة، والالتفات إلى أهمية علوم الأوائل، سواء من اليونانيين أو غيرهم من الأمم الشرقية ذات الحضارات القديمة، كالهند وفارس، وغيرهما من الحضارات والثقافات. ولذا كان طبيعيا أن نقرأ عن تلك الشخصيات المعتزلية التي أفادت من حركة الترجمة، وإن كانت في مهدها الأول، واحتكّت مباشرة بطائفة من أرباب النِّحَل والمِلَل غير المسلِمَة، واطّلعت على كتبهم، ودخلت معهم في مناظرات وجدل وعصف ذهني عقائدي، الأمر الذي ساهم في صبغ علم الكلام بالصبغة الفلسفية التي مهدت لظهور الفلسفة العربية الإسلامية بعد ذلك.
ويأتي إبراهيم بن سيّار النظّام البصري (الأرجح، بعدَ تحقيقٍ، أنه وُلِد عام 160هـ، وتوفي بين العامين 221هـ و 231هـ) على رأس أئمة المعتزلة الأولين الذين مثّلوا، مع أبي الهذيل العلاف، تحديدا، باكورة الانتقال بعلم الكلام من علم للدفاع عن العقيدة الإسلامية ضد المنتقدين والملحدين، إلى كونه علما يتضمن مباحث فلسفية، ووجودية وطبيعية، لم تكن معروفة عند المتقدمين من علماء الكلام. وكان النظّام أكثر عمقا وأصالة فلسفية من كل من سبقوه من أقرانه وأساتذته، لذلك صدَق مَن وصفه بأنه «يمثّل لحظة التوهُّج الكبرى في الفكر الاعتزالي جميعا» (عبد الجواد ياسين، السلطة في الإسلام، ص 109)، كما صدَق مَن وصفه كذلك بأنه يُعدُّ «من أهم الشخصيات في الثقافة الإسلامية» (نيبرج، الموسوعة الإسلامية، مادة «النظام»)،وكذا مَن وصفه بأنه كان «آية في النبوغ؛ حدّة ذهن، وصفاء قريحة، واستقلال في التفكير، وسَعة اطلاع» (أحمد أمين، ضحى الإسلام، 3/ 106).
اقرأ أيضا:
«العُقلاءُ الأوائل» (2): عمـرو بن عُبيْـد.. الفيلسوف المظلـوم via @aswatonline https://t.co/uvNNVZ2Dqu
— أصوات Aswat (@aswatonline) September 4, 2019
عقل جبّار
لم يأتِ وصفُ النظّام بتلك الصفات وغيرها من فراغ؛ فقد امتاز بعقل جبّار يعرف كيف يفكّر في علوم الكلام والفلسفة والطبيعة والأدب والشعر،وهي العلوم التي استقاها منه تلميذه أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (توفي 255هـ)، أكبر كُتاب العربية في كل العصور؛ لذلك عندما امتدحوا النظّام قالوا: «ومن عِظَم محلّه أن الجاحظ من غلمانه» (القاضي عبد الجبار، فضل الاعتزال، ص 265)، وقد اعترف الجاحظ بفضله اعترافا صريحا فقال: «لولا أصحاب النظّام لهلكت العوام من المعتزلة… إنه نهج لهم سبيلا، وفتق لهم أمورا، واختصر لهم أبوابا، أظهرت فيها المنفعة، وشملتهم بها النعمة» (الحيـوان، 4/ 206).

بيْدَ أنَّ النظام أصبح في زُمرة أهل الضلال والزيغ والانحراف، بل في زمرة الكافرين لدى أتباع أبي الحسن الأشعري (توفي 324هـ)، وأهل الحديث والنصيين بوجه عام، فعبد القاهر البغدادي يصفه بأنه كان يعاشر قوما من ملاحدة الفلاسفة، وأنه أدخَل في أبواب الفقه ضلالات لم يُسبق إليها، ويعارض حُجية الإجماع والقياس، وبلغ به الكُره مبلغا جعله ينفي عن النظّام أي جهد أدبي أو بلاغة شعرية، فيدّعي أنه ما لُقِّب بـ «النظّام» إلا لأنه كان ينظم الخرز ويبيعه في سوق البصرة، لا لأنه كان ينظم الشعر. أما الذهبي فمع اعترافه بشاعريته وبراعته الأدبية، فإنه يجزم بأنَّ جماعة من العلماء كفّرته.
وفي الوقت الذي يعترف فيه ابن حزم الظاهري بعلوّ طبقته في الكلام، وتمكّنه وتحكّمه في المعرفة، إلا أنه أتهم النظّام بأنه كان يعشق فتًى نصرانيا يعلّمه فضل التثليث على التوحيد (..)، وهذه افتراءات يعود مصدرها إلى ابن الراوندي، أحمد بن يحيى (توفي 294هـ)، المعتزلي المنشق، الذي ألحد قبل أن يُشنّع على المعتزلة بأكاذيبه التي كانت، كما يرى كثير من الباحثين والمدققين – أحد أهم مصادر النّصّيين في اتهام المعتزلة بالزيغ والكفر والإلحاد.

بين التفكير النقدي والتذوق البلاغي
جمَع النظّام بين الفكر اللاهوتي، والتفكير الفلسفي، والتذوق البلاغي والشعري والأدبي عموما، فضلا عن تحرره الفكري، وتمتعه بروح نقدية خلّاقة وجريئة، والاعتداد بالعقل وأحكامه، والعلم وتجاربه، وهذا هو سرّ عبقريته وخلود اسمه. وقد كانت تلك الروح الانتقادية التي تمتع بها قائدة ومرشِدة له، وهي الروح التي واجَه بها خرافات المجتمع، آنذاك وأساطيره وأوهامه الذاتية الموروثة، فانتقد عادات الناس وخرافاتهم، وإيمانهم بالتطيُّر (= التفاؤل والتشاؤم بحركة الطير يَمنَة أو يَسرَة)، والاعتقاد بوجود السعالي والغيلان، والأرواح الهائمة في الفيافي، منتهجا في ذلك كله ما يمكن أن نطلق عليه مبادئ علم النفس والاجتماع والتاريخ. وقد اتّهمه خصومه، تبعا لذلك، بأنه ينكر الجن، رغم ذِكرهم صراحة في القرآن، لكن ذلك غير صحيح؛ فهو لم ينكر وجود الجن، لكنه أنكر إمكانية أن يراهم الإنس، فطبيعة تكوين الجنّ لا تُمكِّن الإنسَ من رؤيتهم، لذلك قال المحسن التنوخي: «من بركة المعتزلة أنّ صبيانهم لا يخافون الجنّ»! (نشوار المحاضرة: 2/ 342).

وقد كانت الروح الانتقادية عند النظّام حاضرةً وهو بصدد البحث في علوم التفسير والحديث، وتقليب آراء الفقهاء والمحدّثين والمتكلمين، بل وهو بصدد النظر في أقوال الصحابة وآرائهم، وهذا ما حدا بابن قتيبة الدينوري إلى وصفه بأنه أكبر الطاعنين في الحديث، ومرويات الصحابة، كما هي الحال – مثلا – في انتقاده رواية عبد الله بن مسعود، عن انشقاق القمر للنبي صلى الله عليه وسلم ورؤيته إياه مشقوقا، فرأى حراء بين فلقتيْه،فقد شكك النظّام في تلك الواقعة ومعقوليتها، (ابن قتيبة، تأويل مختلف الحديث، ص 25).

وبنفس الأسلوب العقلي والنظرة النقدية واجَه المفسرين، وأناح عليهم باللائمة، قائلا: «لا تسترسلوا إلى كثير من المفسرين، وإن نصبوا أنفسهم للعامة، وأجابوا في كل مسألة، فإن كثيرا منهم يقول بغير رواية، وعلى غير أساس..»، وبالتأكيد كانت غايته من ذلك تحرير التفسير من أي تأويل بعيدٍ عن المعنى الذي تدلُّ عليه الألفاظ بحسب عادة العرب في تعبيرهم، أي تفسير القرآن باللفظ المتبادَر، لابالتأويل المتكلَّف البارد، فليس من المعقول، مثلا، تفسير (الجلود) في قوله تعالى: «وقالوا لجلودهم لِمَ شهدتم علينا» [فُصّلت: 21]، بأنها كناية عن الفروج، وهذا هو مراد النظّام من التفسير، وبذلك يتضح عدم دقة تعبير المفكر التركي فؤاد سزكين، حين ذكر في موسوعته الشهيرة (تاريخ التراث العربي، مجلد1، ص 68)، أنَّ النَّظَّام يطالب بشرح القرآن شرحا حرفيًّا، فشتان بين التفسير باللفظ العربي المتبادَر وقت نزول القرآن في زمانه بمكة والمدينة، وتأويله بما يتوافق مع لغة العرب آنذاك، وبين تفسيره تفسيرا حرفيا مغلقا، وقد كان أئمة المعتزلة، عموما، أبعد أئمة المسلمين عن التفسير الحرفي الجامد.

نظرية الكمون
وللنظّام في مجال دقيق الكلام، أو الطبيعيات والأحياء، آراءٌ طريفة تَدل على سَعة معارفه، ومدى إلمامه بكثير من المسائل والتفاصيل الفلسفية والطبيعية المختلفة، ومن أشهر آرائه في ذلك نظرية (الجوهر الفرد)، فقد رأى النظّام أنّ الجزء يتجزّأ إلى مالا نهاية له، فلا بعض إلا وله بعض، ولا نصف إلا وله نصف، وهو بهذا يختلف عن رأي أستاذه أبي الهذيل العلاف الذي ذهب إلى أن الجزء لا يتجزّأ ولا ينقسم إلى ما لا نهاية، أما النظّام فهو يرى أن الجسم ينقسم إلى عدد لا نهائي من الجواهر الفردية (= الذرات)، والنظريات الفيزيائية الحديثة تثبت صحة رؤية النظَّام؛ فالذرة تنقسم إلى بروتونات ونوترونات.. إلى ما لا نهاية.
ومن أهم آرائه الطريفة التي لم يُسبق إليها نظريته في (الكمون)، ومعناها باختصار أن الله خلق الأشياء كلها، من حيوان ونبات ومعادن، دفعة واحدة، وجعل بعضها كامنا في بعض، لتظهر بعد ذلك تدريجيا إلى الوجود، وهذا معناه أن ثمة تطورًا وارتقاءً في الموجودات، وعنه أخذ تلك النظرية إخوان الصفاء، ثم عنهم أخذ ابن خلدون. وتلك النظرية التي ابتدعها النظّام تُعدُّ إرهاصًا واضحًا لنظرية التطور وأصل الأنواع، التي توصَّل إليها عالم الأحياء الإنجليزي الشهير تشارلز دارون في العام 1859م(مع الاختلاف بالطبع بين ما توصل اليه النظّام وما قال به دارون فيما يخص أصل الإنسان )، وهو ما يدل على سَعة رؤيته ودقتها، وفي الوقت نفسه، قوة ملاحظته التجريبية. فالنار تكمن في العُود (النبات) كما تكمن في الحجر، ولكن ليس بنسبة ابتة أو طريقة واحدة، ويبدو أن تلك النظرية كانت ضرورية في ذلك الوقت – رغم طرافتها وغرابتها – لمواجهة الموجات الإلحادية المتتالية التي زخر بها عصر النظّام، فلم يكن مستساغا أن يواجهها النظام بشكل تقليدي كأغلب مفكري زمانه، فكان لزاما عليه أن يأتي بأقوال ونظريات لتثبيت عقيدة التوحيد، وفي الوقت نفسه تعتمد على العقل والمنطق والتجريب؛ لتكون أدخل في الإقناع والتصديق.
وبالإجمال، يمكن القول إن سبب عبقرية النظّام، ترجع إلى اعتماده على الشك والتجربة، وهما الركنان اللذان يمثلان خلاصة عبقريته وتفرّده بين زملائه من المعتزلة، وغيرهم من الفِرق الإسلامية الأخرى، فبالشك يُفتِّت الأوهام والمسلَّمات، ليبنيَ بعد ذلك يقينه الذاتي المعقول، وينقل تلميذه الجاحظ عنه قوله «الشاكُّ أقرب إليك من الجاحد» (الحيـوان: 6/ 16)، وبالتجربة العملية يتأكد من النتائج التي يتوصل إليها. وقد بلغ به الأمر أنه أجرى بنفسه بعض التجارب على الحيوانات المختلفة بما فيها الأسد والأفعى؛ لمعرفة تأثير الخمر عليها، لذلك استحق أن يكون فيلسوف المعتزلة دون منازع.