في العام 1928، دُعِي عميد الأدب العربي، الدكتور طه حسين، إلى مؤتمر المستشرقين في أكسفورد، فقدّم باللغة الفرنسية ورقتيْن بحثيتيْن؛ إحداهما بعنوان: «استخدام ضمير الغائب فى القرآن كإسم إشارة»، والأخرى كانت بعنوان: «المعتزلة وليبنتز».
https://www.facebook.com/Aswatonline/videos/511945746210888/?t=0
ومرّت عقود بعد ذلك لم يقرأ أحدٌ الورقة البحثية الثانية، بل لم يكن أحدٌ يعرف عنها شيئا؛ ذلك أنها فُقدَت تماما؛ إذ لم تُنشَر كما نُشرَت الورقة الأولى في باريس، بيْد أنَّ أحد أصدقاء الدكتور عبد الرشيد محمودى (ناقد وكاتب وباحث مصري) وجد نسخةً من تلك الورقة، فدفعها إليه، فترجمها الدكتور محمودي فى كتابه «من الشاطئ الآخر، كتابات طه حسين الفرنسية»، الذي نشره المجلس الأعلى للثقافة، العام 2008، فكان من حُسن حظّنا أننا قرأنا تلك الورقة التي -على وجازتها- تهمّ كثيرًا من الباحثين في مجال الفلسفة الإسلامية والفكر الإنساني عموما؛ ولا سيما أنها تعقد مقارنة – ربما كانت الأولى – بين المعتزلة، كإحدى أكبر فرق المتكلمين في الفكر الإسلامي، وبين الفيلسوف الألمانى الشهير، ليبنتز (1646 – 1716).
وربما توضح الفقرة الختامية التي كتبها الدكتور طه حسين لورقته البحثية السبب الرئيس وراء إهمال نشر تلك الورقة البحثية وهو أنها جاءت موجَزة تحتاج إلى تفصيل وتأصيل وتوثيق، حيث كتب: «هل من قبيل المصادفة البحتة وجود هذا التشابه، وأكاد أقول هذا التماثل الكامل بين المذهبين؟ أو أن المعتزلة أثروا على ليبنتز من خلال الفلسفة المدرسية؟ ذلك سؤال لا أسمح لنفسى بأن أجيب عنه، ويكفينى أننى طرحته».

اهتمام خاص
كان من الطبيعي أن يهتم طه حسين بفكر المعتزلة اهتماما خاصا، فقد كان ممن تأثروا بهذا الفكر العقلاني النقدي، ولا أدلّ على هذا الاهتمام من إرساله بعثة علميّة إلى اليمن للاطّلاع على الكنوز العلمية النفيسة من المخطوطات الموجودة في خزائن الكتب هناك، ولتصوير ما تختاره منها حتّى يتمّ حِفظُه في دار الكتب المصرية بالقاهرة، فقد ارتأت وزارة المعارف المصرية عام 1952م – وكان طه حسين وزيرها آنئذ – توجيهَ الاهتمام إلى تراث المعتزلة وأفكارهم الحقيقية كما كتبها شيوخهم وأئمتهم، بعد أن كان الدارسُون – حتى منتصف القرن العشرين – يستندون في أبحاثهم ودراساتهم حول أفكار المعتزلة وأصولهم وعُلمائهم على ما يقوله مُخالِفوهم وخُصومُهم من الأشاعرة والحنابلة. كان طه حسين هو الموجِّه للعلماء الذين ضمتهم هذه اللجنة، وكان حريصا على الإشراف بنفسه على ما حققوه من مخطوطات المعتزلة، لأنه فطِن إلى أهميتها علميا وتاريخيا، بعد أن أُهمل الفكر المعتزلي لقرون طويلة، وطُمرَت مخطوطاته تحت تراب الصراعيْن المذهبي والسياسي، ولولا حرص الزيديين وتبنّيهم علم الكلام المعتزلي (البصري خاصة) لنحو ثلاثة قرون، لاندثرَ تراث المعتزلة إلى الأبد!.
اقرأ أيضا:
طه حسين وشعارات الإسلام السياسي via @aswatonline https://t.co/TgT99dJQVz
— أصوات Aswat (@aswatonline) November 14, 2019
بين المعتزلة وليبنتز
اهتمّ المعتزلة بمسألة العدل الإلهي اهتماما بالغا، حتى إن أحد الأسماء التي أُطلِقت عليهم أو أطلقوها هم على أنفسهم اسم (أهل العدل والتوحيد)، ويتلخّص مفهوم العدل الإلهي لديهم في القول بأن الله لا يستطيع فعل الشر، لأن ذلك مما يتعارض مع عدله وحكمته، فإن الخير الذي يفعله لا بد وأن يكون «أصلح الممكن»، فالله يفعل ما هو الأصلح لعباده، ولا يمكن أن يفعل الشر لهم، ويتمثل المعتزلة الذات الإلهية خيرا مطلقا، ويقولون باللطف الإلهي أى أن الله يهدي الناس إلى ما فيه الخير لطفا بهم، وإلا لما كان الله خيّرًا كامل الخير ولا حكيمًا كامل الحكمة. أما القول بأن هناك خيرًا ممكنًا لم يُردِ اللهُ فعلَه فهو انتقاص من كمال الله.
ويرى المعتزلة أن هذا المذهب يستتبع بالضرورة القول بحرية الإنسان، فبدونها يكون عدل الله باطلا، وهو ما عارضه الأشاعرة، تنزيها لله تعالى عن الإلزام، بحسب اعتقادهم، وقد كانت هذه المسألة سببًا رئيسًا في أن يُناظِرَ أبو الحسن الأشعري أستاذَه أبا علي الجُبَّائي المعتزلي في قضية الإخوة الثلاثة: المؤمن البالغ، والكافر البالغ، والصبي. يقول طه حسين، وهو يختصر لنا حكاية الإخوة الثلاثة تلك: سأل الأشعرى أستاذه أبا على الجبائي المعتزلى: «ما تقول فى ثلاثة إخوة، أحدهم كان مؤمنا برًّا تقيا، والثانى كان كافرا فاسقا شقيا، والثالث كان صغيرا، فماتوا فكيف حالهم؟ فأجاب الأستاذ قائلا: أما الزاهد ففى الدرجات، أما الكافر ففى الدركات، وأما الصغير فمن أهل السلامة» [فقال الأشعرى: إن أراد الصغير أن يذهب إلى درجات الزاهد هل يؤذن له؟، فقال الجبائى: لا. لأنه يقال له: أخوك إنما وصل إلى هذه الدرجات بعطائه الكثير وليس لك تلك الطاعات. فقال الأشعرى: فإن قال ذلك التقصير ليس منى، فإنك ما أبقيتنى [ولا أقدرتنى على الطاعة]. فقال الجبائى: «يقول البارى جلَّ وعلا: كنت أعلم لو بقيت لعصيت وصرت مستحقا للعذاب الأليم فراعيت مصلحتك».
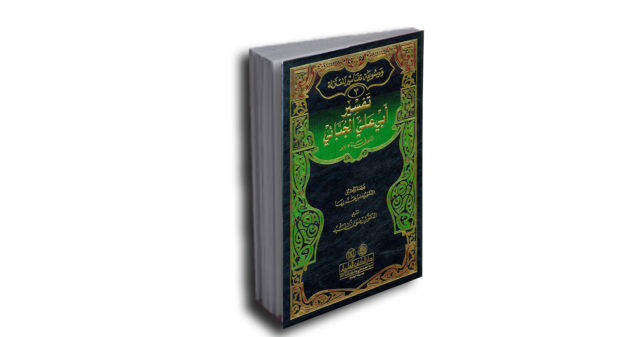
وفي نهاية القرن السابع عشر، كان الفيلسوف الألماني ليبنتز أول من استخدم مصطلح «ثيوديسيا»، بمعنى العدالة أو التبرير، وذلك في كتابه (محاولات في الثيوديسيا)، وهو المصطلح الذي عرّفه الفيلسوف الألماني «كانط» بقوله: «محاولات الدفاع عن حكمة الإله الصانع ضد التهم الموجَّهة إليه بمخالفة الغاية في العالم»، وقد اكتشف طه حسين بعد قراءة ليبنتز أن نظريته في الثيوديسيا تتشابه إلى حدّ كبير مع مبدأ «الصلاح والأصلح» المعتزلي، الذي كان إبراهيم النظّام (ت 231 هـ) أول من صاغه، لا لشيء سوى لتأكيد نظرية المعتزلة في العدل الإلهي، ومراعاة الأصلح للعباد في دينهم ودنياهم، وعاجلهم وآجِلهم، وهذا هو ما ذهب إليه ليبنتز عندما تناوَل مبدأ الأفضل الذي هو مماثل لمبدأ الأصلح لدى المعتزلة، مما دفع الدكتور طه حسين إلى كتابة ورقته البحثية الصغيرة، مقارنا بين ما ذهب إليه المعتزلة في القرن الثالث الهجري (التاسع الميلادي) وما ذهب إليه ليبنتز في نهايات القرن السابع عشر الميلادي، بل مقارنا بين ردّ الأشاعرة والحنابلة على المعتزلة، وردّ الفيلسوف الفرنسي (بيير بيل) على ليبنتز؛ يقول العميد: «لو أننا قرأنا مناقشات المسلمين أنصار وخصوم نظرية أصلح الممكن، لشعرنا على وجه اليقين أننا نقرأ الجدل الذى دار بين بيل وليبنتز، فهنالك نفس الطريقة التى تطرح بها المسألة لأن المعتزلة يثبتون مثلهم مثل ليبنتز وجوب أصلح الممكن عن طريق طيبة الله وحكمته وكماله، ونفس الطريقة فى مناهضتها لأن خصوم المعتزلة مثلهم مثل خصوم ليبنتز يحتجون من ناحية بوجود الشر، ومن ناحية أخرى بأن نظام أصلح الممكن من شأنه أن يحد من قدرة الله، ونفس المناقشات المنصبة على التفاصيل لأن خصوم المعتزلة مثلهم مثل خصوم ليبنتز يحتجون عليهم بمعاناة الحيوان والأبرياء، وبموت الأطفال فى سن مبكرة».

الفيلسوف الألماني ليبنتز
وربما لا يكون من قبيل المبالغة القول بأن الفكر المعتزلي كانت أصداؤه واسعة في نفس طه حسين، فلم يتأثر الرجل بفكر ديكارت أو فولتير، وغيرهما، فقط، بل كان أثر الفكر المعتزلي في نفسه كبيرا، وهو ما يفسر اهتمامه به، وحرصه على اكتشافه وتحقيقه ونشره، خصوصا مع تبنّيه الفكر العقلاني القائم على الشك والنقد، وهو الفكر نفسه الذي تبنّته مدرسة المعتزلة منذ نشأتها في بداية القرن الثاني الهجري.
الفيديو جراف
نص: Belal Momen
تحريك ومونتاج: Abdalah Mohamed













