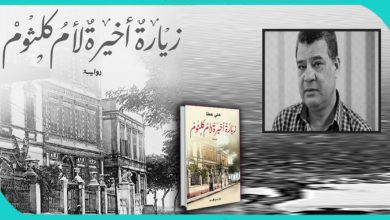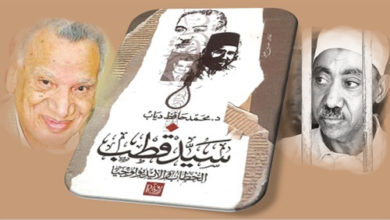«الأديب والناقد».. تلك الثنائية التي قد يرى فيها البعض نوعا ما من التعارض أو التباين. إذ أن العلاقة بين الناقد وبين الأديب، سواء كان شاعرًا، أم روائيًّا، تقوم في معظم الأحيان على الخوف، فالناقد مع أنه قد يستند إلى أسس علمية، وذائقة عميقة في فهم النصوص الأدبية إلّا أنّه عادة ما يخشى من ردة فعل الأديب على ما يكتبه عن نصه، إن سلبًا أو إيجابًا. في المقابل ينظر بعض الأدباء بنوع من الريبة إلى الناقد، الذي يرون أنه لا يستطيع سبر أغوار نصوصهم، لاسيما إذا ما تناول النواحي السلبية في النص، بما يقلل من قيمته الأدبية، أو يبعد الناس عن قراءته. لذا فإن هذه النرجسية الممزوجة بالخوف ربما تجعل الأديب يرى في الناقد عدوًا له.
في ضوء ذلك يبرز التساؤل عن امكانية الاحتفاء بالأديب والناقد سويا؟ وكيف يمكن ذلك؟، وهل يمكن التعامل مع رؤية الناقد لعدد من الأعمال الأدبية لأديب ما بوصفه نوعا من الإحتفاء بكليهما معا؟.. إذا كان الأمر ممكنا فتُرى من هو هذا الأديب؟ ومن هو ذاك الناقد؟
الأديب هنا هو صاحب نوبل عميد الرواية العربية نجيب محفوظ (11 ديسمبر 1911 – 30 أغسطس 2006) الذي لاتزال أعماله محل نقاش وجدل من قبل الأجيال المتعاقبة من النقاد. أما الناقد فهو الراحل إبراهيم فتحي (1930-2019) الذي غيبه الموت بداية شهر أكتوبر الماضي عن عمر ناهز 89 عاما، بعد رحلة طويلة قضاها في محراب الثقافة العربية والحياة السياسية منذ ستينيات القرن الماضي، والذي أشاد نجيب محفوظ ذاته بتناوله النقدي لأعماله الأدبية، خاصة كتابه «العالم الروائي عند نجيب محفوظ»، الذي أعتبره محفوظ أهم كتاب كُتب عن أعماله، هذا بالإضافة إلى كتابه «نجيب محفوظ بين القصة القصيرة والرواية الملحمية» و«نجيب محفوظ إبداع نصف قرن»، وغيرها من الكتابات التي تناولت عالم نجيب محفوظ الأدبي.
الحاضر والتاريخ عند نجيب محفوظ
في إطار اهتمامها بتكريم الناقد الراحل إبراهيم فتحي عقب رحيله، خصصت «دار المرايا» مساحة كبيرة من كتاب «مرايا 13» لكتاباته فعمدت إلى إعادة نشر عدد من أوراقه البحثية، وكان من بينها دراسته النقدية التي تناول فيها أدب نجيب محفوظ وجاءت تحت عنوان «الحاضر والتاريخ عند نجيب محفوظ».
يستهل إبراهيم فتحي دراسته تلك بالإشارة إلى أن العالم الروائي والقصصي عند نجيب محفوظ يتسم بالإكتشاف الفني للحظة التاريخية الحاضرة، ذلك أن روايته وقصصه «التاريخية» لم تقدم وقائع أو شخصيات الماضي لذاتها، لكنها أبدعت تجربة إنسانية متخيلة استمدت نسيجها من قضايا أساسية عاشها المصريون المعاصرون في زمن الكتابة، ومن ثم أصبح لأحداث الماضي وشخصياته دلالة راهنة.
كان محفوظ وفقا لإبراهيم فتحي قد أعد نفسه لكتابة تاريخ مصر في شكل روائي بالطريقة ذاتها التي كتب بها الكاتب المسرحي والشاعر الأسكتلندي «والتر سكوت» تاريخ بلاده، فظل يسرد الحاضر كتاريخ عبر رواياته: «عبث الأقدار» (1939)، و«رادوبيس» (1943) و«كفاح طيبة» (1944)، حيث كانت تلك الروايات جزءا من مشروع أكبر تخلى عنه محفوظ في النهاية لينتقل لمرحلة جديدة وصفها محفوظ بقوله: «حين بدأت الأفكار والإحساس بها يشغلني لم تعد البيئة ولا الأشخاص ولا الأحداث مطلوبة لذاتها، فالشخصية صارت أقرب إلى الرمز أو النموذج، والبيئة لم تعد تعرض بتفاصيلها بل صارت أشبه بالديكور والأحاديث مختصرة مجردة وأعتمدت الأحداث في إختيارها على بلورة الأفكار الرئيسية».
يتوقف فتحي عند الروايات الأولى لمحفوظ والتي شاع عنها انها تتسم بالواقعية مثل، القاهرة الجديدة (1945)، وخان الخليلي (1946)، وزقاق المدق (1947)، وبداية ونهاية (1949)، وصولا للثلاثية (1956-1957)، حبث رأى أن هذه الأعمال لم تكن فقط معنية بتصوير أساليب حياة فئات شعبية بعينها ووصف معاناتها وبؤسها أو الدفاع عنها بواسطة أفكار مجردة تتعلق بالعدالة الاجتماعية أو الوطنية، بل كانت أيضا معنية بتصوير الحاضر تصويرا ناشئا عن فهم القاسم المشترك بين الناس، حيث كانت هذه الأسس المشتركة راسخة عندما كان هناك تحالف بين الطبقة الوسطى وبقية الطبقات الشعبية في الحركة الوطنية.
أما رواية اللص والكلاب (1961) التي أستعار محفوظ قصتها عن حادث محمود أمين سالم الذي لقبه الإعلام بالشهيد، فقد أستقبل النقاد تلك الرواية برؤيتين متمايزتين .. فالناقد عبد القادر القط وصف «اللص والكلاب بأنها رواية فاشلة» حيث أخذ عليها أنها ركزت على حاضر البطل دون إكتمال صورته وربط ماضيه بحاضره، وهو ما جعله يرى في ذلك إفسادا للبناء الفني، في المقابل رأت الدكتورة فاطمة موسى في اللص والكلاب، قفزة ونقطة تحول في أعمال محفوظ، ومن ثم الإنتقال من محاولة نقل الحاضر بكل تفاصيله في أعماله السابقة عليها إلى إستعمال أرقى وأعقد الأدوات الفنية كالرمز والإستعارة، ذلك أنها رأت أن منطق الرواية عنده أهم من منطق الواقع الجزئي أو الكلي. وبناء عليه أعتبرت فاطمة موسى اللص والكلاب أعلى مستوى من الثلاثية لإستخدامها أدوات فنية أرقى وأعقد.
د. فاطمة موسى، والناقد عبد القادر القط
يتناول فتحي أفكار الطبقة الوسطى في ثلاثية محفوظ، مشيرا أنها لم تكن بأي حال تمثل أفكار طبقة واحدة، حيث تضمنت الثلاثية عناصر من أفكار ورؤى فئات مختلفة مثل الفلاحين من صغار الملاك وهم آباء سكان المدينة والحرفيين والتجار التقليدين، ومن ثم قدم محفوظ رؤية الطبقة الوسطى بوصفها رؤية الأمة بأكلمها في فترات المد الثوري أثناء ثورة 1919.
ثم يعود إبراهيم فتحي ليقف مطولا عند رواية «أمام العرش» (1983) التي حملت عنوانا فرعيا: «حوار مع حكام مصر» وتناول فيها محفوظ حكام مصر من مينا وصولا إلى أنور السادات، فيما يشبه المحاكمة التي يرأسها أوزيريس وإيزيس ويتوافد عليها الزعماء المصريون. وعلى الرغم من أن الرواية تقوم على فكرة المحاكمة إلا أنه لم يكن هناك أي حكم على أي من هؤلاء الحكام. لكن اللافت للنظر أن محفوظ حرص على جعل شخصية «آتوم» ممثل ثورة الفلاحين على الفراعنة وكبار الملاك خالداً بين الخالدين بما يعنيه ذلك من كونه ممثل للثورة الدائمة.
هنا يقف فتحي عند الحوار الذي دار بين شخصية جمال عبد الناصر والسادات في الرواية حيث يخاطب ناصر السادات قائلا: «كيف امتكلت الجرأة لتتخذ موقف عديم الإحترام لذكراي» ويجيب السادات: «لقد كنت مضطرا لان جوهر سياستي تأسس على تصحيح الأخطاء التي ورثتها من حكمك» فيرد ناصر: «لكنني عهدتك مؤيدا وصديقا» فيقول مصطفى النحاس للسادات: «لقد أدهشني أن أسمع دعوتك للديمقراطية ثم أكتشفت أنك أردت ديمقراطية من خلالها تستطيع ممارسة سلطاتك الديكتاتورية» فيرد السادات: «لقد أردت ديمقراطية تستطيع أن تحمي أخلاق القرية وحقوق كبير العائلة».
لم يكف محفوظ عن تأريخ الحاضر ففي «يوم قتل الزعيم» (1985) التي وصفها إبراهيم فتحي بكونها «صرخة لم يسمح محفوظ لنفسه بها من قبل» نجد محفوظ على لسان الجد يقول: «ما هذا القرار يا رجل؟ تعلن ثورة تصحيح في 15 مايو ثم تصفيها في 5 سبتمبر، وتزج بالمصريين جميعا في السجن، مسلمين وأقباط ورجال فكر، ولا يبقى حرا إلا الإنتهازيون .. فلك الرحمة يا مصر».
يجمل إبراهيم فتحي تناوله لأعمال نجيب محفوظ بالقول إن روايات محفوظ لم تكن حركة التاريخ فيها تعبيرا عن قوى خارجية مجردة توجه الأحداث من قصورها وقلاعها البعيدة، بل جرى استئناسها وتحويلها إلى تجارب شخصية، فرواية محفوظ كانت تشمل رؤية متكاملة تضم الذات والموضوع والماضي والحاضر ومن ثم تستشرف أفاق المستقبل، وعندما كانت تغيب أي من هذه الأدوات كان محفوظ يلجأ إلى القصة القصيرة التي أعتمد عليها خاصة في تلك الفترات التي أفتقد فيها وضوح الرؤية، مثلما حدث له في أعقاب هزيمة 1967، وهي الفروق التي تناولها إبراهيم فتحي في كتابه «نجيب محفوظ بين القصة القصيرة والرواية الملحمية».
ناقد الرصيف
«ناقد الرصيف» ذلك اللقب الذي حمله الراحل إبراهيم فتحي عبر رحلة حياته النقدية، تُرى من أين جاء هذا اللقب ومن أطلقه عليه؟ .. المدهش أن إبرهيم فتحي ذاته هو من أطلق على نفسه هذا اللقب، ولعل إلقاء الضوء سريعا على معالم رحلته في مجال النقد الأدبي ومشاركته الفعالة في الحياة الثقافية المصرية تجيب على سبب ذلك .
فقد إلتحق إبراهيم فتحي بكلية الطب ومن ثم إلتقى بالأديب يوسف إدريس والناقد الدكتور صلاح حافظ ونشطوا سويا فيما عرف «بمكتب الأدباء والفنانين» التابع لمنظمة «حدتو».. «الحركة الديمقراطية للتحرر الوطني»، وكانت بداية رحلته مع عالم الأدب كمترجم حيث ترجم رواية «الهزيمة» للكاتب الروسي «فادييف».
دخل إبراهيم فتحي المعتقل لإنتمائه السياسي لليسار سنة 1959، وعند خروجه بعد خمس سنوات بدأ رحلته في عالم النقد الأدبي، حيث دأب على الكتابة بمجلة «الشعر والثقافة» ومجلة «المجلة» مع يحيى حقي ومن ثم تم إعقتاله مرة أخرى في سبتمبر 1966.
عقب خروجه من المعتقل شارك في تأسيس «جمعية كتاب الغد» التي لعبت دورا بارزا في الحياة الثقافية في مصر مع نهاية الستينيات وبداية السبعينيات من القرن الماضي، كما ساهم في تأسيس مجلة «جاليري 68»، غير أن أبرز ما يذكرعنه أنه ساهم عبر كتابته النقدية في تقديم العديد من الأدباء المصريين كان من بينهم إبراهيم أصلان ويحيى الطاهر عبد الله ومحمد البساطي وبهاء طاهر وجمال الغيطاني.
أطلق إبراهيم فتحي على نفسه لقب «ناقد الرصيف» لحرصه على التبرؤء من الإنتماء لأي عمل مؤسسي، ومن ثم بات يعقد ندوته الأسبوعية بأتيلييه القاهرة في الثمانينيات والتسعينيات، لطرح ومناقشة كل جديد في عالم الأدب والفكر. وقد كرّمه المجلس الأعلى للثقافة عام 2018 عن مجمل أعمال النقدية.