في الجزء الأول من مقالنا توقفنا عند سجن المنفلوطي بسبب قصيدته التي هجا بها الخديوي عباس حلمي الثاني.
قام المنفلوطي وصديقه الصحفي الناشر أحمد فؤاد باستئناف الحكم، قبلت المحكمة الاستئناف فعدلت الحكم بالسجن لستة أشهر مع بقاء الغرامة كما هى، يدفع فؤاد ثلاثين جنيهًا ويدفع المنفلوطي عشرين جنيهًا.
وقبل مواصلة الرحلة مع المنفلوطي المفترى عليه، نتوقف قليلًا عنده صديقه الأديب والناشر أحمد فؤاد الذي أدرك من البداية أنه سيسجن ولو قدم ألف دليل على براءته فقرر فضح العائلة المالكة أمام المحكمة فقال وفق الكاتب سعد رضوان الذي أرخ لتلك القضية: «إن الرعية لم تسر حقا بقدوم الخديوي، وإن محبة الرعية الملكية أمر اختياري وما من ملك إلا وله من لا يسر بقدومه، والملك لا يستطيع إرغام رعيته على محبته، لأن الملك يملك أجسام الناس ولا يملك قلوبهم، وأنه ليس أول من جاهر وأعلن للناس مظالم الخديوي، فإن أحدًا لا ينسى قصة مدفع الوالي سعيد التي نشرتها صحف مصر فى وقتها، فقد استورد الجيش مدفعا جديدا من فرنسا، وطلب سعيد تجربته فى أحد الميادين العامة، ونقل المدفع إلى ميدان عام، وأمر بإطلاقه فاقترب منه أحد رجال الحاشية، وقال: هل يأمر أفندينا بأن نتمهل قليلا حتى يمر الناس؟.
فرد سعيد: ليس عندى وقت، أطلق النار فنحن لم نستلم الناس بالعدد!
وأكمل فؤاد كلامه قائلًا: إن الخديوي إسماعيل أراد جمع مبلغ من المال، فصنع شارات جوخ وزعها على أهالى طنطا مقابل خمسمائة جنيه للشارة.
وأضاف فؤاد: أن رجال إسماعيل حاصروا مرة بلدة بالوجه القبلي، هرب إليها أحد خصوم إسماعيل فأمر بضربها بالمدافع.

الخديوي إسماعيل
التشطير المريب
لم تمت القصيدة بسجن شاعرها وناشرها، بل حدث العكس، لقد زادها سجنهما انتشارًا، فرأت السلطات ـ وفق رأي جمهور المؤرخين ـ أن توجه للقصيدة ضربة قاضية.
أنقل عن الكاتبة رفيعة عبد الرازق محمد التي قصت قصة التشطير المريب: حتى تقضي السلطة على الضجة، كلفت الصحفي سليم سركيس الذي كان يصدر مجلة (المشير) بأن يبحث عن شاعر له القدرة على تحويل القصيدة المذكورة من هجاء إلى مدح، ولم يجد سليم سركيس أفضل من شاعر عراقي ضرير نزح من الموصل إلى مصر واسمه الشيخ عثمان الموصلي أو عثمان الضرير يقوم بالمهمة لمقدرته الأدبية والشعرية.
قام الموصلي بتشطير القصيدة بحيث أدى التشطير إلى قلب معنى القصيدة الأصلي ونشرت (المشير) التشطير ومنه:
(قدوم ولكن لا أقول سعيد)
على فاجر هجو الملوك يريد
لإضرابه بيت من اللؤم عامر
(وملك وإن طال المدى سيبيد)
(رمتنا بكم مقدونيا فأصابنا)
رخاء عن الجدب المبيد بعيد.
ما بين الأقواس هو من شعر المنفلوطي، والتشطير لا يكون إلا كما فعل الموصلي، شطر من المنفلوطي وشطر من عنده، وهذا أدى إلى صحوة القصيدة مرة ثانية لا موتها!
بعد سنوات سيزعم سركيس أن التشطير كان حيلة منه وليس بأمر من السلطات، لكي يضمن للقصيدة رواجًا لا يوقعه تحت طائلة القانون!

أيام البؤس
غادر المنفلوطي السجن، ليجد نفسه في الشارع حرفيًا، فلا وظيفة ولا مدخرات ولا جريدة تقبل أن يكتب لها، فهو عدو الحاكم، فمن يغامر بمساندته؟.
فيما بعد سيسرف المنفلوطي في سرد تفاصيل تلك الأيام البائسة، وقد بحثت أنا عن دعم عائلته له فلم أظفر بشيء.
هل نفضت العائلة العريقة يديها من ولدها بعد مغادرته للأزهر؟.
أم تلقوا أمرًا من الخديوي بترك ولدهم للأيام والليالي؟.
الإمام مرة ثانية
مر بنا أن الشيخ الإمام محمد عبده هو الذي أنقذ المنفلوطي أثناء دراسته في الأزهر وهو الذي رعى موهبته، والآن في أيام المحنة يظهر الإمام مجددًا لا لينقذ موهبة المنفلوطي فحسب، بل لينقذ حياته كلها.
سعى الإمام حتى حصل على عفو من الخديوي عن المنفلوطي، استرد بموجبه بعض حقوقه، ثم فتح له الإمام أبواب الصحف ثانية، فأمطرها المنفلوطي بمقالاته، وهى تلك المقالات التي سيجمعها فيما بعد في كتاب «النظرات» الشهير، ولم تكن المقالات لأكل العيش بل كانت لبناء وعي وتأسيس شخصية وإقرار منهج.
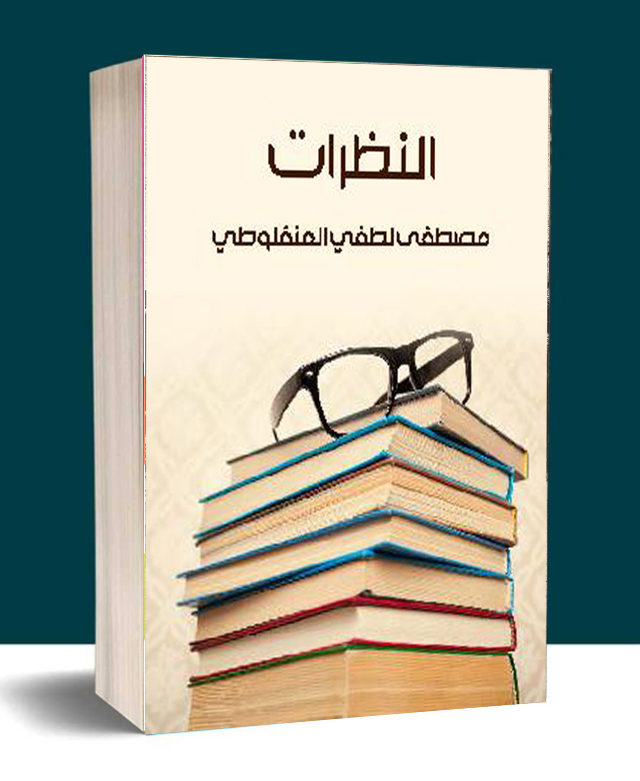
عن تلك المقالات يقول الأستاذ نجيب محفوظ: إن الجريدة التي كانت تظفر بمقال للمنفلوطي كانت تبيع النسخة بقرشين، وكان القرشان ثروة طائلة!
ومن أيادي الإمام البيضاء على المنفلوطي أنه قدمه لسعد باشا زغلول، وكان زغلول من أخلص تلاميذ الشيخ الإمام.
أحب زغلول المنفلوطي وعرف قدره فأخترع له وظيفة حكومية تقيه شر الأيام
كان سعد باشا يتولى نظارة المعارف (وزارة التربية والتعليم حاليًا) فجاء بالمنفلوطي ليتولى وظيفة «المحرر العربي» للوزارة.

سعد زغلول
وكانت مهام الوظيفة هى ترقية الأساليب داخل دواوين الوزارة فى قراراتها ومكاتباتها خاصة فى المسائل الكبرى التى تكتب من أجلها المذكرات المطولة والقرارات المسهبة.
لم يجد المنفلوطي مشقة في وظيفته، فهو وُلد ليكتب، ووظيفته هى الكتابة التي لا يعرف غيرها، تواصلت أيام الراحة حتى طرق بابه في العام 1905 خبر رحيل شيخه الإمام محمد عبده.

الشيخ الإمام محمد عبده
هنا ضاق السيد مصطفى بكل شيء، فقد خسر المساعد والمعين، فقرر تحت وطأة أحزانه على شيخه العودة إلى منفلوط!
مكث الرجل في مسقط رأسه عامين كاملين، معتزلًا كل نشاط عام، ثم ـ شأن كل أصحاب الرسالات ـ تخلص من عزلته وأحزانه وعاد إلى القاهرة ليواصل مقالاته ومعاركه مع المحتل وأعوانه من حكام القصر.
جناية المازني
في العام 1921 نشر الأستاذان محمود عباس العقاد وإبراهيم عبد القادر المازني كتبهما الشهير «الديوان» كانا أيامها من الناشئين في عالم الأدب والثقافة، وكان المنفلوطي الذي سبقهما في الميلاد باثنتي عشرة سنة كاملة يعد من أكابر الأدباء.
لا أعرف هل هو طيش الشباب أم حب الشهرة الذي جعل الشاب المازني يهجم على المنفلوطي هجمة ستكون دليل الاتهام الأول ضده، بل أكاد أقول الأوحد.
كتب المازني عن المنفلوطي فقال: «ماذا في كتابات المنفلوطي مما يستحق أن يعد من أجله كاتباً أو أديباً إلا إذا كان الأدب كله عبثاً في عبث لا طائل تحته؟ سمعت بعض السخفاء من شيوخنا المائتين يقول إن في أسلوبه حلاوة. ولو أنه قال نعومة لكان أقرب إلى الصواب، ولو قال أنوثة لأصاب المحز».

بربك هل هذا نقد أم هو النقض والنسف؟.
الشاب المازني سمع لا شك برأي الأساتذة في المنفلوطي ولكنه تجاهل كل كلام يصب في صالح الرجل.
قال أحمد حسن الزيات عن المنفلوطي: «لقد عالج الأقصوصة أول الناس وبلغ في إجادتها شأواً ما كان ينتظر ممن نشأ كنشأته في جيل كجيله، وسر الذيوع في أدبه أنه ظهر على فترة من الأدب اللباب، وفاجأ الناس بهذا القصص الرائع الذي يصف الألم ويمثل العيوب في أسلوب رفيع وبيان عذب وسياق مطّرد ولفظ مختار».
وقال حافظ إبراهيم: «المنفلوطي حسن الديباجة، منسجم الكلام، رقيق المعنى».
وعنه قال وليّ الدين يكن: «السيد مصطفى لطفي المنفلوطي رجل من كبار كتّاب القلم في زماننا، فهو من كتّاب الطبقة الأولى،
و شعر المنفلوطي كالعقود الذهبية، إلا أن حبات اللؤلؤ فيها قليلة، فهو يخلب بروائعهِ أكثر مما يخلب ببدائعهِ».
كأن الأستاذ المازني لم يجد في الورد عيبًا فراح ينتقد اعتزاز المنفلوطي بنسبه فقال يخاطبه: «وما للقراء ولأجدادك الذين لم تزدنا بهم علماً فيشفع لك ما أفدت في سماجة ما كتبت، ولقد قرأنا لجيته شاعر الألمان الضخم كتاباً في تاريح حياته يقع في أكثر من ستمئة صفحة، ولا نذكر أنه أورد اسم أبيه حتى ولا في سياقة الحديث».
عجيب هذا النقد، هل جوته منزل من السماء، فإذا لم يذكر أباه، يصبح فرضُا على كل أديب أن يسكت عن والده؟.
ثم صنو المازني أعني الدكتور طه حسين نسب المتنبي العظيم إلى الفاحشة لأن المتنبي لم يفتخر بوالده في شعره.
فهل المقدر لنسبه المعتز به على خطأ وغير المقدر على خطأ أيضًا؟.
ثم يجعل الأستاذ المازني من نفسه آلة حاسبة فيقول في نقده لكتاب المنفلوطي الشهير «العبارات»: «كل لفظة يمكن الاستغناء عنها قاتلة للكاتب، فإن العالم أغنى في باب الأدب من أن يحتمل هذا الحشو … وقد عددنا إلى الآن 572 مفعولاً مطلقاً ولا ندري إلى أي رقم يرتفع العدد إذا استقصينا».

نقد المازني للمنفلوطي يشبه الخروب، طن من الخشب ودرهم من الحلاوة، ولكن المزعج أن كثيرين المعاصرين لم يقرأ الواحد منهم مقالًا واحدًا للمنفلوطي، يردد نقد المازني كأنه وحي إلهي!
عاب المازني على المنفلوطي ما فعله بالروايات الغربية ونسب ذلك إلى محبة المنفلوطي للشهرة!
والحق أن المنفلوطي كان يعيش بين الجيل الذي لا يعرف كتابة الرواية وفق القالب الغربي، والرجل لم يصف نفسه يومًا بالمترجم، هو كان ينتقي الروايات التي يشهد لها عارفو اللغات الغربية ويدفع بها إلى مترجم متخصص، وبعد الترجمة يعيد هو صياغتها وفق البيان العربي الناصع، وطبعًا كان ينسب العمل إلى صاحبه، فأي محبة للشهر تتكلف كل هذا العناء؟.
لقد ساعد تعريب المنفلوطي للروايات على ذيوعها وقد قال الأستاذ محفوظ إنه في صباه قد قرأ رواية من الروايات التي عربها المنفلوطي عشرين مرة!
وقد تأسس على نقد المازني لصاحب العبرات والنظرات اتهام جديد بأنه رجل حزين يعمل على استجداء الدموع من عيون القراء.
نعم المنفلوطي كان حزينًا ولكنه لم يكن كئيبًا، الرجل دفن بيديه أربعة من أولاده الذكور، فكيف كان سيأتيه الفرح؟
ثم هناك ما عناه من قسوة السجن، ثم البطالة بعد السجن، ثم التضييق عليه، ثم الغربة عن أهله وعائلته، الذي عاش حياة كحياة المنفلوطي يصبح من حقه أن يحزن وأن يعبر عن أحزانه.
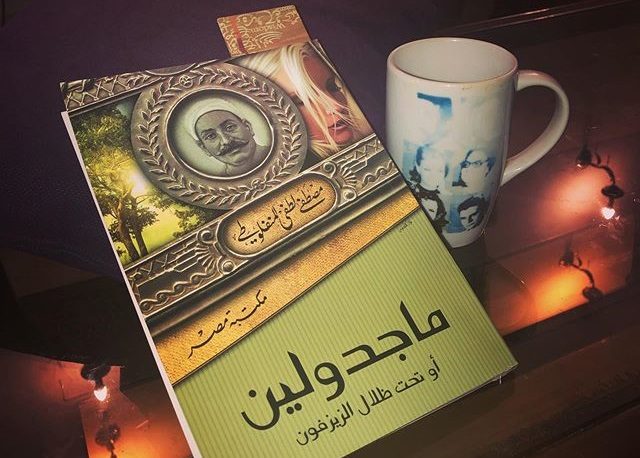
مفارقة الرحيل
وفق الحسابات البشرية كان يجب أن يعمر المنفلوطي طويلًا، ولكن: «وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ».
كان المنفلوطي يملأ الدنيا ويشغل الناس وكان في الرابعة والأربعين من عمره، وهى سن اكتمال الفتوة ولياقة الكتابة، وكان لصاحبه القديم سعد باشا زغلول مكانة عند الشعب لا تضاهيها مكانة، وفي يوم الخميس 12 يونيو تعرض الباشا لمحاولة اغتيال هزت الشارع هزًا، في ذلك اليوم رحل المنفلوطي!
كانت الأبصار كلها متجهة صوب بيت الزعيم، فلم يعرف أحد برحيل المنفلوطي الذي شيع إلى مثواه في جنازة فقيرة لا تليق لا باسمه ولا بمكانته، وما كان أحكم أمير الشعراء شوقي عندما رثا المنفلوطي قائلًا:
اخترت يوم الهول يوم وداع
ونعاك في عصف الرياح الناعي
هتف النعاة ضحى فأوصد دونهم
جرح الرئيس منافذ الأسماع
من مات في فزع القيامة لم يجد
قدما تشيع أو حفاوة ساع.









