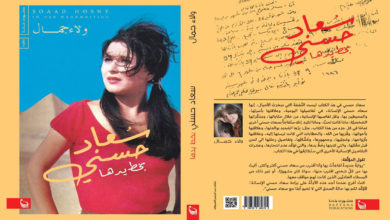يمكن لك أن تقدم المتعة، لكن أن تدمغها بالوعي والرؤية، أن تجعلها قلقة وحائرة، كي تتناثر الأفكار، ويبدأ عقلك يعمل، بل وتريد أن تعيد تلك المتعة مرة أخرى، وكلما لجأت أو شاهدت تلك المتعة، عاد لك هذا القلق، حتى تعي ما يدور حولك، وتفهم كما لا يفهم أحد، فأنت بالتأكيد أمام أحد أعمال لينين الرملي، ذلك العظيم الذي رحل منذ أيام قليلة مغادرًا معبده ومحرابه، أقصد خشبة المسرح. لكننا تذكرناه مؤخرًا فتوجناه بجائزة النيل، بعد أن توجناه داخل قلوبنا.
رغم أن بداياته كانت بعد تخرجه من معهد الفنون المسرحية عام 1970، إلا أنك تشعر بأنه أحد عظماء وهج المسرح المصري، وامتداد لطابور العظماء: سعد الدين وهبة، ونعمان عاشور، ويوسف ادريس، ومحمود دياب، وميخائيل رومان، ونجيب سرور، ولطفي الخولي وغيرهم ممن أثروا تاريخنا ووجداننا المسرحي.
فلينين الرملي لم يفقد إيمانه بالمسرح، وخشبته، رغم ما تعرض له المسرح المصري من خفوت منذ نهاية السبعينيات، وبعد أن داهم العقل المصري تجريف في وعيه وهبوط أفكار على سطحه قادمة في حقائب كل المغتربين الذين عملوا في الخارج من أجل لقمة العيش.
وبين هذه الأفكار الجديدة ولقمة العيش كان الإنسان الذي اهتم به لينين الرملي في جميع أعماله، فهو لم يقدم الجديد، بل قدم المغاير، قدم وجهه نظر جديدة لموضوع قديم، استطاع أن يشق الصف ويقف به متفردًا، رغم أنه كان يمكن أن يخفت مثلا ذات يوم بسبب اسمه الغريب أو غير المستثاغ على أذن فؤاد المهندس الذي رفضه بسببه، أو صلاح جاهين الذي استغرب أن يكتب هذا الاسم على المسرح.
لكن عناد لينين الرملي، هو ما جعل اسمه ينقش في حياتنا بقوة، تاركًا لنا أيضا كثير من الحيرة ما بين هل هو مسيحي أم مسلم،؟ هذه الحيرة هي التي تنتقل لنا عندما نشاهد تلك الأعمال، فمثلا مسرحيته «أهلا يا بكوات» التي توهجت لسنوات على خشبة المسرح القومي، قامت على سؤال بسيط عندما داهم الرعب رجلا بسبب التقدم العلمي، بينما هم جالسون يثرثرون، فيذهب إلى صديقه ليسأله ماذا فعلنا لنواجه المستقبل؟، لنبدأ في الانفجار في الضحك، وكيف لنا أن نظل جالسن ومتأخرين عن عصرنا، بينما العالم والعصر يسيران بسرعة جبارة.
هذه هي التنويعات التي كانت يتقافز عليها ليطرحها في مسرحياته، وهي المرادف للشيء الواحد، أي الرؤية المغايرة للأشياء، ووجهه النظر الجديدة، فمثلا في «أهلاً يا بكوات» كان الصراع بين الماضي والحاضر، أو بين القديم والحديث الذي لا نعرفه أو غير مستعدين له، بينما في مسرحية «وداعاً يا بكوات» كان الصراع بين الحاضر والمستقبل. وهذه مفارقة واحدة، لكن تركيبة مختلفة.
فهو بنفس الأسئلة البسيطة يطرح أفكاره، جاذبًا خيط الوعي والبهجة داخل جماجمنا الضيقة، ليجعلنا نرى بعيون «عرفة الشواف»، هذا الكفيف المتبصر، وهل العمي هو عمي النظر أم عمي شيء آخر، وهنا ينبع وينفجر الضحك أكثر، فنحن جميعنا في هذا الملجأ الذي به عرفة الشواف ورفاقه، لكن عندما نهدأ ونبدأ نفكر ليصبح «وجهه نظر» ليس للمسرحية فقط ولكن لحياتنا ايضا.
منذ البداية كان هدف جميع أعمال لينين الرملي الإنسان المصري البسيط وما حدث له من تحولات أو من مشكلات عظمي هو لا يعي ماهيتها، نراه في مسرحية بسيطة اسمها «الشيء» عن هؤلاء الذين يبدأون يخشون أو يتعاطفون مع هذا الشيء، وبالتالي ينقسم الناس بين مؤيد ومعرض، ويبدأون في الحديث، لكن لم يفكر أحد ما هو هذا الشيء.
هذا التناقض وعدم معرفة الأشياء وفهم مكنونها هو ما نجده في رفضه لثورة يوليو مثلا ويخبرنا إنها إنقلاب، كما أنه رفض ثورة يناير ليس كثورة ولكن وقعها على الإنسان البسيط الذي يبحث عنه لينين، وهل الإنسان المصري مستعد لها، ولتغيراتها، وبالتالي وصلنا إلى ما نحن فيه.
أتذكر له موقف شهير كان يحزنه دائما عندما التقيت به في منزله منذ عدة سنوات، كان حينها قد تم القبض على أب لسرقته قطعة شيكولاته طلبها ابنه ولم يكن معه نقود، كاد يبكي لينين الرملي، هو يعلم أن العدو الأكبر للإنسان المصري هو الجوع، وليست الحرية تلك التي طرحها بسخرية حادة في كثير من الأعمال كمسرحيته الشهيرة «الحادثة»، وهل هذه الشعوب لديها الحق في تلك الحرية؟، أم يجب أن تظل محبوسه، وقد ظل مشهد ترك الباب مفتوحًا للبطلة للهروب ولكنها لم تهرب من أقوي المشاهد المؤثرة في عقلي، كذلك نجده يطرح المغاير في مسرحيته الشهيرة لفؤاد المهندس والذي طلب منه مسرحية بعد عدة سنوات، فجاءت مسرحية «سك على بناتك» والتي تنتهي بجملة عبقرية تزيدنا من فهم ما يريده لينين الرملي عندما يقول المهندس: «نسك على بناتنا بس نديهم المفتاح».
https://youtu.be/sbZLE31tSIw?t=197
في الهمجي كانت السخرية شديدة وكأنه يتنبأ بتحولنا إلى الآلات، وأن الإنسان في سبيله ليس لفقده هويته بل فقده إنسانيته أيضًا، ويخبرنا بأن كل التطور والمدنية التي أصابتنا زادت من همجيتنا، همجية الحروب، وهمجية الأمراض التي اخترعناها والأسلحة الفتاكة التي نتبارز في تطوريها، وهمجية الإنسان ضد أخيه الإنسان. مؤكدًا في الختام أنه يجب ان يعود الإنسان لعفويته وطيبته ومشاعره وحبه للآخر.
هذا هو لينين الرملي، الواعي والمدرك والفاهم إشكاليات الإنسان المصري، ومدرك أكثر لما يعانيه، وبالتالي يخشى عليه من الأحداث الكبري التي تحدث حوله، لأنه يعلم أنه غير مستعد لها سواء ثورة أو حرب، لأن حرب الإنسان الكبري مع لقمة العيش.
إن الإيمان الذي كان يسير به لينين الرملي، وموهبته العظيمة، ووجهه نظره المغايرة لكل ما كنا نعرفه، هو ما جعلنا شديد الحزن عندما سمعنا خبر رحيله. هذا الرجل الذي ندين له – جميعنا – بابتسامة حقيقة على وجوهنا المصرية العابثة من كثرة الجري وراء لقمة العيش.
لأكثر من خمسون عامًا ظل لينين الرملي يثري حياتنا بكثير من الإبداعات، فله أكثر من 55 مسرحية، فمنذ ميلاده في عام 1945 ونشأته في بيت كان أساسه الجدل والنقاشات إلى أن رحل في 2020. هذه النقاشات التي تثمر الرؤية والوعي، فجعلته صاحب رؤية ساخرة وحادة، ويعلم قوة تلك السخرية في الفكر الإنساني، في الانتقاد والهجاء والتعبير، فجاءت أعماله مغلفه بحسه الكوميدي المرير، رؤيته للعالم وتغيرات الأحوال حوله، وما يحدث من الحكام أو السلطة ونظرة الإنسان البسيط لهما، فهو لن يجد أمامه ضد أي قهر، إلا السخرية، حتى لو كانت السخرية من نفسه لأنه هو من تسبب في هذا.
إن سلاح السخرية ليس سهلا إشهاره، وليس سهلا أن يمسكه أحد، وقله قليلة من امتلك مقبضه، وقلة قليلة جدا من استطاع أن يطلق منه رصاصات حقيقة، ومنهم «لينين الرملي» رحمه الله
لقد سخر لينين الرملي من كل شيء، السياسيين، ورجال الأعمال، والرأسمالية، وسخر من جشع التجار، من الأفكار الراكدة، من التطور الذي داهمنا، من عدم فهمنا لما يحدث حولنا، هذا التناقض هو ما جعل لينين الرملي ومسرحياته هي وردة البهجة في حياتنا خلال السنوات الماضية. وها نحن نرد له السخرية بسخرية أخري، لنهديه – جائزة النيل- وقلادتها، كي يضحك ويبتسم في مقبرته، عليه رحمه الله،