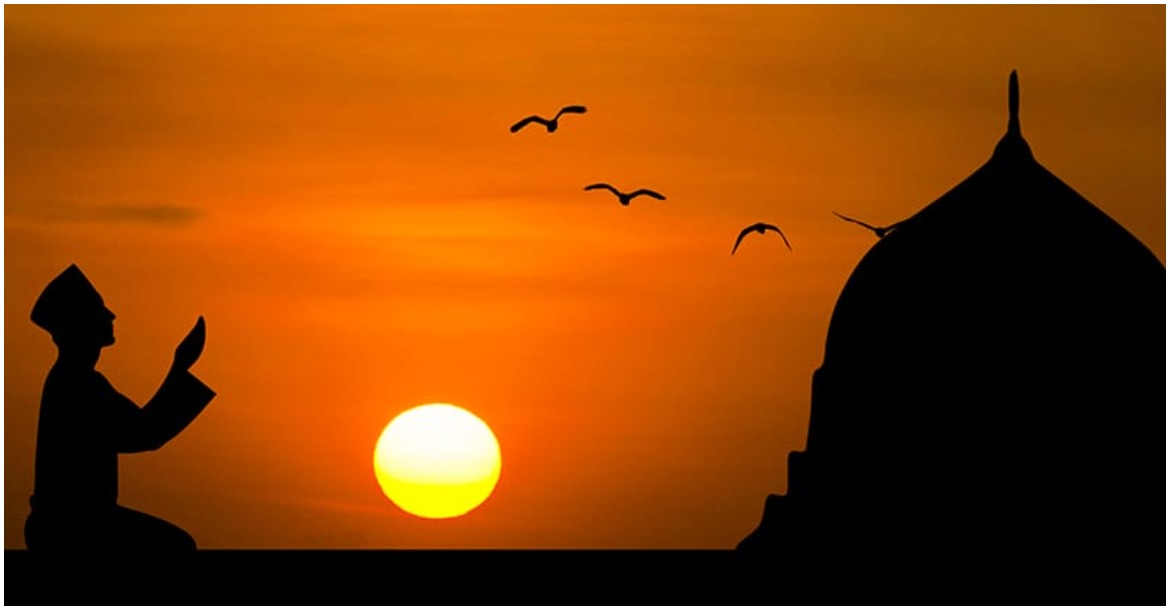في إطار الحديث المتواصل الذي نحاول من خلاله بناء “مفهوم إسلامي” للتنمية، وفي سياق ما وصلنا إليه من إنَّها “عملية” تبدأ من الواقع الراهن إلى المستقبل (ذلك الغائب من الزمن القادم بعد حين)، لتحقيق هدف محدد يتمحور حول تقدم المجتمع.. يمكن الإشارة إلى أنَّ التنمية في الإسلام، إنَّما تعتمد على بعدين أساسيين:
البعد الأول، وهو البعد الاجتماعي؛ أي ذلك البعد المتمثل في التصور الإسلامي للمسألة الاجتماعية، وهي المسألة التي تتقاطع عندها دوائر ثلاث، الإنسان والمجتمع، العمل والإنفاق، الحلال والحرام.
البعد الثاني, وهو البعد الاقتصادي؛ أي ذلك البعد المتمثل في التصور الإسلامي للمشكلة الاقتصادية، وهي المشكلة التي تتقاطع عندها –أيضًا– دوائر ثلاث: الموارد والإنتاج، الحاجة والإشباع, التوزيع والتوازن.
ومن المنطقي, والحال هذه, أن نبدأ بـ”محاولة معرفة” التصور الإسلامي للمسألة الاجتماعية, أو بالأحرى “البعد الاجتماعي للتنمية”.
يقوم “البعد الاجتماعي”، للتنمية في الإسلام, على أساس إرساء الدوائر الثلاث للمسألة الاجتماعية على ثلاث قواعد, تنبع من نظرة الإسلام العامة إلى الإنسان والمجتمع والكون. هذه القواعد الثلاث, هي: قاعدة تعمير الأرض, وقاعدة قيمة العمل, وقاعدة الثواب والعقاب.
تعمير الأرض
أما عن القاعدة الأولى, قاعدة تعمير الأرض, فهي القاعدة التي يرتكز عليها الهدف من التنمية, وما إذا كان الهدف يقتصر على مجرد تحقيق إشباع الحاجات المادية للإنسان والمجتمع, أم أنَّ ذلك مرحلة لهدف أسمى وهو تعمير الأرض. يشير إلى ذلك، ويؤكده، أن لفظ “العمارة”، (أو: التعمير)، يحمل في حقيقته مضمون التنمية والهدف منها, وذلك كما في قوله تعالى: “وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنْ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ” [هود: 61]. في هذه الآية الكريمة، طلب للعمارة في قوله تعالى: “وَاسْتَعْمَرَكُمْ”؛ وهو طلب مطلق من الله عز وجل, ومن ثم يكون على سبيل “الوجوب”.
بيد أن الملاحظة التي نود أن نشير إليها, في هذا المجال, أنَّ لفظ “العمارة”, أشمل وأعم من لفظ “التنمية”, من حيث إنَّ “العمارة” تشمل “التنمية”، ببعديها الاجتماعي والاقتصادي. فـ”عمارة الأرض”، (أو تعمير الأرض)، تعني نهوض مختلف مجالات الحياة الإنسانية؛ ولهذا فإن لفظ “التنمية الاقتصادية” ـالسائد في الحديث عن التنميةـ إذا أخذناه بمعناه الحرفي، يكون قاصرًا، لأنَّ التنمية لا تتحقق إلا في مجتمع. ومن ثم، تكون موارد المجتمع, مادية وبشرية، وغايات هذا المجتمع ومستوى ثقافة أفراده ودرجة “ولائهم”، عناصر هامة في تحديد مدى نجاح عملية “التنمية”، الاقتصادية, التي هي اجتماعية في الوقت نفسه.
ملاحظه أخرى, نود أن نشير إليها في هذا المجال, أيضًا, وهي إنَّ تعمير الأرض, كقاعدة اجتماعية ينبني عليها الهدف من عملية التنمية, لا يمكن فصلها عن مضمون استخلاف الله سبحانه وتعالى للإنسان، وجعله خليفة في الأرض، وذلك كما قوله سبحانه: “وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ” [البقرة: 30]. وبناء على ذلك، فإنَّ التنمية كعملية هدفها تعمير الأرض إنَّما تلتقي مع القصد من أنَّ الله عز وجل قد سخَّر لهذا الخليفة (الإنسان)، ما في السموات والأرض ليستفيد منها وينعم بخيراتها ويسبح بحمده, كما في قوله تعالى: “وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ” [الجاثية: 13]. ومن ثم, يتمكن “الإنسان/الخليفة”، وعن طريق هذا التسخير, من تحقيق القصد من الاستخلاف وأداء مهمته في تعمير الأرض.
وترتيبًا على ذلك, تعتبر التنمية عملية واجبة إسلاميًا على الفرد والدولة والمجتمع. وفي هذا يقول الله تعالى: “هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ” [الملك: 15].. ويقول سبحانه: “فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ” [الجمعة: 10]. في هذه الآيات يأمرنا الله عز وجل بالمشي في مناكب الأرض، والانتشار فيها, والابتغاء من فضل الله, ومعنى هذا هو ممارسة مختلف العمليات الإنتاجية, والخدمية.. أي ممارسة “التنمية”، كعملية تستهدف “تعمير الأرض”.
قيمة العمل
وأما القاعدة الثانية، قاعدة قيمة العمل, فهي القاعدة التي تتكامل مع قاعدة “تعمير الأرض”. فإذا كان الإسلام قد اعتبر أنَّ تعمير الأرض, كهدف لعملية التنمية التي يقوم بها الإنسان، هو أساس خلقه ووجوده, بل ومناط تكليفه, فإنَّ هذا لا يعني سوى أنَّ الله لم يخلق الإنسان في هذه الدنيا عبثًا, أو لمجرد أن يأكل ويشرب, وإنَّما خلقه لرسالة يؤديها, كـ”خليفة”، وهي أن: يدرس ويعمل, وينتج ويعمر, عابدًا الله شاكرًا فضله، ليقابله في نهاية المطاف بعمله وكدحه, وذلك كما في قوله سبحانه: “يَاأَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ” [الانشقاق:6]. بل، لقد جعل الإسلام صدق الكدح أو بطلانه هو سبيل سعادة المرء أو شقائه في الدنيا والآخرة, بقوله تعالى: “وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا” [الإسراء: 72].
هذا، وإن كان يؤكد حرص الإسلام على “العمل”؛ فإنَّه، في الوقت نفسه, يشير إلى القيمة التي أعطاها الإسلام له. إذ إنَّ الإسلام، ولا شك، قد ارتفع بالعمل إلى مرتبة “العبادة”؛ فهو لم يكتف بالحث على العمل بقوله سبحانه: “وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ” [التوبة: 105].. بل، اعتبر أنَّ العمل في ذاته عبادة, وأنَّ الفرد قريب من الله ومُثاب على عمله الصالح في الدنيا والآخرة, بقوله تعالى: “وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ” [الشورى: 26].. وقوله : “يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِي الشَّكُورُ” [سبأ: 13]. وواضح من هذه الآية الكريمة مدى الربط بين الشكر والعمل, وبالتالي فإنَّ الحمد والشكر لا يُعبر عنه في الإسلام بالقول والامتنان, بل أساسًا بالعمل والإخلاص فيه.
بل، إن قيمة العمل تبدو أكثر وضوحًا، عبر ملاحظة التساوى بين الذين “يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ” وبين الذين “يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ” الساعين إلى الرزق، وذلك كما في قوله تعالى: “إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنْ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ” [المزمل: 20].
الثواب والعقاب
وأما القاعدة الثالثة, قاعدة الثواب والعقاب, فهي القاعدة التي يرتكز عليها وجوب إتقان العمل وتحسين الإنتاج كمًا وكيفًا, ذلك لأن هذا الإتقان يعتبره الإسلام أمانة ومسؤولية وقُربة كما في قوله سبحانه: “وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ” [النحل: 93].. وقوله تعالى: “إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا” [الكهف: 30].. وقول الرسول (عليه الصلاة والسلام): “إنَّ الله يحب إذا عمل أحدكم عملًا أن يتقنه” [أخرجه: البيهقي].
والإتقان في اللغة يعني إحكام الأشياء، أي حسن الأداء والسيطرة على الشيء. وقد وردت مادة الإتقان في قوله تعالى: “وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ” [النمل: 88]. ولهذا، فإن الإتقان أي الإجادة والإحكام, مطلوب, بل واجب في كل شيء يباشره الإنسان، ولا يقتصر على مواطن معينة فقط.
وترتيبًا على ذلك, فإن وجوب إتقان العمل, من حيث إنَّه يرتكز على قاعدة الثواب والعقاب, إنَّما يأتي في إطار دعوة الإسلام إلى مراقبة الله والخوف منه في كل شأن من شؤون الحياة. فالعمل الصالح والقول الطيب يرفعه الله إليه، كما في قوله سبحانه: “مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُوْلَئِكَ هُوَ يَبُورُ” [فاطر: 10]. بل، إنَّ الله عز وجل يحذر من مخالفة ذلك، لأنَّ المُخالِف لن يفلت من مراقبة الله وعقابه, ولهذا يقول تعالى: “قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا” [الكهف: 110].
ولأن العمل هو العنصر الفعال في طرق الكسب التي أباحها الإسلام، وهو الدعامة الأساسية للتنمية, كعملية تستهدف تعمير الأرض، فقد أوضح الإسلام أنَّه على قدر عمل المسلم واتساع دائرة نشاطه, يكون نفعه ويكون جزاؤه.. يقول سبحانه: “مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ” [النحل: 97].. ويقول تعالى: “يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ • فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَه • وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَه” [الزلزلة: 6 ـ 8].
هذه الآية الكريمة تشير بجلاء إلى قاعدة الثواب والعقاب, التي ينظم الإسلام من خلالها النشاطات الإنسانية كافَّة؛ بل، إنَّ الإسلام –وبناءً على هذا التوضيح الاختياري بين عمل الخير وعمل الشر– يأمر بممارسة النشاطات النافعة ويصفها بأنَّها حلال، وينهى عن تلك التي توصف بأنَّها حرام.
وعلى هذا الأساس، فإن كان العمل هو الذي يمنح الإنسان قيمته في الحياة، وإذا كان هو سبيل تقدم الأمم وتعمير الأرض، فإنَّ العمل يأخذ في الإسلام جانبًا اجتماعيًا مضافًا ومكملًا لجانبه الشخصي، إذ تتعلق مصالح الناس بالعمل، إيجابيًا بناءً على حاجة المجتمع إلى هذا العمل، من جهة؛ وسلبيًا بناء على تضرر المجتمع من الأعمال السيئة، من جهة أخرى. ولذا، يكون من المنطقي أن تقاس الأعمال في أهميتها وضرورة مراقبتها والتدخل في شأنها بـ”مقياس” حاجة المجتمع لها ومدى نفعها له.
وهكذا، يبدو التكامل الرائع في نظرة الإسلام إلى “البعد الاجتماعي” للتنمية، وذلك من خلال التكامل بين القواعد الثلاث: قاعدة تعمير الأرض, وقاعدة قيمة العمل, وقاعدة الثواب والعقاب.. هذه القواعد التي ترتكز عليها, في الإسلام, الدوائر الثلاث للمسألة الاجتماعية، الإنسان والمجتمع، العمل والإنفاق، الحلال والحرام.