ولد الإمام أبو حامد الغزالي، بطوس من أعمال خراسان عام 450 هـ، وتربى تربية صوفية في بيت صديق لوالده، وتتلمذ على بعض فقهاء عصره، ومن أشهرهم إمام الحرمين أبو المعالي الجويني. ولما اشتهر اسمه؛ عهد إليه الوزير المشهور نظام الملك بالتدريس في مدرسته المعروفة بالنظامية ببغداد عام 484 هـ.
وكان الغزالي قد حصَّل كثيرًا من العلوم وتعمق فيها؛ ومن بين هذه العلوم الفلسفة، ولكنه لم يتوصل من هذه العلوم، إلى ما فيه راحة نفسه، واستبد به القلق النفسي إلى حد أدى به إلى أزمة روحية عنيفة، وصفها لنا وصفًا شيقًا في كتابه “المنقذ من الضلال”.
نتج عن هذه الأزمة، انصراف الغزالي عن تدريس ما كان يدرسه من علوم، وإقباله على اعتزال الناس، صارفًا النظر عما حققه من شهرة واسعة وجاه ونفوذ. وهكذا تبدت نزعة التصوف عند الغزالي وآمن بأن “الاتجاه إلى الله هو الدواء الشافي” لأزمته.
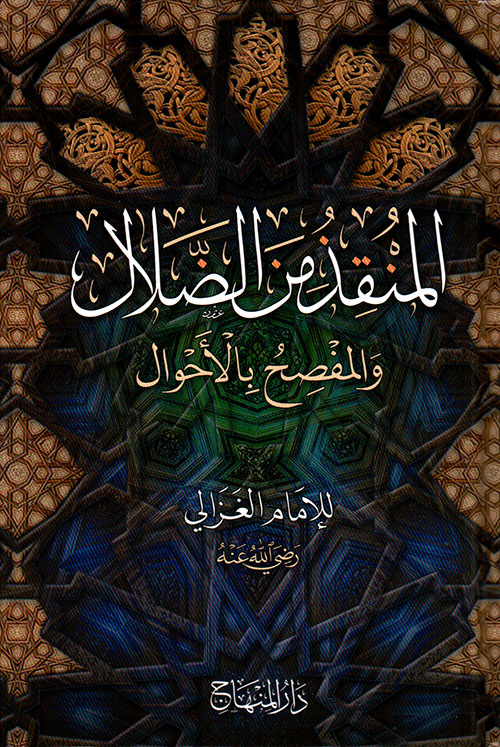
الغزالي وطريق التصوف
وكان الغزالي مفكرًا خصبًا في إنتاجه، واسع الثقافة. فقد ألف عددًا ضخمًا من الكتب والرسائل، قُدرت بثمانين مؤلفا في مجالات متعددة، كالفلسفة (مقاصد الفلاسفة، وتهافت الفلاسفة)، وعلم الكلام (الاقتصاد في الاعتقاد، وإلجام العوام عن علم الكلام)، والفقه (الوسيط، والبسيط، والوجيز، والخلاصة)، والمنطق (معيار العلم).
أما كتبه ورسائله في التصوف، فهي كثيرة، أهمها “إحياء علوم الدين”، الذي شرح فيه بالتفصيل مذهبه في التصوف، رابطًا إياه بالفقه والأخلاق الدينية؛ وكذلك كتابه “المنقذ من الضلال” الذي صور فيه حياته.
وينتمي الغزالي فقهيا إلى الشافعية، ومتكلما إلى الأشاعرة. وبالرغم من نقد الغزالي للمتكلمين، يظل حتى بعد تصوفه، متكلمًا أشعري العقيدة إذ، يعتبر من أئمة الأشعرية من أهل السنة. وهو يقيم تصوفه على أساس دائم من الفقه وعلم الكلام معًا.
يناءً على ذلك، تنشأ تصورات الغزالي للنص القرآني، ولأهدافه وغاياته، من منطلقين اثنين: الأول، من تصور الأشاعرة للقرآن الكريم بوصفه صفةً من صفات الذات الإلهية؛ في حين يتحدد منطلقه الصوفي، من حصر غاية الوجود الإنساني على الأرض، في تحقيق الفوز والفلاح في الآخرة. وإذا كانت هذه الغاية يمكن الوصول إليها وتحقيقها، عبر تحقيق الوجود الإنساني الأمثل في الواقع والمجتمع؛ إلا أن الغزالي يرى أن تحقيقها لا يتم إلا عبر الزهد في الدنيا والانقطاع إلى الله وطرح كل ما سواه.
وقد سجّل الغزالي وصفه لطريق التصوف في كتابه “إحياء علوم الدين” بحيث يمكن القول إن هذا الكتاب كله وصفٌ لطريقته الصوفية. لذا، يقسم الغزالي كتابه إلى أربعة أجزاء: العبادات، والعادات، والمهلكات، والمنجيات.

ويقوم مفهوم الإحياء عند الغزالي، على افتراض مؤداه العودة إلى الماضي لحل معضلات ومشكلات الحاضر. بذلك يكون الحاضر –في هذا الافتراض– نموذجًا للضعف والانحراف عن المعايير الأصيلة للدين، في حين يكون الماضي نموذجًا للطهارة والنقاء وتحقيق الوجود الفعلي للوحي. أما العلوم فهي تنقسم –عند الغزالي– إلى نوعين: علوم الدين وعلوم الدنيا. ثم يأتي تصوره للدين بكونه الخلاص الفردي في الدنيا والآخرة.
وفي ما يبدو، فإن تصنيف الغزالي للعلوم بهذا الشكل، إنما يُعبر عن الثنائية الحادة في تصوره للعلاقة بين الدنيا والآخرة. ورغم أن القرآن الكريم لا يضع مثل هذا التعارض الحاد بينهما؛ بل يطلب من المسلم ألا ينسى نصيبه من الدنيا، إلا أن الغزالي يُعبر عن تصوره للتعارض الحاد بينهما، بحيث يستحيل جمعهما، ويجعل من هكذا تصور الحد الأدنى من العلم؛ ذلك الذي ينبني على أن الدنيا مجرد معبر وطريق إلى الآخرة.
الغزالي وإشكاليات التقسيم
الملاحظة الأهم –في هذا المجال– هي ما قام به الغزالي من تقسيم آيات القرآن، وتشبيهها بالجواهر. إذ نراه يقول: “معرفة الله تعالى وذلك هو الكبريت الأحمر، وتشتمل هذه المعرفة على معرفة ذات الحق ومعرفة الصفات ومعرفة الأفعال. وهذه الثلاثة هي: الياقوت الأحمر فإنها أخص فوائد الكبريت الأحمر. وكما أن لليواقيت درجات فمنها الأحمر والأكهب والأصفر، وبعضها أنفس من بعض، فكذلك هذه المعارف الثلاثة…”.
ومن المنطقي، بعد تقسيم الآيات القرآنية، أن يتبع ذلك تقسيم الناس؛ إذ لما كانت الدنيا مجرد معبر للآخرة، فإن عمارة الدنيا هي مقدمة لعمارة الآخرة، وبدلًا من أن يكون الخلاص الأخروي نتيجة للفعل الإنساني في عمارة الأرض وتحقيق وجوده فيها، صار تقسيم الناس هو الحل. ومن ثم، صار الناس عند الغزالي منهم العامة ومنهم الخاصة. والخاصة –من منظوره في التصوف– هم أرباب المقامات والأحوال، السالكون إلى الله عبر التخلي عن مطالب الدنيا.
وهكذا، صار هناك أهل الدنيا وهم كما يرى الغزالي، أهل الظاهر الذين يكفيهم الإيمان العادي ليحقق نجاتهم من العذاب ويوصلهم إلى النعيم المادي؛ وهناك أهل الآخرة، وهم أهل الباطن الذين يعانقون الحقيقة ويفنون فيها فيفوزون بالنعيم الدائم.
الغزالي وعلم المكاشفة
ولعل القارئ لكتاب الغزالي “إحياء علوم الدين”، يمكنه ملاحظة نقطتين أساسيتين:
الأولى، أن الغزالي يتميز عما سبقه من الصوفية بأنه جعل التصوف طريقًا واضح المعالم والحدود. وهو يرى أن أداة المعرفة الصوفية هي القلب، وليست الحواس ولا العقل. والقلب عنده كالمرآة، والعلم هو انطباع صور الحقائق في هذه المرآة، فإذا كانت مرآة القلب غير مجلوة، فإنها لا تستطيع أن تعكس حقائق العلوم. والذي يجعل مرآة القلب تصدأ هي شهوات البدن. وبالتالي، فإن الإقبال على طاعة الله والإعراض عن مقتضى الشهوات، هو الذي يجلو القلب ويصفيه.

الثانية، أن الغزالي يُميز بين الكشف عند الصوفية، وبين وحي الأنبياء؛ فيرى أن معرفة أولياء التصوف تتم بلا واسطة من حضرة الحق (الله تعالى)، وهي الإلهام الذي لا يدري الصوفي كيف حصل له ولا من أين جاء إليه، في حين أن معرفة الأنبياء وحي يحصل للنبي، ويدري النبي سببه، وهو نزول الملك عليه. ومع ذلك، فإن كل من النبي والولي موقن بأن العلم في الحالين هو من الله سبحانه وتعالى.
ونتيجة لهاتين النقطتين، يرى الغزالي أن تعبير المتصوف عن حقائق التوحيد صعب للغاية، ولا تصلح له اللغة العادية. ورغم أن الغزالي بوجه عام يتميز بوضوح الأسلوب، إلا أن ذلك يبقى في نطاق المعاملة. أما علم المكاشفة فليس إلى تدوينه من سبيل. ولذا، يرى الغزالي أن علم المكاشفة علم خفي لا يعلمه إلا أهل العلم بالله؛ وبالتالي فإن أصحابه يستخدمون رموزًا خاصة، ولا ينبغي التحدث فيه خارج نطاق أهله. وهكذا، يرى الغزالي ضرورة التزام السالك (الصوفي) بالأخذ عن شيخ، “فمن لم يكن لديه شيخ يهديه، قاده الشيطان إلى طرقه”.. وهي القاعدة التي اعتمدها السلفيون في حياتهم وأفكارهم، رغم خلافهم واختلافهم، الواضح والعدائي، مع المتصوفة.
رغم ذلك، فإن أهم ما يمكن أن يُقال عن الغزالي، ويُثير الإعجاب في آن، أنه لم يكن فقط، صوفيًا إيجابيًا (عُني بشؤون عصره وتفاعلات ما تضمنه من أفكار).. ولكنه إضافة إلى ذلك، كان مفكرًا عاش آراءه، ويعتبر تصوفه صورة لحياته، وحياته صورة لتصوفه.









