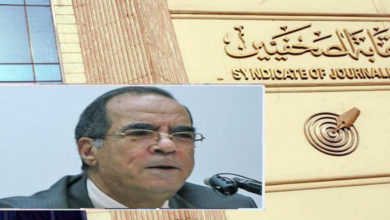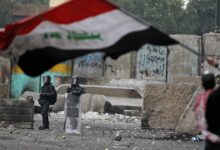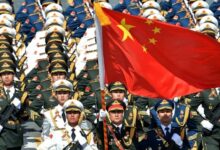عندما سيطر العثمانيون الأتراك على الشام عام 1516، أصبحت القدس تابعة لهم، بعد أن كانت تابعة من قبل لدولة المماليك.
ومن الثابت أن الدولة العثمانية حرصت على مدار تاريخها، على إرضاء رعاياها من اليهود والنصارى وإزالة الفوارق بينهم؛ حتى مشاركتهم في الإدارة العامة وتقليدهم المناصب الرفيعة. ولعل هذا يعود في ما يعود إليه، إلى أن نزاع الطوائف في ما بينها كان له أسوأ الأثر على الدولة العثمانية، خاصة مع استغلال الدول الأوروبية لهذه الخلافات والنزاعات الطائفية.
اليهود والدولة العثمانية
لقد تبدّى هذا الاستغلال المشار إليه بأوضح صورة مع بدايات القرن التاسع عشر مع بروز قضيتين هامتين، القضية الأولى: المسألة الشرقية، التي تمثلت في عملية التربص بإرث الخلافة العثمانية، التي كانت إمبراطورية شاسعة تمركزت في قلب العالم، من شواطئ بحر قزوين إلى شواطئ المحيط الأطلسي، وضمت أقطارًا كثيرة من جنوب أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. لكن الضعف والوهن قد أصابها، وعجزت وتهيأت كل ممتلكاتها الأوروبية والآسيوية والأفريقية لتكون ميراثًا للغالبين من الدول الأوروبية التي أطلقت على الدولة العثمانية، حينذاك اسم الرجل المريض.
والقضية الثانية: المسألة اليهودية، التي تمثلت في قضية ديانة توزع أتباعها في أنحاء الأرض، وكان يهود العالم منذ مأساة الخروج مع المسلمين من الأندلس عام 1492، موزعين بين أوروبا وشمال أفريقيا، حيث لجأ الكثيرون منهم إلى العالم الإسلامي في نهاية العهد المملوكي وبداية التوسع العثماني التاريخي في العالم العربي.
منذ تلك الأيام، كان الكلام عن العودة إلى فلسطين نداءً يتردد على لسان أحد الحاخامات بين حقبة وأخرى؛ ولم يكن هناك من يأخذ هذا النداء على محمل الجد، أو يعلق عليه بأكثر من أنه: “حنين يجتر الوهم، لأن العودة خلط متعسف للأسطورة بالتاريخ”.
ولعل هذا هو ما دفع العديد من الدول الأوروبية إلى اللعب بورقة اليهود؛ للسيطرة على المنطقة المتحكمة في قلب العالم (المنطقة العربية) من جهة ولحل مشكلة اليهود داخل مجتمعاتها بترحيلهم بعيدا عنها، من جهة أخرى.
مصر ورؤية نابليون
إن أوضح الأمثلة على قولنا الأخير هذا، هو نابليون بونابرت.. الذي حاول أن يعزف على الوتر الديني اليهودي وأساطيره في نهاية القرن 18، وبداية القرن 19، بحيث تكون فلسطين وهي حينذاك من أملاك الدولة العثمانية التي يتسابق الكل على إرثها– الوطن الموعود والمختار لليهود برعاية فرنسا، وذلك لتكون فلسطين نقطة البداية لخطط فرنسا الإمبراطورية في قلب أملاك الخلافة العثمانية؛ في وقت كان التنافس الدولي بين فرنسا وإنجلترا على أشده، فضلًا عن القوى الاستعمارية الأخرى.
لم يكن نابليون يهوديًا ولا مواليًا لليهود، لكنه كان يملك حسًا استراتيجيا نابهًا وبعيدًا؛ وكانت ورقته اليهودية المتمثلة في ندائه الشهير ليهود العالم، من خارج أسوار القدس– هي المعبرة عن دوره ودور فرنسا في مساندة هذا التحرك؛ رغم أن عدد اليهود في فلسطين، طبقًا لتقرير مرفوع إليه من مجموعة ضباط استكشاف سبقت جيشه إلى فلسطين، كان 1800 يهوديا فقط منهم 135 يهوديًا في القدس.

ولعل هذا الحس الاستراتيجي يتبدى بوضوح، إذا لاحظنا كيف أدرك نابليون أهمية مصر، وذلك من جهتين:
الأولى أنها تتميز بموقعها الحاكم على طريق التوسع الإمبراطوري، خصوصًا إلى الهند وما حولها. ومن ثم، فإن السيطرة على مصر تعد مقدمة ضرورية لأي قوة تريد أن تتصدى لبريطانيا، وتريد أن تتحدى سيطرتها على التجارة وعلى البحار.
ومن جهة أخرى، فمصر في اتصال غير قابل للانفصال مع السهل السوري، الذي يشكل معها زاوية قائمة تحيط بالشاطئ “الشرقي ـ الجنوبي” للبحر المتوسط. ومن ثم، أدرك نابليون أن هذه الزاوية القائمة بضلعها الجنوبي في مصر، تمد تأثيرها بالعرض إلى كل الساحل الشمالي لأفريقيا، وبالطول إلى الجنوب حتى منابع النيل.. ثم إنها بضلعها الشمالي في سوريا، تلامس حدود العراق وشبه الجزيرة العربية والخليج، وحتى طرق الاقتراب البري والبحري إلى فارس والهند.
اليهود وأطماع نابليون
في هذا السياق، كان نابليون يرى أنه لكي يضمن عدم التقاء الضلعين عربيًا وإسلاميًا، فإنه لابد أن يزرع عند نقطة التقائهما (أي عند مركز الزاوية) شيئا آخر لا هو عربي ولا هو إسلامي.
ولأن هذا الزرع لا يمكن خلقه من العدم، وإنما يحتاج في خلقه هذا إلى بذور (حتى وإن كانت من جنبات حفريات الإنثروبولوجيا) بحيث يمكن غرسها في التربة؛ لذا كانت ورقة نابليون اليهودية تصورًا استراتيجيًا وإن كان استعماريًا للمستقبل، نعني لمستقبل مصالح القوى الكبرى في هذه المنطقة في العالم.
ورغم أفول نجم نابليون في أوروبا عام 1815، ومع التحقق الأول في التاريخ الحديث لحلم جمع الزاوية الشرقية/الجنوبية من البحر المتوسط على يد محمد علي في العقد الرابع من القرن التاسع عشر، ثم مع نجاح بريطانيا في إعادة محمد علي إلى الحدود المصرية وانسحابه من الشام، عقب معاهدة لندن 1840، أصبح بالإمكان إقامة العازل بين ضلعي الزاوية القائمة: مصر وسوريا.
ولعل ذلك يأتي ضمن أهم المحددات التي يمكن أن تُفسر سلسلة الحوادث الكبرى، التي وقعت في الربع الأخير من القرن التاسع عشر في مصر وما حولها، وبالتحديد في فلسطين.
نقول بالتحديد في فلسطين، لأنه يمكن ملاحظة أن كافة تلك الأحداث لم تكن لتحدث مصادفة، بقدر ما هي نتيجة لرؤية استراتيجية طرحتها فرنسا (نابليون) و قامت على استثمارها وتنفيذها بريطانيا (وعد بلفور).
بل لا نغالي إذا قلنا: إن سقوط القدس، مع مغادرة آخر جندي تركي عثماني لها صباح اليوم التاسع من ديسمبر عام 1917، وانتهاء الحكم العثماني لها الذي دام زهاء أربعة قرون، كان المقدمة الضرورية والرئيسة لإقامة العازل اليهودي في فلسطين، الذي تم إعلانه عام 1948، بقيام الدولة العبرية.
ومع هذا الإعلان، نجحت القوى الغربية في الفصل بين ضلعي القائمة (مصر وسوريا) وبذلك ضمنت الحد الأدنى من مصالحها الاستراتيجية في هذه المنطقة من العالم: المنطقة العربية ومحيطها الشرق أوسطي، والغرب أسيوي أيضًا.
والأهم، انتقال المشروع الصهيوني من مجرد “الفكرة” التي تضمنها “برنامج بازل” الذي أقره المؤتمر الصهيوني الأول عام 1897، إلى حيز التنفيذ.
ولعل مثل هذا الانتقال من الفكرة إلى التنفيذ، وإن كان قد بدأ بخطوة احتلال فلسطين وإعلان الدولة العبرية، فإنه تقدم خطوات كبيرة، ولا شك باحتلال القدس عام 1967.
فها هنا تبدي بوضوح كم كانت ولا تزال مدينة القدس تمثل الأولوية الأولى في المخططات الصهيونية.. فهي نقطة الارتكاز في تبرير الممارسات الإسرائيلية طوال نصف القرن الماضي؛ وهي نقطة المحور في جذب اليهود من أجل الهجرة إلى فلسطين… يتبع.