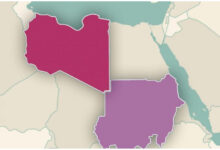ما الأسماء التي تعلمها آدم عليه السلام؟ ما هذه الأسماء التي لم تكن تعرفها الملائكة، قبل أن يُنَبِئهم آدم بها، بأمر من المولى عزَّ وجل؟ ثم ما هو الرابط بين تعلم آدم لهذه الأسماء، ودلالة الاصطفاء الإلهي له ليكون في الأرض خليفة؟ هذه وغيرها كثير، تساؤلات تطرح نفسها بقوة، في إطار محاولتنا البحث في معنى الاستخلاف ودلالته.
في معرض الإجابة عن تلك التساؤلات، نبدأ من دلالة لفظ “اسم” الذي يأتي في الأصل من وسم وهو فعل يدل على أثر ومعلم، ووسمت الشيء وسما: أثرت فيه بسمة، بما يعني أن الاسم هو سمة لصاحبه، أي شيء يُميزه عن غيره؛ ولذا يكون المراد من الأسماء “الصفات”.
مصطلح “اسم” ودلالته
لنا أن نلاحظ ذلك في الآية الأولى من آيات التنزيل الحكيم: “بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ” حيث تؤشر الآية إلى الصفة المميزة “لله” والله هو لفظ ـ ولا نقول اسم ـ الجلالة، ومن سماته أنه “الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ”. وهي نفس دلالة الاسم في قوله سبحانه وتعالى: “سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى” [الأعلى: 1]؛ وفي قوله سبحانه: “تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ” [الرحمن: 78].
ويأتي ورود لفظ “اسم” في آيات الله البينات، كمصطلح ذي دلالة على سمات، وصفات، بعض من الأنبياء عليهم السلام جميعا. ففي قوله سبحانه وتعالى: “إِذْ قَالَتْ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ” [آل عمران: 45] يأتي مصطلح “اسْمُهُ الْمَسِيحُ” للدلالة على سمة عيسى بن مريم عليه السلام، وهي السمة التي جاء ذكرها في قوله سبحانه: “وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنْ الْمُقَرَّبِينَ ٭ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنْ الصَّالِحِينَ” [آل عمران: 45-46].
أما في قوله تعالى: “يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا” [مريم: 7] فإن مصطلح “اسْمُهُ يَحْيَى” يجيء للدلالة على السمة التي تميز “يَحْيَى” عن غيره، والتي ورد ذكرها في الآية: “لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا”؛ إذ، إن سمة “يَحْيَى” عليه السلام أنه أكثر اسم حي من أسماء أهل الأرض جميعًا.
ثم، في قوله سبحانه وتعالى: “وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ” [الصف: 6] يأتي مصطلح “اسْمُهُ أَحْمَدُ” ليؤشر إلى دلالة السمة المميزة لخاتم الأنبياء، محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه؛ حيث إن “أَحْمَد” هي صيغة تفضيل على وزن أفعل من “حَمَدَ”، بما يعني أن الله سبحانه قد أعطى لمحمد –صلى الله عليه وسلّم– سمة “الحمد” المميزة بالتفضيل على من سواه من الأنبياء والرسل.
ولنا أن نتأمل سمة “الحمد” هذه في التنزيل الحكيم.. فقد بدأ الله كتابه الكريم بالحمد: “الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ” [الفاتحة: 2]، وبدأ إنزال الكتاب بالحمد: “الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجَا” [الكهف: 1]، وبدأ الخلق بالحمد: “الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ” [الأنعام: 1]، وأنهى دخول الجنة بالحمد: “وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ” [يونس: 10].
العَلَم ومحمول الاسم
ولنا أن نلاحظ، أن ثمة فارقًا مُهمًا يتبدى بوضوح بين التعريف وسمة هذا التعريف، في آيات التنزيل الحكيم؛ إنه الفارق في دلالات ألفاظ القرآن الكريم وعائدها المعرفي، ما بين أسماء العَلَم ومحمولات هذه الأسماء، بحسب اصطلاحات اللسان العربي.
فقد ميز التنزيل الحكيم بين اسم العلم محمد (التعريف) واسم المحمول أحمد (سمة هذا التعريف) كما ميّز بين اسم العلم عيسى واسم المحمول المسيح، وجمع ليحيى بين اسمي العلم والمحمول في اسم واحد حين أسماه الله سبحانه وتعالى “يَحْيَى” أي إن الاسم المحمول يتعلق بسمات وخصائص وهوية الحامل له.
ولعل هذا ما يُتيح لنا الاقتراب من قوله سبحانه: “وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاء إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ٭ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ” [البقرة: 31-32]. وهنا، لنا أن نؤكد على نواحٍ ثلاث.
من ناحية، في قوله سبحانه: “وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ”، فإن ورود لفظ “الْأَسْمَاءَ” في الآية كمصطلح يعني أن الذي لم تعرفه الملائكة هو “الْأَسْمَاءَ” المتعلقة بالمعروضات، من حيث إن المطلوب معرفته ليس اسم العلم وإنما اسم المحمول، أي سمات وخصائص هذه المعروضات.
ولنا أن نلاحظ أن الإشارة في “ثُمَّ عَرَضَهُمْ” تتعلق بشيء موجود وكائن، أي الموجود الحسي والواقعي، وليس الموجود اللغوي أو الذهني، الذي يُقال فيه “عرضها” بما يُشير لذات الأسماء. فأسماء الأعلام كانت الملائكة تعرفها، وآدم يعرفها، والبشر الذين كانوا يُفسِدون في الأرض ويسفكون الدماء يعرفونها.
ألم يتساءل الملائكة بمفردات دالة على أسماء علم؟ فقد أشاروا إلى مُسمى الأرض، وإلى الدم، وكونه مسفوكا؛ كما أشاروا إلى الفساد ـ أو الإفساد المطلق الذي يصل إلى حد سفك الدماء ـ من حيث إنه فعل مادي وليس سلوك لا أخلاقي، أي سلوك مخالف لأوامر الله ونواهيه، فهذا يُسمى فسوق وليس فسادا. فليست الأسماء المقصودة، إذن أسماء علم.
آدم والملائكة والمعرفة
من ناحية أخرى، في قوله تعالى: “فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاء إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ” فإن الصدق هنا إشارة إلى ظن الملائكة ـ في ما مضى ـ بأن الله يستخلف من بين بشر يُفسدون في الأرض، بحيث يتضح أن معطيات الأسماء تتعلق بمفارقة السلوك البشري “البهيمي” الذي تساءلت عنه الملائكة، وإلا لما طُرِحت “الصدقية” في هذا المجال.
فالذين عرضوا على الملائكة، كانوا يتصفون بأسماء محمولة تُقرر حالتهم؛ وهي حالة يفترقون بها عن أوضاع أولئك الذين يسفكون الدماء، بمعنى أنه افتراق سمات وخصائص وهوية. أما في قوله سبحانه: “وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا”، فإن “آدَمَ” جاء هنا اسم جنس للدلالة على الإنسان الذي اصطفاه الله سبحانه وتعالى من بين “بشر” ونفخ فيه من روحه فأصبح إنسانًا، وليبدأ معه تاريخ الإنسانية.
ثم إن “الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا” في الوقت الذي تؤكد فيه أن الأسماء التي تعلمها آدم شاملة، بما يعني “الإحاطة” فإنها –في الوقت نفسه– تُرَد إلى “آدَمَ” بما يُؤشر إلى اختصاصها به. وقد تولى آدم تعريف من عُرِضوا على الملائكة بأسماء محمولاتهم كخطوة رئيسة في مفارقة السلوك البهيمي في الأرض.
ويبقى أن نلاحظ أن “هَؤُلَاء” في الآية تأتي للدلالة على أن المعروضات مخلوقات “إنسانية” عاقلة؛ كما في قوله سبحانه: “قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ” [هود: 78]، وكما في قوله تعالى: “فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا” [النساء: 41]. إذ إن جمع غير العاقل يُعامل في اللسان العربي معاملة المُفرد، فنقول: هذه أشجار، وتلك طيور.
من ناحية أخيرة، في قوله سبحانه: “وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا” [البقرة: 35]، فإن السياق القرآني يُركز على العلاقة الزوجية بين آدم وزوجه ارتباطًا، وذلك بعد أن تعلم آدم “الأسماء” وأنبأ بها الملائكة. وهنا تأتي أهمية الدلالة في مسألة الاصطفاء الإلهي لآدم عليه السلام، من حيث إنها ترتبط بالتشريع وحمل الرسالة، كما في قوله سبحانه: “إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ” [آل عمران: 33]. فإذا كان نوح أول من أُوحِي إليه، فقد كان آدم الذي اصطفاه الله من بين البشر، وميزه بالروح، أو تحديدا بـ”نفخة الروح” (سر الأنسنة) أول من اضطلع بمسئولية ومهام “الخلافة” في الأرض.
ولأن هذه المسئولية تتطلب تشريعا إلهيا، يُفارق بموجبه آدم سلوك “مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ” [البقرة: 30] فقد جاء هذا التشريع، كأول تشريع ديني في تاريخ الإنسانية، عبر الأسماء التي تعلمها آدم؛ فما تعلمه هو “الشرعة” النقيضة للسلوكية البشرية الأولى، أي محمولات الأسماء “العائلية”.
فـ “الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا” تنحصر في التكوين العائلي ذي العلاقة الجديدة؛ فحواء اسم علم وهي امرأة ومحمولها زوجة، واسم المولود الذكر علم ومحموله ابن، وكذلك اسم المولودة الأنثى علم ومحمولها ابنة.. بل إن آدم نفسه اسم علم، أما محموله فزوج يسكن مع زوجه الجنة، فتحرم على غيره وهو محرم على غيرها.
وهكذا فإن تلك هي “الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا” التي خص الله بها آدم، لتكون أول تشريع للإنسانية، ولتكون الأساس في التشريعات الدينية التالية؛ إنها “الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا” بما تتضمنه من علاقات التحريم، التي تمتد إلى محمولات الأسماء التي بيَّنَتها آيات الذكر الحكيم في سورة “النساء” [23-25] والتي جاء في ختامها قوله سبحانه وتعالى: “يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ” [النساء: 26].