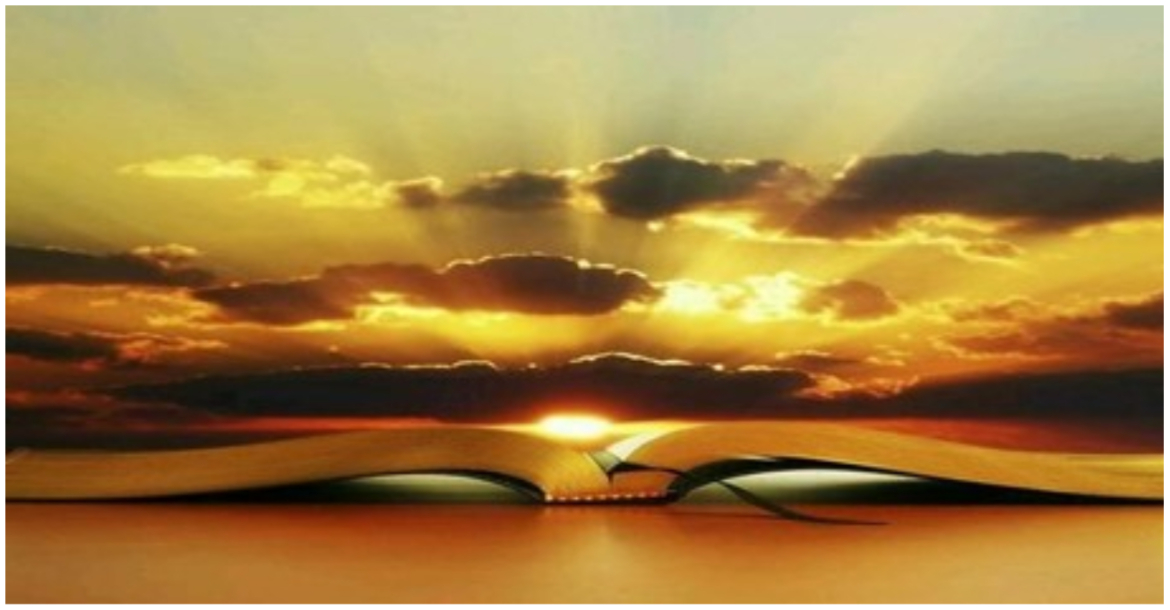إن الحياة التي تعج بحركة البشر في كل مكان في العالم لا يتطابق فيها سعي الناس، فمنهم من يسعى إلى كسب المال الذي يستعين به على مواصلة العيش، ومنهم من يستكثر منه وينهمك في اكتنازه دون توقف، ومنهم من يسعى إلى الشهرة والمجد، وكذلك من يكد في تحصيل العلم والمعرفة، هذا بالإضافة إلى من يسرق ويقتل ويُزوِّر ويفسد في الأرض ويبطش بالأبرياء، وإلى جانب هؤلاء هناك من لا يبذل أي جهد ولا يحاول أن يعمل أي شيء فتتغير الدنيا من حوله كل يوم ويظل هو لا يغير من نفسه ولا من حياته شيئًا.
وما بين الكد والكسل يتدافع ذوو الطموح وأصحاب الآمال العريضة –سواء كانوا من أهل الخير أم من أهل الشر– في تكالبٍ ملحوظٍ على زخرف الدنيا الذي يغري الجميع كي ينهلوا من نهره الغزير، فما أن يغترفوا من مجراه شربة واحدة سواء كانت مباحة أم مُحرَّمة حتى يتسارعوا كي يملئوا بطونهم من مائه دون ارتواء، وعلى النقيض منهم يقف المحرومون والكسالى على أطراف أنهار الدنيا التي تفيض بالذهب والفضة والمال بقلوب متعلقة بمتاعها ونعيمها الزائل، وبأنفس تعج بالشهوات المتلهفة لكل لذة، وبأعين مفترسة ترقب كل ذي نعمة وتلاحقه بشراسة في انتظار اللحظة الحاسمة للانقضاض على الفريسة والتهامها دون رحمة.
وما بين المترفين الغارقين في الشهوات واللذات، وبين المحرومين المشتاقين لأي قدْر من النعيم والترف يظل بعيدًا عن ذلك التدافع الشرس الدائر فيما بين الفريق الأول وعن كل تزاحم غير مرئي يخفيه الفريق الثاني، أولئك الذين أبصرت قلوبهم حقيقة الحياة الدنيا فلم تخدعهم زينتها ولم يجرفهم غرورها في مستنقعها الذي ليس منه نجاة. وهؤلاء لا يزالون في مراعاة لعزائمهم وضمائرهم وقلوبهم حتى نهاية الحياة، فلا يفترون عن جهاد أنفسهم طوال الوقت خشية أن تغافلهم في لحظة ضعف قد تداهمهم فجأة فيخسرون بسببها كل ما دأبوا عليه من قبل.
فلحظة واحدة من الغفلة إذا لم تُتَدَارَك؛ قد تُعرِّض كل من أبصر حقيقة الدنيا لخسارة فادحة، وذلك إذا ما راوده الشك حول مدى قيمة ترفّعه عن الدنيا وحظوظها، فإذا به يُستدرَج فجأة إلى الدنايا واللذات التي تجذبه إليها، مستغلة كل ما كبته في الماضي من طمع وطموح، فإذا بـ”الطيبات” تتمكن من إغرائه فتثور بداخله الرغبات والشهوات والأهواء، وما أن ينغمس فيها حتى يصعب انتشاله من “وُحُولِها”.
وهذا ليس بغريب فالناس صرعى بسبب استعدادهم للاستجابة للإغواء، والحياة قادرة على إغرائهم تارة بسبب قصرها الذي يدفع إلى الرغبة في سرعة اقتناصها وانتهاز فرصة الحصول على طيباتها –سواء كانت مباحة أم لا– وتارة أخرى بسبب ضعف العزائم على تحمل أعبائها وضغوطها وويلاتها وخطوبها. فالجميع مفطور على حب الراحة والدعة والحياة المريحة السهلة اللينة، ولكن الأرض ليست هي الجنة العامرة بكل ما لذَّ وطاب، أو التي تخلو من الألم والآهات، أو التي لا يَعْرَى فيها الإنسان أو لا يظمأ أو لا يجوع؛ بل إن حياة الإنسان فيها تبدأ بألم وصراخ وعُري وضعف، ويظل طوال رحلته فيها خائفًا من الألم والعُري والضعف بل ومن فقدان الحياة برمتها.
ومثلما تُقدِّم الحياة إلى الناس شتى أنواع المتع والملذات؛ فإنها أيضا تسوق إليهم ما يُختَبر به صبرهم وجلدهم وقوة تحملهم. فمع كل إغراء يثير المطامع هناك أيضا تذكير ينبه إلى الاعتبار ويدعو إلى الاتعاظ؛ لذلك هناك من يجذبه الإغواء الذي يمنيه بما تطمع فيه نفسه، وهناك أيضا من يفطن إلى النجاة من شِرَاكِه؛ فيجاهد نفسه كي يفلتها من قبضته قبل أن تتسلط عليه وتتمكن منه.
وطالما أن الحياة قصيرة، فإما أن يُكرَّس جُلها لإرضاء غرور الإنسان وكبريائه وطمعه، أو أن تُستغل قدر المستطاع في ترويض نفسه للارتقاء بها عن الدنايا، وهذا الترويض لن يتحقق طالما كانت (الأنا) متفردة ومنفردة ومنعزلة، بينما في ظل اندماجها مع (نحن) ستحقق ذاتيتها المتعاونة مع غيرها بالرغم من استقلاليتها؛ ومن ثم سيكون للحياة معنى أكبر وأشمل وأعظم وأرقى تختفي فيه العبثية، ويتجلى معه معنى البقاء والخلود. فإذا ما تحول معنى الحياة الزائلة بكل ما فيه من ضيق ومحدودية إلى رحابة معنى الأبدية الذي تتحقق معه النجاة من الموت، آنذاك ستذوب (الأنا) سجودًا لخالق الموت والحياة رب السماوات والأرض (الأعلى) معلنة خضوعها التام وتسليمها المطلق للحي الذي لا يموت.
وربما يتوق الجميع إلى الحياة المترفة والتقدم والحضارة، وينفرون من ضيق العيش ويسخطون على قلة الأرزاق ويمقتون كل تخلف وضعف، ولكنَّ الحضارة التي يصنعها الإنسان لا تقدم له دائما ما ينفعه دون أن يصاحبه ما يسبب له الضرر؛ بل إنها قد تحوّله إلى كائن آلي ممسوخ، يعيش في واقع افتراضي مزيف وغير حقيقي قد يكون فيه ألعوبة في يد صناع التكنولوجيا الذكية، فإذا به يفقد حريته التي يظن أنه قد امتلك زمامها إلى الأبد. وطالما فقد الإنسان قدرته على الاعتراض أو التفوه بكلمة (لا) فحتمًا سيظل أسيرًا في قبضة من يُشكِّلون وعيه ويُقدِّمون إليه كل محتوى يضره ولا يفيده. فهل من الممكن لنفس أسيرة ومكبلة أن تتحرك خارج الحدود المحصورة فيها والمُقيَّدة بداخلها؟
للأسف إن هذا هو سر خداع حضارة اليوم للإنسان! فقد أبهرته بتقنيات الذكاء الاصطناعي الذي قدمته إليه في إطار جذاب يتطور كل يوم بصورة مذهلة وسريعة للغاية مصورة إياه على أنه هو السبيل لتيسير كل عسير عليه، فإذا به يدير كافة شئون حياته بلمسة واحدة من إصبعه، ولكنه في ذات الوقت فقد حريته وقدرته على العيش بعيدًا عن تلك التكنولوجيا الذكية بكل أجهزتها الرقمية التي أصبحت محور حياته؛ بل إنها غدت لا تفارق يده على مدار اليوم حتى باتت أكثر استعبادًا له من أي شيء آخر.
وكأن الحرية لا تكاد تبدو ملموسة للإنسان؛ حتى تنأى عنه مراوغة إياه طوال الوقت. وكأن كل ذلك التقدم الذي تهرول البشرية لنيل نصيبها منه؛ لم يُصِب الإنسان بشيء يعكر مزاجه ويكدر صفو حياته أكثر من السأم والملل من الرفاهية، بل ومن سرعة معرفة كل شيء في أقل وقتٍ ممكن. وهل هناك ما يدفع إلى السأم أكثر من كون الإنسان مُستقبِلًا لما يُقدَّم إليه باستسلام تام، دون أن يكون صانعًا لأي شيء؟! وهل هناك تكبيل لحركة الإنسان الحرة أكثر من جلوسه محني الرأس طوال الوقت بسبب تعلقه المرضي بذلك الجهاز الذي لا يفارق يديه؟!
وهل من الممكن أن تتحقق العدالة والكرامة في عالم أصبح كل شيء فيه موجودًا ومتاحًا عند فئة قليلة من الناس؛ بل إنه كثير أكثر من اللازم وفائض عن الحاجة، بينما هناك آخرون لم يعد لديهم أي شيء وليس لديهم أقل ما يغنيهم عن السؤال أو يحميهم من ألم الجوع وخواء البطن؟!
وهذا لا ينفي أنه بين حين وآخر ربما يود بعض أهل النعيم أن يكسروا روتين حياتهم المترفة والتي تصيبهم بالملل، فيقومون بالعطف على أصحاب الحاجات بأقل القليل مما يملكونه متباهين بذلك أمام الكاميرات، كي تنقل للجميع مدى رقة مشاعرهم وحنان قلوبهم. ولكن هذا العطف الموسمي لن يغير من حال المساكين والمحتاجين ولن يغنيهم عن ذل السؤال؛ بل ربما سيزيد من أعدادهم، لأنه سيغري غيرهم ممَّن هم أفضل حالًا منهم بالالتصاق بهم لمشاركتهم في الحصول على المنح والعطايا دون استحقاقٍ لها، فلا بأس أن يختلط الحابل بالنابل أو أن ينضم غير المحتاجين إلى زمرة الفقراء والمساكين ما دامت العطايا وفيرة وبلا حساب.
وما يحدث مع البشر ينطبق أيضًا على الدول؛ فليس هناك ما هو أسهل من مد اليد بالسؤال، وليس هناك ما هو أصعب من العمل والكد للاستغناء عن ذل السؤال. وهكذا تظل الحرية بعيدة المنال فلا ينالها المرفَّهون من فرط استعباد كل تقدم تكنولوجي لهم، كما لا ينالها المحتاجون ومن يتمسح بهم بسبب قبولهم بأن يستعبدهم كل من هم أقوى منهم ممَّن يمنون عليهم بالمساعدة بين حينٍ وآخر.
“ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبۡدٗا مَّمۡلُوكٗا لَّا يَقۡدِرُ عَلَىٰ شَيۡءٖ وَمَن رَّزَقۡنَٰهُ مِنَّا رِزۡقًا حَسَنٗا فَهُوَ يُنفِقُ مِنۡهُ سِرّٗا وَجَهۡرًاۖ هَلۡ يَسۡتَوُۥنَۚ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ بَلۡ أَكۡثَرُهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ (75) وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلٗا رَّجُلَيۡنِ أَحَدُهُمَآ أَبۡكَمُ لَا يَقۡدِرُ عَلَىٰ شَيۡءٖ وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوۡلَىٰهُ أَيۡنَمَا يُوَجِّههُّ لَا يَأۡتِ بِخَيۡرٍ هَلۡ يَسۡتَوِي هُوَ وَمَن يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٖ (76)” سورة النحل
فمتى يقتنص الإنسان حريته، ومتى تعود الأوطان إلى سابق مجدها وعزها، ومتى يسود العدل في العالم، فلا يستأثر القوي بالثروات التي يمنعها عن كل من هم أضعف منه؟ ومتى تكون القوة مصحوبة بالعدل؟ ومتى يصبح التقدم مكسوًّا بلمسة الحضارة المعنوية والروحية إلى جانب اهتمامه بالحضارة المادية والحسية التي تلبي احتياجات الجسد وتهمل احتياجات الروح والفؤاد؟ ومتى تستقل الأوطان وتتخلص من ضعفها وتبعيتها؟ فنراها ذات يوم تنهض بأمورها دون أن تكون عبئًا على غيرها الذين يستغلون ضعفها وحاجتها ويتحكمون في توجيهها كيفما أرادوا ناظرين إليها باستهزاء واستهتار!
إن كل ذلك لن يتحقق إلَّا إذا بدأ كل إنسان بنفسه فامتلك زمامها وكان قادرًا على التفوه بكلمة (لا) أمام نفسه أولًا. آنذاك سيسترد حريته الفردية التي هي الأهم في حياته، وبعدها سيصبح من السهل لمن تخلص من عبودية التكنولوجيا ومن عبودية الشهوات والأهواء أن ينشئ جيلًا جديدًا قادرًا على امتلاك زمام أمره، ومُقدِّرًا لمعنى الحرية الحقيقي، وهؤلاء لن يكون من الصعب عليهم تعمير الأرض تحت مظلة العدل طالما سيتمسكون بالأخلاق محتفظين بيقظة ضمائرهم.