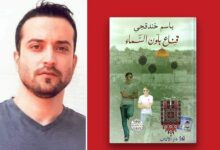ليس واضحا بما فيه الكفاية ومع ذلك فإنه يفصح بكل وضوح عن خلوه مِمَّن يجب أن يملأ كل فراغٍ فيه! بل ومن كل من كانوا من المفترض أن يكونوا جزءًا منه. فكثيرون فضلوا العزلة بعيدا عن المشهد بسبب التضييق وتجنبًا للمضايقات، فهل كل من انعزل وأغلق بابه على نفسه محتضنًا في حشاياه كدر همومه وبقايا سراب أحلامه – قد غاب عن المشهد وعن المشاركة في الحياة والمجتمع بمحض إرادته وعن رغبة حقيقية منه في ذلك؟ وهل كل من أغلق بابه على نفسه بإمكانه أن يوصد باب قلبه؛ كي ينعم بعزلة هادئة مستقرة بلا متاعب أو هموم؟
وبعيدًا عن من فُرضت عليهم العزلة الإجبارية.. هناك فئة أخرى من المنعزلين استطاعوا أن يغلقوا قلوبهم عن سماع أنين من حولهم؛ فاحتموا بعرين الانعزال علّه يحميهم بعدما تضخمت أرصدتهم البنكية؛ حتى كادت أرقامها أن تخيفهم هم شخصيًّا. ولولا ذلك التعالي الذي يشبع لديهم الرغبة في التميز والتفرد، ولولا تلك الأنانية التي تلائم نرجسيتهم لاستطاعوا أن ينجوا بأنفسهم من شراك عزلتهم قبل فوات الأوان.
ولقد سبق وخاطب عميد الأدب العربي الدكتور “طه حسين” [1889-1973م] في أسًى واضحٍ أولئك المنعزلين من أصحاب القلوب المغلقة في مقالٍ له بعنوان (قلب مغلق) نشره في مجلة الهلال عدد فبراير عام 1947م، فعاتبهم قائلًا: “هل نعمت بعزلتك نعمة هادئة مطمئنة، لا ينغصها منظر البؤس، ولا يكدرها صوت الشكاة، ولا يشوبها تفكير في البائسين، سواء منهم من احتمل البؤس صامتًا صابرًا جلدًا، ومن احتمل البؤس صائحًا صاخبًا شاكيًا إلى الله وإلى الناس؟”
أما آن الأوان لكل من لجأ إلى العزلة في غير اضطرارٍ لها؛ بهدف الاحتماء بها بعيدًا عن كل أنين وشكوى أن يفتح قلبه لمن حوله ويتعاون معهم في حمل أثقال الحياة والنهوض بأعبائها؟
“إن حصنك يا سيدي ليس إلَّا قلبك المغلق الذي لا ينفذ إليه شعور بالتضامن أو حاجة إلى التعاون، ولا تصل إليه رحمةٌ؛ حين يحتاج الناس إلى الرحمة، ولا رفق حين يحتاج الناس إلى الرفق، ولا رثاء حين يحتاج الناس إلى الرثاء”.
“إنه قلب قد صُوّر من صخر مجوف تستطيع أن تودعه كل ما شئت من أمل لا حد له، وطمع لا ينتهي إلى غاية، وجشع بشع ليس له قرار، وشهوات جامحة لا سبيل إلى ضبطها، وطموح لا يحده إلَّا الموت، ولكنه على ذلك مقفل مصمت من جميع جوانبه، لا ينفذ إلى داخله أيسر الضوء، ولا أرق النسيم، ولا سبيل إلى تحطيمه؛ لأنه أقسى وأصلب من أن تبلغ منه المعاول”.
“ومثل هؤلاء من أصحاب القلوب المغلقة قد تراهم يتمتعون بالهدوء ولا يحسون اضطراب من حولهم من الناس، أو يسمعون صخب من حولهم من البائسين، طالما أغمضوا أعينهم؛ كي لا ترى ما يسوؤهم، وصموا آذانهم كي لا تسمع ما يؤذيها، وألغوا حواسهم كلها بل سخَّروها لهواهم؛ كي لا تحمل إليهم إلَّا ما يحبون.
وحتى إذا فتحوا أعينهم وآذانهم؛ فإن الواحد منهم سيرى وكأنه لا يرى، ويسمع وكأنه لا يسمع، فإذا التمس قسوة الحياة وغلظتها على البائسين والمحرومين؛ فلن يجد شيئًا بداخله يدعوه إلى فعل أي شيء لمساعدتهم.. بل سيواصل حياته وكأنه لم ير أو يسمع ما يجب أن يتحرك لتغييره وتبديله. إذ المهم عند هؤلاء هو أنهم في منأى عن ذلك البؤس وبعيدون عن أي شقاء، فلماذا لا يستمرون في حياتهم المُنعَّمة دون أن يشغلوا بالهم بأن نعيمها هذا قد اشتق حلاوته، ممَّا سببه للآخرين من مرارة؟ ولماذا لا يتنعمون ما دام قد كُتِب لهم النعيم ويسعدون ما دامت قد أتيحت لهم السعادة؟ أما غيرهم ممَّن كُتِب عليهم البؤس والشقاء فعليهم أن يتحملوا مصيرهم وحدهم فهذا شأنهم”.
فإذا ما وقعت الواقعة التي ليس لها من دون الله كاشفة، وتبدّل حال هؤلاء في غفلة منهم من النعيم إلى البؤس ومن الغنى إلى الفقر ومن الحياة إلى الموت، فلن يكون هناك ما قد كان من قبل، فهل حقًّا تستحق تلك الحياة القصيرة أن نصل إلى نهايتها بقلوب قاسية لم يصل إليها ضوء الرحمة؟ وماذا بعد مفارقة الحياة؟ هل سيختفي معها كل ما قد سلف وكأنه لم يكن؟ فلن يكون هناك حساب على العمل خيره وشره؛ بل على كل مثقال ذرة منه وكأن كل ما مضى لم يكن له وجود!
إن إخراج أصحاب القلوب المغلقة من عزلتهم الأنانية – لن يتحقق سوى برغبة صادقة منهم في تحطيم أسوار تلك الحصون المصفدة التي دعموها بطمعهم ونرجسيتهم، وزينوها بالكِبر والخيلاء والتعالي.. آنذاك فقط سيشاركون عامة الناس في استقبال الحياة حين تشرق وحين تظلم، فيسعدون معهم إذا سعدوا ويشقون معهم إذا شقوا. فهل حقًّا من الممكن أن تتخلص الأرض من هؤلاء الذين يبغون علوًّا فيها فيحتكرون خيراتها ويحرمون منها كل محتاج إليها؛ كي يكتنزوا لأنفسهم الثروات الطائلة؟ وهل سبق واستطاع قارون أن ينجو بنفسه من شر أنانيته وطمعه، أم كان الخسف هو المصير الذي يستحقه والذي به يتخلص الناس من شر كل عالٍ ومفسدٍ في الأرض؟
فماذا إذن عن هؤلاء الذين وصفهم الدكتور طه حسين بأنهم يختفون بعيدًا عن المشهد إذا جد الجد؟ فإذا بهم كالسراب يحسبه الظمآن ماءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئًا، ووجد عنده الحزن، واليأس، وخيبة الأمل، وكذب الرجاء. “فهم لا يوجدون إلَّا حين تشرق النعماء، بينما يختفون حين تظلم البأساء، فلا يعرفون سوى مشاركة غيرهم في العيش الرضي، والحياة المقبلة، بينما يبتعدون أقصى البعد حين يغلظ العيش، ويعظم البأس، وتُدبِر الحياة”.. فهل من الممكن منح الثقة لهؤلاء في حمل أعباء حياة الناس أو إيجاد حلول لمشاكلهم وهم يُظهرون أمام الناس عكس ما يخفون في صدورهم؟
إن قلوب هؤلاء قد أغلقت على حب المنفعة الشخصية، ولذلك فإن أنانيتهم أبغض ممَّن سواهم بل أشد ضررًا وأعظم سوءًا لأن وجودهم مع الناس لن يكون لمشاركتهم والتعاون معهم بل للاستفادة من كل محنة يتعرضون لها وتحصيل المنافع من كل شدة يكابدونها.
وإذا كانت تلك هي بعض أحوال أصحاب القلوب المغلقة سواء من المتعالين المتشبهين بإبليس أو من المنافقين المخادعين، فإن أحوال المُغيبة عقولهم والميتة ضمائرهم أعسر على الإيجاز وأعصى على الوصف في هذا المقال؛ ومع ذلك فإن الكثير من المَشاهد قد لا تكتظ سوى بهؤلاء وتكاد تخلو ممَّن يقبعون في عزلتهم المفروضة عليهم، ولكن إذا ما انحلّت يومًا أغلال أصحاب القلوب السليمة، فسيكونون هم الأولى بالمشاركة والأجدر بالمساهمة في تغيير الأحوال للأفضل، المهم أن يظلوا محافظين على سلامة قلوبهم دون أن يمسها أي عطب أو تسكنها الظلمة.
وإلى أن تستقبل المَشاهد من يزينها ويملأ كل فراغٍ فيها؛ فلن يتفاقم بسبب الفساد والطغيان سوى الخمول والركود إلى أن يختفي الحماس الذي يشعل العزائم من أجل المقاومة الفعالة، أو من أجل العمل المثمر؛ ومن ثم لن يكون الإقدام أو الإحجام عن بصيرة ورؤية وقناعة، بل ستكون الأحكام على كل الأمور بدون تدبر أو تفكر في الصالح العام، ولن تُعبر الأفعال سوى عن التخبط والحيرة؛ فمع انتشار الكذب والغش والتدليس سيسود عدم الثقة وسيعم الشك وسوء الظن، ناهيك عن الخوف الذي يكبل كل حركة فعالة في المجتمع.. وما أن تتوقف الحركة الفعالة في أي مجتمع؛ فهذا يعني أنه قد تشبّع باليأس والإحباط، ولم يعد لأفراده أي أمل في المستقبل، وذلك هو الموت المحقق الذي قد ينتج عن تحكم أصحاب القلوب المغلقة في مصير العالم.