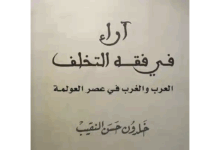وصلنا من خلال حديثنا عن دلالة “أُمَّةِ اَلْدَعْوَة”، في التنزيل الحكيم، إلى أن الأمر “بِٱلۡمَعۡرُوفِ” والنهي “عَنِ ٱلۡمُنكَرِ”، والحفظ “لِحُدُودِ ٱللَّهِۗ”؛ هي صفات “ثلاث”، من بين الصفات “التسع” التي وردت في قوله سبحانه: “ٱلتَّٰٓئِبُونَ ٱلۡعَٰبِدُونَ ٱلۡحَٰمِدُونَ ٱلسَّٰٓئِحُونَ ٱلرَّٰكِعُونَ ٱلسَّٰجِدُونَ ٱلۡأٓمِرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡحَٰفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِۗ وَبَشِّرِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ” [التوبة: 112]؛ وهي الصفات التي وردت في فئة مُحددة من الناس، ذكرتها الآية السابقة مُباشرة، لهذه الآية، نعني قوله تعالى: “إِنَّ ٱللَّهَ ٱشۡتَرَىٰ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ أَنفُسَهُمۡ وَأَمۡوَٰلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلۡجَنَّةَۚ…” [التوبة: 111].
ولأن هذه الصفات “الثلاث”، هي حيثية تخص أمة محمد، أو “ٱلۡمُؤۡمِنِينَ”؛ لذا اختص التنزيل الحكيم في وصف هذه الأمة بكونها “خَيۡرَ أُمَّةٍ أُخۡرِجَتۡ لِلنَّاسِ” [آل عمران: 110].. ليس فقط، ولكن جاء التوجيه الإلهي لهذه الأمة، في سورة آل عمران، في قوله سبحانه وتعالى: “وَلۡتَكُن مِّنكُمۡ أُمَّةٞ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلۡخَيۡرِ وَيَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ” [آل عمران: 104].
ولنا أن نُلاحظ أن التوجيه الإلهي ورد بخصوص أمة محمد، أو “ٱلۡمُؤۡمِنِينَ”؛ بدليل أن الآيات السابقة لهذه الآية [آل عمران: 104]، تنطلق من توجيه الخطاب إلى الذين آمنوا “يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ”، وذلك في قوله سبحانه: “يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ ٭ وَٱعۡتَصِمُواْ بِحَبۡلِ ٱللَّهِ جَمِيعٗا وَلَا تَفَرَّقُواْۚ وَٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ إِذۡ كُنتُمۡ أَعۡدَآءٗ فَأَلَّفَ بَيۡنَ قُلُوبِكُمۡ فَأَصۡبَحۡتُم بِنِعۡمَتِهِۦٓ إِخۡوَٰنٗا وَكُنتُمۡ عَلَىٰ شَفَا حُفۡرَةٖ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنۡهَاۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَهۡتَدُونَ” [آل عمران: 102-103].
في هذا السياق القرءاني، يأتي التوجيه الإلهي إلى “ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ”؛ وفي هذا السياق أيضا يأتي التوجيه الإلهي “وَلۡتَكُن مِّنكُمۡ أُمَّةٞ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلۡخَيۡرِ”.. وهذه الدعوة إلى الخير، تأتي كـ”أول” الأوامر بالنسبة لهذه الأمة، بمعنى أن الدعوة “إِلَى ٱلۡخَيۡرِ”، تأتي صفة من صفات هذه الأمة، متواكبة بذلك مع الدعوة “إِلَى ٱللَّهِۚ”، كما في قوله تعالى: “قُلۡ هَٰذِهِۦ سَبِيلِيٓ أَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا۠ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِيۖ وَسُبۡحَٰنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ” [يوسف: 108].
ثم يأتي الأمر “بِٱلۡمَعۡرُوفِ” والنهي “عَنِ ٱلۡمُنكَرِ”، صفتين من صفات هذه الأمة صاحبة الدعوة، أو بالأصح المُكلفة بالدعوة، “إِلَى ٱلۡخَيۡرِ”. وهنا لنا أن نؤكد على أكثر من جانب:
أولا: إن ذكر الأمر “بِٱلۡمَعۡرُوفِ” والنهي “عَنِ ٱلۡمُنكَرِ”، بعد الدعوة “إِلَى ٱلۡخَيۡرِ”، يؤشر إلى أن ذلك يتعدى حدود الصفة، ليُصبح واجبًا على هذه الأمة، من حيث كونه توجيها إلهيا لها؛ خاصة أن الأمر “بِٱلۡمَعۡرُوفِ” والنهي “عَنِ ٱلۡمُنكَرِ”، دلت عليه آيات كثيرة في التنزيل الحكيم. إذ جاء على لسان لقمان، في قوله عزَّ وجل: “يَٰبُنَيَّ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَٱنۡهَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَٱصۡبِرۡ عَلَىٰ مَآ أَصَابَكَۖ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنۡ عَزۡمِ ٱلۡأُمُورِ” [لقمان: 17]؛ وقول سليمان هذا، يرد وهو يعظ ابنه: “وَإِذۡ قَالَ لُقۡمَٰنُ لِٱبۡنِهِۦ وَهُوَ يَعِظُهُۥ…” [لقمان: 13].
أيضا فقد جاء اللعن لبني إسرائيل لما ضيعوا النهي “عَنِ ٱلۡمُنكَرِ”، كما في قوله عزَّ من قائل: “لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنۢ بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُۥدَ وَعِيسَى ٱبۡنِ مَرۡيَمَۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعۡتَدُونَ ٭ كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوۡنَ عَن مُّنكَرٖ فَعَلُوهُۚ لَبِئۡسَ مَا كَانُواْ يَفۡعَلُونَ” [المائدة: 78-79].
من جانب آخر، إن عطف الأمر “بِٱلۡمَعۡرُوفِ” والنهي “عَنِ ٱلۡمُنكَرِ”، على ما قبلهما من الدعوة “إِلَى ٱلۡخَيۡرِ”، هو من قبيل عطف العام على الخاص؛ إذ في اللسان العربي لا تُعطف إلا المتغايرات، أو العام على الخاص، أو الخاص على العام. وهنا، نكون أمام احتمالين: إما أن يكون الأمر “بِٱلۡمَعۡرُوفِ” والنهي “عَنِ ٱلۡمُنكَرِ” هو العام، وتكون الدعوة “إِلَى ٱلۡخَيۡرِ” هي الخاص، وهو احتمال غير مُرجح بالنسبة إلينا سياقيا ودلاليا.
ومن ثم، يكون لدينا الاحتمال الآخر، الأكثر ترجيحا بالنسبة لنا، وهو أن تكون الدعوة “إِلَى ٱلۡخَيۡرِ” هي العام، ويكون الأمر “بِٱلۡمَعۡرُوفِ” والنهي “عَنِ ٱلۡمُنكَرِ” هما الخاص؛ وهو أمر منطقي من منظور “ال” التعريف الواردة في كل من الخير والمعروف والمنكر. هذا، فضلًا عن أن الأمر “بِٱلۡمَعۡرُوفِ” والنهي “عَنِ ٱلۡمُنكَرِ”، هما جزء من الدعوة “إِلَى ٱلۡخَيۡرِ”، التي ترد “أول” الأوامر الإلهية إلى هذه الأمة.
من جانب أخير، يأتي التعبير بالفعل المضارع، في قوله سبحانه “وَلۡتَكُن مِّنكُمۡ أُمَّةٞ يَدۡعُونَ… وَيَأۡمُرُونَ… وَيَنۡهَوۡنَ…”، للدلالة على التجدد والاستمرار؛ فهذه الدعوة، وذلك الأمر والنهي، لا بد أن تكون في حال من الاستمرارية بلا توقف في كل الظروف؛ خاصة أن هذه الأفعال المضارعة “الثلاثة” تأتي بعد الأمر الوارد في بداية الآية الكريمة “وَلۡتَكُن” ، الذي هو للوجوب.
يقول عزَّ من قائل: “كُنتُمۡ خَيۡرَ أُمَّةٍ أُخۡرِجَتۡ لِلنَّاسِ تَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَتَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَتُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِۗ وَلَوۡ ءَامَنَ أَهۡلُ ٱلۡكِتَٰبِ لَكَانَ خَيۡرٗا لَّهُمۚ مِّنۡهُمُ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ وَأَكۡثَرُهُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ” [آل عمران: 110]؛ بمعنى أن “ثلاثة” عوامل تجعل من أمة محمد، أو “ٱلۡمُؤۡمِنِينَ” به وبرسالته “خَيۡرَ أُمَّةٍ”؛ هي: الأمر “بِٱلۡمَعۡرُوفِ” والنهي “عَنِ ٱلۡمُنكَرِ”، والإيمان “بِٱللَّهِۗ”.
والمُلاحظة التي نود أن نسوق، أنها ليست “خَيۡرَ أُمَّةٍ” على وجه العموم؛ ولكنها مشروطة، إضافة إلى العوامل “الثلاثة” السابقة، بعامل أهم، هو: “أُخۡرِجَتۡ لِلنَّاسِ”. بهذا، جعلها الله سبحانه وتعالى ـ و”الجعل” هو “تغيير في الصيرورة باتجاه التطور”، أي: تحول زائد إضافة ـ “خَيۡرَ أُمَّةٍ أُخۡرِجَتۡ لِلنَّاسِ”. وهنا، يتأكد مرة أخرى أن “ال” التعريف في لفظ “ٱلۡمَعۡرُوفِ” ولفظ “ٱلۡمُنكَرِ” تدل وتفيد “الاستغراق”، وهذا يقتضي كون هذه الأمة تأمر بكل معروف وتنهى عن كل منكر
بيد أن التساؤل الذي يتوارد إلى الذهن، ذلك الذي يتعلق بأسباب تقديم الأمر “بِٱلۡمَعۡرُوفِ” والنهي “عَنِ ٱلۡمُنكَرِ”، على الإيمان “بِٱللَّهِۗ”، رغم أن الإيمان “بِٱللَّهِۗ” لا بد أن يكون مقدما على كل الطاعات؟
وكما يبدو، فإن الإيمان “بِٱللَّهِۗ” هو أمرٌ مشترك بين كافة الأمم، سواء أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أو غيرها؛ ومن ثم، لا يكون المؤثر في خيرية الأمة هو الإيمان “بِٱللَّهِۗ”، الذي هو العامل المشترك بين الكل. لذا، لا بد أن يكون المؤثر في حصول هذه الخيرية “كُنتُمۡ خَيۡرَ أُمَّةٍ أُخۡرِجَتۡ لِلنَّاسِ”، هو كون هذه الأمة تتسم بالأمر “بِٱلۡمَعۡرُوفِ” والنهي “عَنِ ٱلۡمُنكَرِ”، عن سائر الأمم.
وللحديث بقية.