السؤال الذى يفرض نفسه – منذ البداية – هو هل نشأة العلمانية فى الغرب يحول دون الأخذ بها وتكييفها طبقا للثقافات التى تستقبلها دونما إخلال بجوهرها وخصائصها الأساسية؟ الإجابة بالطبع لا..فقد استقبلت ثقافات العالم-على تمايزاتها- العديد من المفاهيم التى يمكن وصفها بالإنسانية كالإشتراكية والليبرالية بانواعهما دون خوف –اللهم إلا عند غلاة الإنغلاقيين الذين وقعوا أسرى فوبيا ما يسمى ب”تهديدات الهوية”، وكأنها-الهوية- جوهر نقى لايعرف التفاعل الحى الخلاق الذى يعد شرطا – بديهيا لتقديم إسهامات متميزة.هذا المقال يستهدف التوقف عند العلمانية الغربية لمعرفة خصائصها والرد على المغالطات الكثيرة التي ألصقت بها.

كنائس إقطاعية
لايمكن فهم الكهنوت الكنسى إلا بربطه بالمصالح الضخمة التى تكسبتها الكنيسة من خلاله، ففي العصور الوسطى – كما يقول وول ديورانت فى “قصة الحضارة” – “أصبحت الكنيسة أكبر ملاك الأراضى وأكبر السادة الإقطاعيين فى أوربا ،كما كانت تملك المساحات الشاسعة من الأراضى الزراعية باعتبارها أوقافا للكنيسة” كما فرضت مايسمى ضريبة “العشور” التى تحصل بمقتضاها على عشر ما تغله الأراضي الزراعية وما يكسبه التجار، ولم يكن لأحد أن يعترض لأن هذا كلام الله.

محاربة العلم
محاربة الكنيسة للعلماء واتهامهم بالهرطقة والحكم عليهم بالإعدام أشهر من أن نحاول الاستفاضة في الحديث عنه، فقد حكموا على “كوبرنيكس بالإعدام بسبب كتابه “حركة الأجرام السماوية “ووافته المنية قبل تنفيذ الحكم، كما حكموا على” برونو” بسبب قوله بتعدد العوالم بالإعدام أيضا ولكن دون قطرة دم، وكان هذا يعنى إحراقه حيا، كذلك حكموا على “جاليليو” بالإعدام بسبب تأكيده حقيقة “دوران الأرض” لولا تراجعه خوفا من مصير “برونو”. هذا بالإضافة إلى تدجين الفلسفة وجعلها – فحسب – في خدمة رؤى “الإكليروس” الدينية.
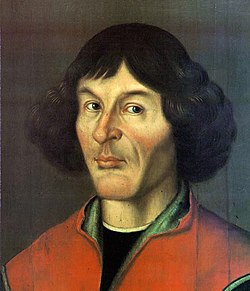
نيكولاس كوبرنيكس
دولة فوق القانون
بهذه السلطات المطلقة التى انتزعتها الكنيسة طيلة القرون الوسطى أصبحت – دون مبالغة – “دولة فوق الدولة”، بل إن الملوك كانوا يرون سلطتهم مستمدة من سلطة الكنيسة، وبالتالي من سلطة الله.
كان من المهم أن أسوق كل ماسبق – بإيجاز شديد – لكى نصل إلى حقيقة تعد نقطة الانطلاق الأولى فى مقاربة العلمانية، وهى أنها لم تكن ضد “الدين” – على عكس مايشيع الإسلاميون الآن – كما لم تكن ضد رجال الدين، بل ضد “الطغيان” باسم الدين وتحقيق كل هذه المصالح الاقتصادية الضخمة التي أشرنا إليها والوقوف في وجه أي تقدم علمي وعقد تحالف غير مقدس بين سلطة الكنيسة وسلطة الملوك.
وقد ساعدت عوامل التطور الاجتماعى والعلمى نفسها على تحقيق غايات العلمانية مع صعود الطبقة البرجوازية، وبدء الثورة الصناعية وتمرد بعض رجال الكنيسة أنفسهم عليها، مثل المصلح الكنسي “ويكلف ” weklf– وهو من أوائل المصلحين – الذي اتهم رجال الدين بأنهم “أتباع قياصرة لا أتباع الله” وطالب بإلغاء الأوقاف التى تمتلكها الكنيسة. أما “مارتن لوثر” فقد قام بثورة حقيقية حين ترجم الإنجيل من اللاتينية -التى لم يكن يعرفها غير القساوسة -إلى “الألمانية” ففتح الباب واسعا أمام تفسير النص الدينى ولم تعد الكنيسة محتكرة لهذا الحق.
مارتن لوثر
رواد النهضة والعلمانية
ما يهم هنا هو كيفية التلقي العربي – والمصري خصوصا – للعلمانية ومفهومها، لاسيما أنها أصبحت ضرورة ملحة من أجل إنشاء الدولة الحديثة، بعد الخروج من عصور الإمبراطوريات الكبرى – بما فيها الخلافة الإسلامية – وسيادة فكرة الدولة القومية أو الوطنية. وبغض النظر عن التقييمات المتباينة لتجربة كمال أتاتورك في تركيا والتي أعقبت سقوط الخلافة العثمانية، تظل هذه التجربة خطوة مهمة في ترسيخ مباديء الدولة العلمانية. وفى هذا السياق يمكن النظر إلى التلقي المصري لهذه الخطوة من خلال أهم الأسماء التى تعرضت لهذه القضية.
“التجديد” ومحاولات الدخول إلى العصر الحديث كان هدفا واضحا لكل رواد النهضة المصرية بدءا من الطهطاوى والأفغانى ومحمد عبده وكان ذلك عبر طريقين: أولهما العودة إلى التراث، وثانيهما الاطلاع على آثار الحضارة الحديثة وهو اتجاه يمثل مايسمى بالسلفية المستنيرة فى مقابل السلفية المحافظة، التي لم ترفض فحسب كل القيم الغربية بل رفضت كل الإنجازات العقلية والفلسفية فى التراث الإسلامى – خاصة ذا النزعات التى ترى ضرورة تأويل النص الدينى عقليا بما يوافق مقتضيات الواقع ويحقق المصلحة – والاكتفاء بالمصدرين الأساسيين للتشريع: القرآن والسنة وفهم الصحابة لهما في عصر الخلافة الراشدة. ويمثل المودودي ومحمد بن عبد الوهاب وحسن البنا وسيد قطب وغيرهم هذا الاتجاه الأخير.

محمد رشيد رضا جمال الدين الأفغاني رفاعة الطهطاوي
وتأتى أهمية محمد عبده الكبيرة من أنه – وهو الأزهرى ومفتى الديار المصرية – قد نقض بوضوح لالبس فيه وجود أى سلطة “دينية ” فى الإسلام واعتبر – كما يقول د.وائل غالى فى كتابه “الأصول الإسلامية للعلمانية – قلب السلطة الدينية والإتيان عليها من أساسها” الأًصل الخامس للإسلام فقد “هدم الإسلام بناء تلك السلطة ومحا أثرها حتى لم يبق لها عند الجمهور أسم ولا رسم. فلم يدع الإسلام لأحد بعد الله ورسوله، سلطانا على عقيدة أحد ولاسيطرة على إيمانه. على أن الرسول عليه السلام كان مبلّغا ومذّكرا، لا مهيمنا ولا مسيطرا” .
ومحمد عبده – فى هذا – يلتقى مع أحد المبادىء الأساسية للعلمانية وهو رفض السلطة الدينية وتأكيد السلطة المدنية، وأن من حق أى مسلم أن يفهم عن الله من كتاب الله وعن رسوله من كلام رسوله، دون وساطة أحد من سلف أو خلف، ولاشك أن هذا قريب مما كان يقصده مارتن لوثر حين ترجم الإنجيل إلى الألمانية .وبهذا يلتقى المصلح الكنسى مع المصلح الأزهرى فى هذه القضية الجوهرية التى تعد أساس بناء أى دولة حديثة.
لكن يظل من غير الوارد – أساسا – وصف محمد عبده بالعلمانى فهو مازال – مثلما كان أستاذه الأفغانى – مؤمنا بالدولة الإسلامية التى يميز بينها وبين الدولة الدينية دائما، وهى تفرقة راسخة فى أذهان كل دعاة الإسلام السياسي .غاية القول إن محمد عبده كان ضد الطغيان الدينى والسياسى ولاشك أن هذا كان سر تحفظه على مشروع محمد على التحديثى الذى بناه على حساب الجماهير لا من أجلهم .وأخيرا يمكن القول إن محمد عبده كان يسعى إلى استنفار طاقات الأمة والعودة إلى تراثها العقلانى – المعتزلى بصفة خاصة – ردا على العلمانية لا تبنيا لها لأنه – كما يقول د. معن زيادة في كتابه ” معالم على طريق.. تحديث الفكر العربى ” – ” كان يخشى أن تتوطد العلمانية الطاغية فى الفكر الأوربى، وكان يدرك أن البنية الدينية فى شكلها الجامد والتخلف الذى كانت قد وصلت إليه، لن يمكنها من الصمود فى وجه هذا المد الجديد، وأن الحل السياسي – الأيديولوجي يكمن في العودة بالإسلام إلى مرونته الأولى التى استطاعت استيعاب الثقافات السابقة عليه. والواقع أن هذا هو جوهر موقف جمال الدين الأفغاني، إلا أن محمد عبده فصّله وأغناه “وكأن لسان حاله يقول – بناء على ماسبق-: نحن لانعرف السلطة الدينية ولايقرها إسلامنا فما حاجتنا إذن إلى هذه العلمانية التى تعالج مشكلة غربية” ولأن هذا يمثل يقينا راسخا عند جميع الإسلاميين – كما ذكرت – فإنه يستحق التوقف عنده لاحقا لمعرفة مدى مصداقيته.













