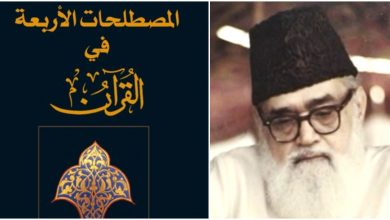استطاع المسلسل الاجتماعي المصري “ليه لأ؟” أن يتناول فكرة تمرد المرأة على الزواج من رجل لا تحبه بالرغم من كونه كامل الأوصاف في نظر أسرتها، فعرض على مدار حلقات قليلة وموجزة وممتعة رحلة الفتاة التي تحاول أن تعيش وحدها رغم أن رفضها للزواج سيتسبب في تعرضها للعنوسة خاصة مع تقدمها في العمر. وهذا ما حدث بالفعل مع خالتها التي باتت تعاني من العنوسة وكذلك من الوحدة بعدما وصلت إلى العقد الخامس من عمرها. وما أن وقعت في حب شاب يصغرها في العُمر بعقد كامل، حتى تعرَّضت هي الأخرى لسخط أسرتيهما رفضًا لفكرة ارتباطهما الشرعي!
ومن هنا نرى كيف يتم تقييد حرية كل من الرجل والمرأة في مجتمعنا مهما بلغا من العمر بقيود مجتمعية بالية وبتقاليد متوارثة ليس لها علاقة بالدين ومع ذلك بلغت درجة من القداسة بسبب الحرص على اتباعها. وتكون النتيجة في النهاية عبارة عن أسر تبدو ظاهريًّا أنها سعيدة ومستقرة ويقبلها المجتمع، بينما هي في الواقع تخلو من المودة والسكينة ولا ترضى عن نفسها.
إن الشكل الاجتماعي الخارجي كي يقبله المجتمع لابد وأن يرضى عن ضوابطه وأن يُشكِّل الخطوط العريضة لملامحه، فيا تُرى من في المجتمع مسئول عن صياغة هذه الضوابط وتلك الملامح؟
إن كل أسرة على حدة بإمكانها صياغة الضوابط التي تسير وفقًا لها، سواء كانت تلك الضوابط نابعة من الدين وشرائعه، أو مُتوارَثة اجتماعيًّا وثقافيًّا، أو مُقلِّدة لكل ما هو حديث ومعاصر واستطاع أن يسود ويهيمن. وما دام كل مجتمع يتكون من عدة طبقات فمن الطبيعي ألا تنفصل الأسر عن الطبقة التي تنتمي إليها ثقافيًّا واجتماعيًّا وماديًّا. وفي هذا المسلسل تمت مناقشة قضية تحرر المرأة من خلال طبقة تفرض عليها ثقافتها وتعليمها المتأثران بالغرب تقليد الكثير من ثقافة دخيلة ولكنها متسلطة ومهيمنة بدرجات متفاوتة. فهناك من يشرب الخمور ومن يستبيح حرمة المرأة التي تسمح له بمعاشرتها دون زواج، وهناك أيضًا من ترفض شرب الخمور وتأبى أن تقيم أية علاقة مع الرجال خارج إطار الصداقة أو الزمالة القائمتين على الالتزام والاحتشام.
وبالتالي هناك دائمًا من يعرف متى يقول “لا” رافضًا ما لا يتناسب مع مبادئه وقناعاته وأخلاقه وضميره، وهناك أيضًا من ينجرف مع التيار الذي فرِض عليه الوجود فيه فلا يجد نفسه إلا مندفعًا مع التيار أينما ذهب. وطالما أن القدرة على البوح بكلمة “لا” لابد أن تكون مسبوقة بالحرية اللازمة للجهر بها علنًا، فإن من حُرِم من حريته ليس عليه سوى انتزاعها بالقوة قبل فوات الأوان. وهذا ما حدث مع بطلة مسلسل “ليه لأ؟!” التي قررت انتزاع حريتها بنفسها فلم ترفض فقط الزواج من شخص لا تحبه بل قررت أيضًا أن تعيش بمفردها معتمدة على نفسها ومكتشفة ذاتها رغم أنها قد تخطت الثلاثين من عمرها. وهنا لابد أن نتساءل عن الحدود الحقيقية والواقعية لحرية المرأة في المجتمعات الذكورية التي تستضعف المرأة ما دامت بلا رجل رغم أي إدعاء بالمساواة أو بالتحرر.
إنه ليس مطلوبًا أن يتجرأ الجميع معلنين رفضهم لكل ما لا يروق لهم لمجرد رغبتهم في مخالفة السائد أو الخروج عن المألوف، كما أنه ليس من الاستواء النفسي أن يخضع المرء ظاهريًّا أمام الناس لما يفرضه المجتمع من أطر وضوابط، بينما يخالفها في الخفاء بعيدًا عن الأعين بسبب جٌبنه عن الإعلان عن قناعاته وخوفه من مواجهة أي انتقاد أو توبيخ. وتجنبًا للوقوع في فخ تحدي الواقع بلا رؤية واضحة أو استعداد كاف لتبعات ذلك التحدي على كل إنسان متحرر أن يدرك أن الحرية ليست منحة والطريق المؤدي إليها ليس ممهدًا بل هو من أصعب الطرق التي من الممكن أن يسلكها الإنسان في حياته. وإذا كانت المجتمعات السوية هي بالقطع المجتمعات التي تتمتع بالحرية، فيا تُرى أي نوع من الحرية بإمكانه الارتقاء بالمجتمعات أخلاقيًّا فتنال الأنفس ما تستحقه من تزكية وإحياء؟
إنها الحرية التي لابد أن يسبقها إعداد كافٍ لتحمل تبعاتها ووعي ضروري بمتطلباتها، ومع ذلك فإن عدم الاستعداد لها ليس مبررًا لعدم الحصول عليها أو الحرمان من التمتع بها؛ بل إنه يجب أن يكون حافزًا لوجود الوعي اللازم بها وعدم الإبطاء في نيلها. فمن استطاعت أن تقول “لا” كان حماسها لإعلان رفضها لواقعها ورغبتها في تشكيله كيفما تشاء دافعًا لها كي تخوض مغامرة الاعتماد على نفسها ربما دون استعداد كافٍ لذلك، ومن ثم كان لابد أن تصطدم بعقبات في طريقها ربما تحول بينها وبين غايتها الأساسية وهي الحرية، ولكن أحيانًا لا يملك الإنسان الراغب في اقتناص حريته سوى المخاطرة باندفاع خوفًا من ضياع حماسه ومن ثم فقدان الفرصة للتحرر.
وإذا كان هذا النوع من المخاطرة يكون له عواقبه السيئة حال فشله مما قد يدفع بعض المتحررين إلى العودة لنقطة البداية وكأن شيئًا لم يكن، فإن ذلك إن كان متقبلًا على المستوى الفردي، فإن الفشل على المستوى الجماعي في أية مخاطرة من أجل الحرية لن يمر دون خسائر فادحة وحتمًا سيؤدي إلى أسْر مضاعَف وخضوع أكبر.
لذلك فإن المجتمعات العازمة على التحرر الحقيقي إذا لم تعِ ما هي مقبلة عليه قبل الإقبال على أية خطوة في سبيله وإذا لم تستعد استعدادًا كافيًا له، فإنها ستظل في منأى عن غايتها مهما تعددت محاولاتها للتحرر غير المدروس. ولهذا فإن مجتمعاتنا التي نجح الغرب في غزوها ثقافيًّا واجتماعيًّا وسياسيًّا حتى تحولت إلى مسوخ ونُسخ لا تجيد سوى التقليد فلم يعد يُقدِّرها أحد، لن تتمكن من استعادة شخصيتها الأصيلة التي تميزها إلا إذا عزمت على التفرد والتميز واستعدت للقيادة وتخلت عن التقليد الأعمى والانقياد للأقوى باستسلام تام ودون تفكير. وهذا العزم المجتمعي لن يؤثر على قرار السلطة الحاكمة طالما تم تقييد حرية الشعوب فلم تعد لديها القدرة على المعارضة أو الاحتجاج السلمي أو حتى على محاسبة أي مسئول قصَّر في أداء مهمته .
وإلى أن ينجح ذلك التحررعلى المستوى المجتمعي، فإنه على كل متحمس للتحرر الفردي أن يحدد بوعي هدفه من نيل حريته، ثم يستعد جيدًا للتضحية في سبيلها؛ فالحرية الحقيقية ليست في نبذ قيود المجتمع البالية من أجل الارتماء في أحضان قشور ثقافة مجتمعية دخيلة ومهجنة ورونقها الظاهري قائم فقط على حداثتها وعصريتها وهيمنتها وليس على جوهرها أو قيمتها، ولكن الحرية الحقيقية تعني الوعي بمعناها، والقدرة على الاختيار بعد تفكير، والرغبة في التحرر من سيطرة كل ما هو متسلط وسائد بالقوة أو تحت ضغط كي يكون الحُكم عليه موضوعيًّا.
وبالرغم من أن التحرر الفردي من سلطة الثقافة العالمية المفروضة – بتسلط شديد -والمهيمنة على العالم برضوخ تام منه لن يغير من حال المجتمعات إلا إنه سيشبع على المستوى الفردي رغبة كل متحرر في إثبات هويته الإنسانية، مما يجعله قادرًا على الوصول للمعنى من حياته والذي به يحقق ذاته فيكون لوجوده قيمة.
لذلك على الأسر في مجتمعاتنا أن تبادر بمنح الحرية لأبنائها كي يدركوا منذ صغرهم معنى الحرية المسئولة، وكي تكون لديهم القدرة على التمييز بين ما هو أصيل وما هو دخيل فيقررون أية هوية يريدونها لأنفسهم وأية غاية سيسعون لها، فلا يعتادون أن يختار لهم الآخرون طريقهم في الحياة بل يألفون أن تكون أهدافهم نابعة من داخلهم.