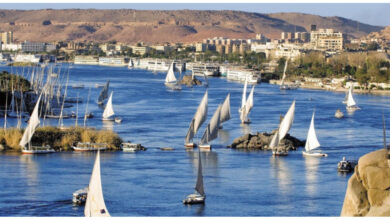في إحدى الأساطير الهوليودية، تتعقب فتاة في مقتبل العمر خيطا دقيقا تلقته عندما كانت تستعرض صورا لعدد من الكوارث الكبرى التي حاقت بالبشرية؛ لتكتشف – رغم تباعد الزمن- أن وجُوهًا بعينها كانت حاضرة في كل المشاهد تقريبا، ما جعلها تواصل البحث عن هؤلاء الذين أصابتهم تلك اللعنة الأبدية؛ ليصيروا شهودا على كل تلك المآسي الرهيبة عبر التاريخ الإنساني، ومع تعاقب الأحداث تكتشف الفتاة المسكينة وجهها ضمن هذه الوجوه الملعونة إلى الأبد، وتكتشف أيضا أن البداية كانت لحظة حادثة الصلب في الجلجثة؛ حيث كان هؤلاء الملعونون يقفون للمشاهدة البليدة دون أن يطرف لهم جفن، لا يبالون إلا بالترقب الحذر لما تجري به الأمور، وربما كان وجودهم في الموقف الدامي، بقصد التلهي والاستمتاع لا أكثر.
في تاريخنا الإسلامي من السهل جدا أن نحصي عددا من المشاهد الأليمة التي كانت محصلتها ضياع أغلب مكتسبات أمة العرب من الدعوة المُحمدية، التي كانت – وفق العديد من الآراء المنصفة- إحدى أهم وأكبر الثورات الاجتماعية في التاريخ.. ثم كان أن وُسِّدَ الأمر إلى غير أهله – حسب التعبير النبوي- لتصير الأمور بين أيدي أصحاب الأهواء والبارعين في فنون المؤامرة، وجامعي الغنائم والغَلُول.. دون سواهم!
في الحراك الشعبي الواسع الذي عمّ أرجاء مصر قبل اثني عشرة سنة، تصدرت وجوهٌ بعينها عددا كبيرا من المشاهد؛ رافعة المصاحف أمام الكاميرات، ما كان يعني أنهم لا يرضون بحكم الله بديلا؛ بينما كان دعاتهم المتحمسون بعصبية مُنَفّرة يُغطّون شاشات التلفزة بصراخهم الذي حمل من شائن الأفكار وساذجها، ما انتهى بأحدهم إلى القول بجرأة لا يحسد عليها “أن الليبرالية تعني أن لا ترتدي أمك الحجاب”!
وإلى وقائع صفين التي امتدت لثلاثة أشهر بين العامين السادس والثلاثين والسابع والثلاثين من الهجرة النبوية المشرفة- نعود علَّنا نهتدي إلى حقيقة هذا الصراع الذي صار ممتدًا بامتداد الزمان؛ لتقف خلفه كل دعاوى الفرقة والتشرذم، وشق صف الأمة، يضل به كل من تدثر بعباءة الدين طلبا للدنيا، وكل من أراد منازعة الأمر أهله لأمر في نفسه، لا يعلنه ولا يرفع له راية، بل يرفع المصحف عوضا عن ذلك؛ زاعما أنه ما حاد عن منهج الحق، وأن طُلبته العدل والقصاص، وأن يجعل القرآن الكريم حكما فيما شجر من خلاف.
تقول الرواية أنه لما أيقن قادة جيش الشام أن الهزيمة في جانبهم على الأغلب، رأوا أن عليهم تعطيل نصر جند العراق على أي نحوٍ كان.. ليتسنى لهم التفاوض على هدنة؛ على أمل حسم الصراع في جولة جديدة.
رفع جند الشام المصاحف على أسنة الرماح، طالبين وقف القتال والاحتكام إلى كتاب الله لحسم الخلاف.. تبين بعد ذلك أن تلك الوسيلة التكتيكية كانت من تدبير معاوية حيث قال للأشعث بن سعد، رسول الإمام علي: “إليه نرجع -نحن وأنتم- إلى ما أمر الله في كتابه، تبعثون منكم رجلا ترضونه ونبعث منا رجلا، ثم نأخذ عليهما أن يعملا بما في كتاب الله”.
لا يشك شاك الآن أن الأمر انطوى على خدعة من بدايته إلى نهايته، وأنه كان فصلا من فصول الفتنة التي عصفت بدولة الإسلام في مرحلة مفصلية من تاريخها.. تلك الفتنة التي امتدت آثارها إلى يومنا هذا.
يذكر ابن كثير في البداية والنهاية أنه قُتل من أنصار معاوية 45 ألفاً مقابل 25 ألفاً من أنصار الإمام علي، وكان ضمن من قُتل في معركة صفين الصحابي الجليل عمار بن ياسر وكان في صف الإمام علي، وكان الجند في كلا الجانبين يعرفون حديث رسول الله- صلى الله عليه وسلم-” ويح عمار تقتله الفئة الباغية، عمار يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى النار “، فكان لاستشهاده- رضي الله عنه- فعل السحر في نفوس جند جيش الإمام علي، وفعل الإضعاف والتنازع في جيش الشام، على ما جاء في الروايات التي لا يقطع بصحتها، فكون عمار كان ضمن جيش الإمام علي، أدعى لمراجعة الموقف، قبل مقتله وقبل انكشاف أمر الفئة الباغية على إمام الحق.
تخرج الفتنة من جيش الشام لتسري كالنار في صفوف جيش الإمام بين مُصِرٍ على الاستمرار في القتال حتى تحقيق النصر الذي بات وشيكًا، وقابل للاحتكام لكتاب الله أملا في توحيد الصف من جديد، وساع بالفتنة من أعوان جيش الشام المنتشرين في جيش العراق.
أثمرت فتنة المصاحف خدعة التحكيم التي آلت إلى إعلان الهدنة ونجاة جيش الشام من هزيمة ماحقة؛ مخلفة في جيش العراق سرطانًا قاتلا عرف وقتها بالخوارج؛ يذكر ابن كثير أنه لما رجع الإمام علي مع جيشه إلى الكوفة وبقى هناك ينتظر انقضاء سنة كاملة مدة الهدنة بينه وبين معاوية، كي يتمكن من بدء جولة جديدة للقضاء على التمرد في الشام وتوحيد الدولة الإسلامية- أن الخوارج استمروا في الضغط والتهديد لمواصلة قتال معاوية، ولما لم يلتفت الإمام علي لرغبتهم كفَّروه، ثم أعلنوا الحرب عليه، فدارت معركة النهروان التي هُزِم فيها الخوارج وتفرقوا إلى حين.
ثم كان ما كان من أمر معاوية وابن العاص بإثارة القلاقل والاضطرابات وإرسال عصابات للسلب والنهب في البلاد الواقعة تحت حكم الإمام، مثل ما حدث في الأنبار، وفي اليمن على يد (بسر بن أرطأة) الذي تحدث بجرائمه الركبان… إلى أن انتهى الأمر بمقتل الإمام علي كرم الله وجهه على يد الخارجي (ابن ملجم) ، واستتب الأمر لأهل المكر والحيلة.
إن وقائع التاريخ تعرض نفسها علينا بين الحين والآخر علنا نعتبر ولا نكررها بنفس الطريقة الحمقاء مما يثير العجب، ولا غرو فنحن أمة نموت حاضرًا؛ لنعيش في أوهام الماضي.. ليس إلا.
لم يكن رفع المصاحب في مختلف المواقف التي شهدت هذا الفعل؛ إلا تفريغا للحظة من زخم حقيقتها، وخصوصية ظرفها التاريخي، وإحالتها إلى حالة سيولة هائلة لا يستطيع عاقل مجابهتها بما تستحق، لأنها باطل محض يرتدي ثوب الحقيقة السابغ الذي لا قوة لأحد على إنكاره.
لقد رأي الإمام علي مآلات الموقف، وعرف أنه لعب بالنار لا يحسمه إلا المغرض صاحب الهوى، وهو قد نأى بنفسه عن ذلك كل النأي، ولو أراد مكرا ما وسع أحد مجاراته.. فكان ما كان من أمر المتغلبين يومها وإلى يوم الناس.
إن عبرة التاريخ تلهمنا اليوم أن نتبين ما وراء الظواهر، لنحاكمها إلى ثوابتنا دون مواربة؛ حتى لا يسلمنا الخطل المتواصل في الوسائط الإعلامية إلى الذهول التام عما ينبغي اتخاذه من مواقف؛ لنصير مندفعين نحو اختيار الأسوأ دائما، أو لنرضى بأن نكون مسلوبي الإرادة لا نبالي بما يجري لنا، ولو كان من باب التسليم بالقضاء والقدر.