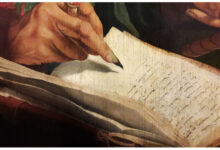في غمرة الأحداث التي تعصف بالمنطقة، وتوشك أن تتحول إلى حربٍ واسعة متعددة الأطراف، في ظل إجرام وحشي غير مسبوق من جيش الاحتلال الصهيوني، بحق الشعب الفلسطيني في غزة الصامدة التي تتصاغر إلى جانب صمودها كل بطولات المدن عبر التاريخ- أطل علينا خبر إنشاء مركز “تكوين” بوصفه مؤسسة تهتم بالفكر والتنوير.. لكن الوجوه الحاضرة، وما عُرف عنها من سوابق اعتبرها البعض تشكيكا في ثوابت الدين، إلى جانب ملابسات أخرى- أثارت ردود فعل سلبية إزاء الأمر برمته.. تطورت سريعا إلى بلاغات للنائب العام وتحركات برلمانية تهدف إلى غلق المركز ومساءلة القائمين عليه.. في المقابل دعا بعض المحسوبين على التيار السلفي وآخرين إلى إطلاق مؤسسة فكرية تحت اسم “تحصين” لمواجهة مؤسسة “تكوين” وما يصدر عنها من دعاوى ومناقشات تستهدف صحيح الدين حسب ما أعلن.
وربما تحمل الأيام القليلة القادمة تطورات متسارعة للمشهد الذي يرى البعض أنه محض افتعال وإلهاء في وقت عصيب تمر به الأمة؛ يحتاج إلى تضافر كل الجهود لمواجهة العدو الصهيوني وأذنابه.

لكن الأمر قديم جدا بخصوص تلك المواجهات أو ما يشبهها ويختلف عنها في كثير من الجوانب، ونحن لا نستطيع على وجه الدقة أن نُحددَ متى ظهر إلى الوجود ذلك الصنف من الناس الذين جعلوا دين الله سلعة يتربحون بها على كلا الجانبين.. حيث آل فريق منهم على أنفسهم أن يقفوا دون سبيل العلم الذي ارتضاه الله لعباده؛ شاهرين أمام الوجوه سيف التكفير، لا تتبدل لديهم حجج وأد الأفكار ونحر الباحثين عن الحقيقة، وفريق آخر يعمل معول الهدم دون أي محاولة للبناء فيثير الريب في النفوس.
أليس من الغريب أن نراهم حاضرين بقوة حتى في العصر الذي نُعت بأنَّه عصر التنوير العربي الذي بدأ أوائل القرن الثالث الهجري، وكان أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن الصباح الكندي (185 – 256 هـ), مؤسس الفلسفة العربية الإسلامية، هو أول من تصدى لهم وأظهر حقيقة كذبهم وبطلان دعواهم.
يُعرّف الدكتور عبد الرحمن بدوي في الجزء الأول من موسوعة الحضارة العربية الإسلامية الكِندي بقوله: “كان الكندي أول فيلسوف عربي وأول فيلسوف مسلم بوجه عام. وكان أول من مزج بين الفكر اليوناني والفكر الديني الإسلامي. وكان واسع الثقافة، بحيث شملت معرفته كل علوم الأوائل، ولا نكاد نجد بين رجال النهضة في أوربا من يساويه في اتساع المعرفة والتحصيل الفلسفي العلمي”.

يقول الكندي في مقدمة رسالته إلى الخليفة العباسي المعتصم والتي عنونها بـ”الفلسفة الأولى” مبديًا حذره من: “سوء تأويل كثير من المُتَسَمِّين بالنظر في دهرنا من أهل الغربة عن الحق، وإن تتوجوا بتيجان الحق من غير استحقاق؛ لضيق فطنتهم عن أساليب الحق، وقلة معرفتهم بما يستحق ذو الجلالة في الرأي والاجتهاد في الأنفاع العامة الكل، الشاملة لهم، ولدرانة الحسد المتمكن من أنفسهم البهيمية والحاجب بسدف سجوفه أبصار فكرهم عن نور الحق ووضعهم ذوي الفضائل الإنسانية – التي قصروا عن نيلها وكانوا منها في الأطراف الشاسعة – لموضع الأعداء الحربية الواترة، ذبًا عن كراسيهم المزورة التي نصبوها عن غير استحقاق بل للترؤس والتجارة بالدين، وهم عُدَمَاء الدين، لأنَّ من تجر بشيء باعه، ومن باع شيئًا لم يكن له، فمن تجر بالدين لم يكن له، ويحق أن يتعرى من الدين من عاند قُنية علم الأشياء بحقائقها وسماها كفراً”.
والرسالة توضح أن الخلاف مفتعل ومُدّعى وأنه من أجل المكاسب والمناصب، وهذا ما نراه اليوم في كثير ممن يزعمون التنوير وينبشون التراث، وهم لا يستطيعون قراءة سطر واحد على نحو صحيح.. بينما يرى الفريق الآخر نفسه حامي حمى الدين والذَّاب عن حياضه دون بقية الأمة؛ دون أهلية حقيقية أو تفويض من أحد.
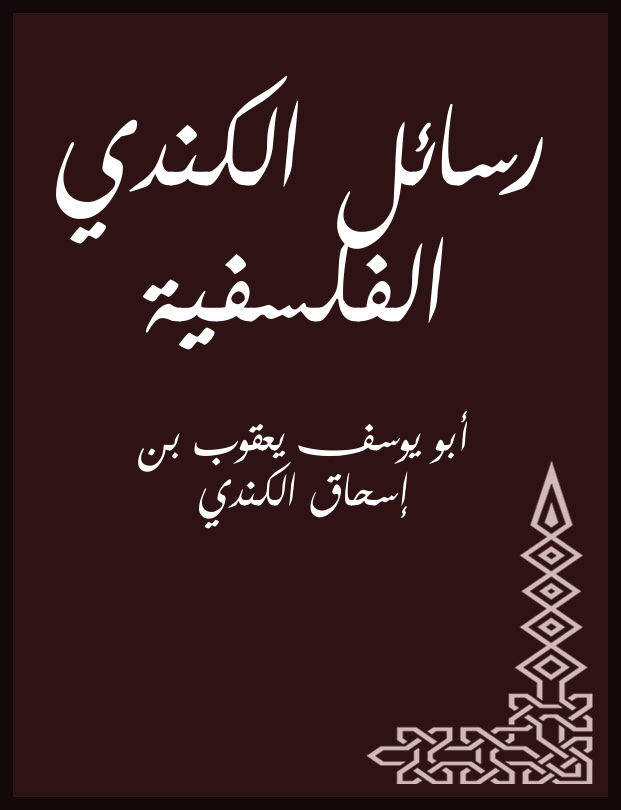
لقد بدأ الكندي مشروعه الفلسفي بدحض دعاوى الفقهاء ورجال السلطة الذين التقوا- وكثيرا ما يلتقون- على فريتين أساسيتين أولاهما: أنَّ الفلسفة اليونانية هي من العلوم الوثنية التي حرَّم الإسلام الاشتغال بها، وثانيتهما: أنَّها وافدة غير أصيلة، ما يجعلها ألحقُ ضررًا بالمجتمع الإسلامي وثوابته وبنيته الفكرية.. وقد تطلّب ذلك من الكندي جرأة وثباتا لا بد أن نعزو إليهما كل فضل في نشأة التفلسف العربي الذي ناضل في سبيله، وفتح له من الأبواب ما كان موصدا بعقول لها صدأ الأقفال!
أراد الكندي أن يثبت أنه لا تعارض بين الفلسفة والدين منطلقًا من المقولة الذائعة أنَّ “الحكمة ضالة المؤمن أنَّى وجدها، فهو أحق النَّاس بها” ويقول الكندي في ذلك: “إنَّ أعلى الصناعات الإنسانية منزلةً، وأشرفها مرتبةً صناعة الفلسفة التي حدها: علم الأشياء بحقائقها بقدر طاقة الإنسان؛ لأنَّ غرض الفيلسوف في علمه إصابة الحق، وفي عمله العمل بالحق، لا الفعل سرمدا، لأنَّا نمسك وينصرم الفعل إذا انتهينا إلى الحق. ولسنا نجد مطلوباتنا من الحق من غير علة، وعلة وجود كل شيء وثباته الحق: لأنَّ كل ما له أنية له حقيقة، فالحق اضطرارا موجود، إذن الأنيات موجودة. وأشرف الفلسفة وأعلاها مرتبة الفلسفة الأولى: أعني علم الحق الأول الذي هو علة كل حق”.
إنَّ أكثر ما يثير العجب في أمر الكندي وحربه الأولى في سبيل الحق والعلم وإفساح المجال للعقل العربي أن ينهل من معين الفلسفة التي يُرجع إليها الفضل في معرفة الحقيقة الأولى التي هي أصل أو سبب كل حقيقة- أنَّنا عندما ننظر إلى حالنا اليوم نشعر وكأنَّنا لم نبارح الكندي وعصره، ما بين التبجح بالجهل ومحاولات التشكيك وسيوف التكفير المشهرة، ودعاوى الحسبة القائمة، والتفتيش في العقول والنوايا الذي يجري على قدم وساق، ومادامت العقائد ما زالت مظنة الهدم، فلابد لها من حماة ومنافحين يتصدون لأصحاب الرؤى من أولي النهى ومن الأدعياء أيضا!
أمر آخر أثاره الكندي في معرض دفاعه عن الفلسفة، وما زال حاضرًا بقوة في واقعنا المأزوم، ألا وهو إنسانية المعرفة، والتلاقي بين ثقافات الأمم على أساس من التلاقح الفكري، وما زال الفريق ذاته يدافع عن خصوصية مدَّعاة خشية ذوبان في ثقافة الآخر جرَّاء تلك الغارات المتلاحقة من جيوش الغزو الفكري التي لا تكل ولا تمل… ثم حدثني بعد ذلك عما نعانيه من تخلف تام وعن أسبابه الموضوعية!
لقد استطاع الكندي خلال تلك الفترة أن يؤسس للفلسفة ما يمكن تسميته بالشرعية الدينية فلقد كان الكندي أول من تكلم من فلاسفة الإسلام، في مسألة التوفيق بين الحكمة والشريعة. ويقول بهذا الخصوص: “ويحق أن يتعرى من الدين، من عاند كنه علم الأشياء بحقائقها وسماها كفرا. لأن في علم الأشياء بحقائقها علم الربوبية، وعلم الوحدانية، وعلم الفضيلة.
كما ذهب إلى موافقة ما جاء به الرسل لحقائق الفلسفة فيقول: “جملة كل علم نافع والسبيل إليه، والبعد عن كل ضار والاحتراس منه. واقتناء هذه جميعا، هو الذي أتت به الرسل الصادقة، صلوات الله عليها، فإنما أتت بالإقرار بربوبية الله وحده، وبلزوم الفضائل المرتضاة عنه، وترك الرذائل المضادة للفضائل في ذواتها وإيثارها”.
وفي اكتساب الفلسفة ووجوب ذلك من عدمه يقول: “يجب أو لا يجب؟ فإن قالوا يجب، وجب عليهم طلبها. وإن قالوا لا يجب، وجب عليهم أن يحصروا علة ذلك، ويعطوا على ذلك برهانًا. وإعطاء العلة والبرهان من “قنية” علم الأشياء بحقائقها. فواجب إذن طلب هذه “القنية” بألسنتهم، والتمسك بها اضطرار عليهم”.
كما استطاع أن يؤسس للغة فلسفية وعقلانية عربية لأول مرة في تاريخنا العربي؛ لذلك فمن الحق أن نقول أنَّ فضله غير منكور على كل من جاء بعده من الفلاسفة العرب بدءا من الفارابي ونهاية بابن رشد مرورًا بالشيخ الرئيس.
كما يُمثّل الكندي في علاقته بالسلطة بعدًا آخر لأزمة المثقف العربي، الذي وإن بدأ مسيره بالقرب من السلطة أو قل في كنفها، فإن ذلك لا يمنع أن تريه تلك السلطة وجهها الآخر لأيما سبب ، فلقد عاصر الكندي ثلاثة من خلفاء بني العباس ومما يذكر بشأنه، أنه كان عظيم الشأن والمنزلة عند الخليفة المأمون، وأخيه المعتصم من بعده، الذي وكله بتأديب ابنه أحمد، ثم جاء المتوكل الذي انقلب على الفلسفة وانضم لمعسكر أعدائها في المرحلة الثانية من حكمه، وكانت آراء الكندي الفلسفية قد شكلت إزعاجا للمتوكل بفعل وشايات حاسديه، فما كان منه إلا أن أمر بمصادرة كتب الكندي ومخطوطاته، إلا أنَّها أعيدت إليه لاحقًا.
لقد كان الكندي صاحب منهج أصيل في جميع ما كتب فيه من سائر العلوم، ولقد أحصيت مؤلفاته فبلغت مئتين وثمانين مُؤلفا، فُقِد معظمها ولم يصل لنا منها إلا القليل؛ لكن منهجه الذي أرساه ظل راسخا يأبى البدد ويستعصي على النسيان، لأنه منهج يقوم على الصدق والتجرد للحق لا لسواه، وهذا هو سبيله الذي ارتضاه فيقول: “فنحن نسأل المطلع على سرائرنا، والعالم اجتهادنا، في تثبيت الحجة على ربوبيته، وإيضاح وحدانيته، وذب المعادين له، والكافرين به عن ذلك بالحجج القامعة لكفرهم، والهاتكة لسجوف فضائحهم، والمخبرة عن عورات نحلهم المردية، وأن يحوطنا ومن سلك سبيلنا بحصن عزه الذي لا يرام، وأن يلبسنا سرابيل جنته الواقية، ويهب لنا نصرة غروب أسلحته النافذة والتأييد بعز قوته العالية حتى يبلغنا بذلك نهاية نيتنا من نصرة الحق وتأييد الصدق، ويبلغنا بذلك درجة من ارتضى نيته وقبل فعله، ووهب له الفلج والظفر على أضداده الكافرين نعمته، والعائدين عن سبيل الحق المرتضاة عنده”.
فلا تكوين ولا تحصين قبل الارتواء من الينابيع الصافية للدين الحنيف وما أكثرها.. ومن اجتهاد المجتهدين المعتبرين وما أكثرهم على امتداد تاريخنا الإسلامي.. أما تلك السجالات الفارغة؛ فيعرف مبتغاها القاصي والداني.. ولا تُنقص أو تُضيف شيئا ذا بال، ولا سبيل للانتفاع منها على أي وجه.. والتصدي لها عمل مؤسسي يجب أن تنهض به الجهات المنوط بها ذلك.. وإلا فهي فوضى نسأل الله منها السلامة.