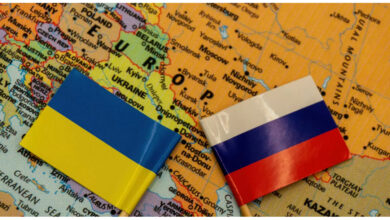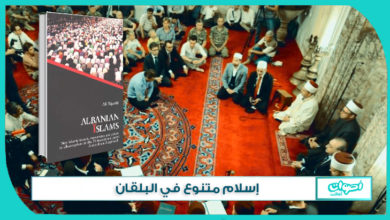استكمالا للحديث حول دلالات كل من “ٱلۡمَعۡرُوفِ” و”ٱلۡمُنكَرِ”، في آيات التنزيل الحكيم، نؤكد بإنه إذا كان “ٱلۡمَعۡرُوفِ” هو ما عرفه الناس ثم تعارفوا عليه، فأصبح مألوفا للذوق والقبول الاجتماعي، أي إنه بهذا المفهوم له معنى إيجابي؛ فإن “ٱلۡمُنكَرِ”، قياسا إلى ذلك، هو ما نكره الناس ثم استنكروه اجتماعيا، فأصبح مُستهجنا غير مألوف للذوق الاجتماعي؛ وذلك، مثل ما يؤشر إليه لفظ “أَنكَرَ”، في قوله تبارك وتعالى: “وَٱقۡصِدۡ فِي مَشۡيِكَ وَٱغۡضُضۡ مِن صَوۡتِكَۚ إِنَّ أَنكَرَ ٱلۡأَصۡوَٰتِ لَصَوۡتُ ٱلۡحَمِيرِ” [لقمان: 19].
بهذا، يحمل مصطلح “ٱلۡمُنكَرِ” دلالة الإنكار والاستنكار؛ بمعنى أن له جانب إيجابي يتمحور حول الاستنكار، أي ما نكره الناس ثم استنكروه اجتماعيا؛ وفي الوقت نفسه له جانب سلبي يتعلق بالإنكار، أي “إنكار الشيء وتجاهله عن سابق معرفة به”، كما في قوله سبحانه: “وَيُرِيكُمۡ ءَايَٰتِهِۦ فَأَيَّ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ” [غافر: 81]؛ حيث إن “تُنكِرُونَ” هنا تدل على “تجاهل الحقيقة”.
بيد أن ما نود التشديد عليه، هو وجوب التفرقة بين الأعراف، أي المتعارف عليه بين الناس في مكان محدد في مرحلة تاريخية معينة، وبين حدود الله سبحانه وتعالى. إذ إن التنزيل الحكيم يتبدى فيه بوضوح، الفصل بين “ٱلۡمَعۡرُوفِ” وبين “ٱلۡمُنكَرِ” وبين “حُدُودِ ٱللَّهِۗ”، وذلك كما في قوله تبارك وتعالى: “ٱلۡأٓمِرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡحَٰفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِۗ” [التوبة: 112].
أمر آخر يجب التشديد عليه، بناءً على السياق القرءاني في هذه الآية الكريمة؛ إنها الصفات “التسع” التي وردت فيها: “ٱلتَّٰٓئِبُونَ ٱلۡعَٰبِدُونَ ٱلۡحَٰمِدُونَ ٱلسَّٰٓئِحُونَ ٱلرَّٰكِعُونَ ٱلسَّٰجِدُونَ ٱلۡأٓمِرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡحَٰفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِۗ وَبَشِّرِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ” [التوبة: 112]؛ وهي الصفات التي وردت في فئة مُحددة من الناس، ذكرتها الآية السابقة مُباشرة، نعني قوله سبحانه وتعالى: “إِنَّ ٱللَّهَ ٱشۡتَرَىٰ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ أَنفُسَهُمۡ وَأَمۡوَٰلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلۡجَنَّةَۚ…” [التوبة: 111].
وبالتالي، فإن هذه الصفات “التسع” هي صفات المؤمنين، أي صفات أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ولكن، قد يقول قائل: فماذا عن خاتمة الآية “وَبَشِّرِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ”؟
ومن الواضح أن “وَبَشِّرِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ” هي مسألة مستقبلية تدل على الخبر السار، بالنسبة إلى هؤلاء الذين يسلكون سلوكا مُطابقا لما اعتقدوه من اليقين والإيمان؛ بمعنى إنها البشرى التي تختص بوعد الله تبارك وتعالى “إِنَّ ٱللَّهَ ٱشۡتَرَىٰ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ أَنفُسَهُمۡ وَأَمۡوَٰلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلۡجَنَّةَۚ…”.
ومن هنا، يأتي التحديد القرءاني لهؤلاء “ٱلۡمُؤۡمِنِينَ”، بأن من بين صفاتهم “ٱلۡأٓمِرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡحَٰفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِۗ”. ولنا أن نُلاحظ أن هذه الصفات “الثلاث” هي وحدها التي وردت في حال “العطف” على بعضها البعض، ضمن الصفات التي ذكرتها الآية. هذا، إضافة إلى أنها ضمن حيثية تخص الأمة المحمدية، وذلك لتكون “خَيۡرَ أُمَّةٍ أُخۡرِجَتۡ لِلنَّاسِ” [آل عمران: 110].
يعني هذا في ما يعنيه، أن الأمر “بِٱلۡمَعۡرُوفِ” والنهي “عَنِ ٱلۡمُنكَرِ”، هو فعل متعدٍ من النفس إلى الغير، بعد أن تكون النفس قد استوفت حظها منه؛ لأن النفس عندما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فلابد أن تكون هي ذاتها فاعلة لهذا المعروف، وتكون بمنأى عن هذا المنكر.
كما يعني أيضا أن هناك صفة ثالثة تتكامل مع الأمر “بِٱلۡمَعۡرُوفِ” والنهي “عَنِ ٱلۡمُنكَرِ”، هي الحفظ “لِحُدُودِ ٱللَّهِۗ”؛ تلك الحدود التي يأتي الأمر الإلهي بشأنها على حالتين في التنزيل الحكيم: الأولى، هي الخاصة بالمحافظة على الأوامر الإلهية، أي تلك التي يردفها سبحانه بقوله: “تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ” [البقرة: 229]؛ والأخرى، هي المتعلقة بالبعد عن ما نهى الله عنه، أي تلك التي لا تقف عند “فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ”، ولكن تصل إلى “فَلَا تَقۡرَبُوهَاۗ”، في قوله تعالى: “تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقۡرَبُوهَاۗ” [البقرة: 187].
ولأن هذه الصفات “الثلاث” ضمن الصفات “التسع” الواردة في آية سورة التوبة [التوبة: 112] هي حيثية تخص أمة محمد، أو “ٱلۡمُؤۡمِنِينَ”؛ لذا اختص التنزيل الحكيم وصف هذه الأمة بكونها “خَيۡرَ أُمَّةٍ أُخۡرِجَتۡ لِلنَّاسِ” [آل عمران: 110].. لماذا؟
لعل الإجابة عن هذا التساؤل، نجدها في قوله عزَّ من قائل: “كُنتُمۡ خَيۡرَ أُمَّةٍ أُخۡرِجَتۡ لِلنَّاسِ تَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَتَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَتُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِۗ وَلَوۡ ءَامَنَ أَهۡلُ ٱلۡكِتَٰبِ لَكَانَ خَيۡرٗا لَّهُمۚ مِّنۡهُمُ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ وَأَكۡثَرُهُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ” [آل عمران: 110]؛ بمعنى أن “ثلاثة” عوامل تجعل من أمة محمد، أو “ٱلۡمُؤۡمِنِينَ” به وبرسالته “خَيۡرَ أُمَّةٍ”؛ هي: الأمر “بِٱلۡمَعۡرُوفِ” والنهي “عَنِ ٱلۡمُنكَرِ”، والإيمان “بِٱللَّهِۗ”.
بيد أن المُلاحظة التي نود أن نسوق، أنها ليست “خَيۡرَ أُمَّةٍ” على وجه العموم؛ ولكنها مشروطة، إضافة إلى العوامل “الثلاثة” السابقة، بعامل أهم، هو: “أُخۡرِجَتۡ لِلنَّاسِ”. بهذا جعلها الله سبحانه وتعالى ـ و”الجعل” هو “تغيير في الصيرورة باتجاه التطور”، أي: تحول زائد إضافة ـ ليس فقط “أُمَّةٗ وَسَطٗا”؛ بل “خَيۡرَ أُمَّةٍ أُخۡرِجَتۡ لِلنَّاسِ”.
عن “أُمَّةٗ وَسَطٗا”، يقول سبحانه: “وَكَذَٰلِكَ جَعَلۡنَٰكُمۡ أُمَّةٗ وَسَطٗا لِّتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيۡكُمۡ شَهِيدٗاۗ…﴾” [البقرة: 143].. وعن “خَيۡرَ أُمَّةٍ”، يقول تعالى: “كُنتُمۡ خَيۡرَ أُمَّةٍ أُخۡرِجَتۡ لِلنَّاسِ تَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَتَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَتُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِۗ وَلَوۡ ءَامَنَ أَهۡلُ ٱلۡكِتَٰبِ لَكَانَ خَيۡرٗا لَّهُمۚ مِّنۡهُمُ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ وَأَكۡثَرُهُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ” [آل عمران: 110]. ومن ثم، يبدو بوضوح الارتباط بين “خيرية الأمة” وبين “الخروج للناس”.
في هذا الإطار، تتبدى الكيفية التي ركز بها القرءان الكريم على أهم سمات الأمة العربية الإسلامية، بكونها “أمة دعوة” مهمتها الخروج إلى الناس، حيث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله؛ وذلك خلافا للتجربة اليهودية، كمثال، التي كانت تعتمد على دخول الأرض المقدسة والتوطن فيها، كما يتضح من قوله تعالى: ﴿يَٰقَوۡمِ ٱدۡخُلُواْ ٱلۡأَرۡضَ ٱلۡمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمۡ وَلَا تَرۡتَدُّواْ عَلَىٰٓ أَدۡبَارِكُمۡ فَتَنقَلِبُواْ خَٰسِرِينَ﴾ [المائدة: 21].
ومن ثم، جعل الله سبحانه وتعالى لكل منهما، ومعهما أهل الإنجيل، “شرعة ومنهاجًا”. يقول سبحانه: ﴿… لِكُلّٖ جَعَلۡنَا مِنكُمۡ شِرۡعَةٗ وَمِنۡهَاجٗاۚ وَلَوۡ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمۡ أُمَّةٗ وَٰحِدَةٗ وَلَٰكِن لِّيَبۡلُوَكُمۡ فِي مَآ ءَاتَىٰكُمۡۖ…﴾ [المائدة: 48].
وللحديث بقية.