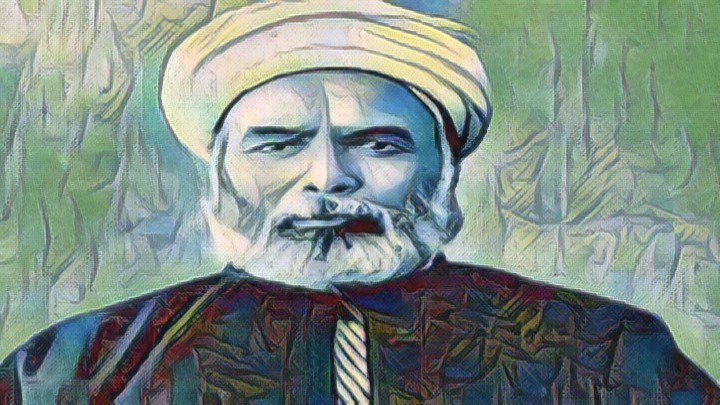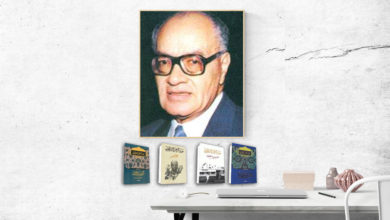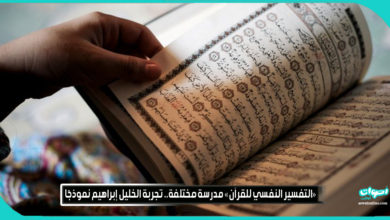في إثباته الطابع المدني للسلطة في الإسلام ينطلق الإمام محمَّد عبده- فيما يتعلق برؤيته لطبيعة «السُّلطة الدِّينية في الإسلام»- من منطلقات فكريةٍ وعقائديةٍ رئيسة، في مقدمتها: أنَّ الإسلام دينٌ وشريعةٌ، لكنَّه لا يعرف «السُّلطة الدِّينية» ولا «الكهنوت»، فالحاكم في المجتمع الإسلامي «هو حاكم مدني من جميع الوجوه»، وأن اختياره وعزله إنما هما أمران خاضعان لرأي الأمة وليس لِحقٍّ إلهيٍّ يتمتع به هذا الحاكم بحكم الإيمان. فالأمة، أو نائب الأمة، هو الذي ينصبه، والأمة هي صاحبة الحق في السيطرة عليه، وهي التي تخلعه متى رأت ذلك من مصلحتها.
كما أكد الإمام أيضا أن الإسلام كما لم يجعل للخليفة سلطانا دينيا، لم يجعل للقاضي أو المفتي أو شيخ الإسلام أدنى سلطة دينية على العقائد وتقرير الأحكام. «وكل سلطة تناولها واحد من هؤلاء، فهي سلطة مدنية قررها الشَّرع الإسلامي، ولا يسوغ لواحد منهم أن يدَّعي حق السيطرة على إيمان أحد أو عبادته لربه، أو ينازعه في طريق نظره». وحجته في ذلك أنَّ ما يُمثِّلُه الإسلامُ من رابطة اعتقادية وأدبية وروحية تجمع كلَّ المسلمين، لا يمنع من تأسيس الولايات السياسية على أُسُس قوميةٍ ووطنيةٍ في إطار هذا المحيط الإسلاميِّ الكبير. لكن الجمع بين السلطتين: الدينية والسياسية يعد على العكس من ذلك أصلا من أصول المسيحية. ففي مشاهداته التي دونها أثناء رحلته إلى صقلية، يحكي الإمام: «رأيت بيتًا من بيوت القصر فيه صور نواب المَلِك، وكان النائب عن المَلِك يصحبه كاردينال يرجع إليه في أمور دينه وفي أعماله السياسية، أيام كانت الأحكام المدنية والسياسية مما يدخل فيه رجال الدين، كما نقول عندنا المفتي أو شيخ الإسلام في عهد الملوك الذين لا تسمح لهم أوقاتهم بتعلم العلوم الدِّينية، فيحتاجون إلى من يرجعون إليه من علماء الدين. غير أن المفتي أو شيخ الإسلام إنما يجيب عما يسأل عنه، أو يؤدي ما كُلِّف به، أما الكاردينال فكان يبتدئ المشورة، ويقترح المطلب، ويقيم نائب المَلِك على المذهب، فكانت السلطة الحقيقية مدنية سياسية دينية في نظام واحدا، لا فصل فيه بين السلطتين، وهذا الضرب من النظام هو الذي يعمل الباباوات وعُمَّالهم من رجال الكثلكة على إرجاعه؛ لأنه أصل من أصول الديانة المسيحية عندهم، وإن كان ينكر وحدة السلطتين: الدينية والسياسية من لا يدين بدينهم».
وفي السياق ذاته يشدد الإمام بأنَّ المدَّ الاستعماري يستلزِمُ التمسُّك بالسُّلطة العثمانية القائمة، مع بذل الـجهود من أجل إصلاحها. أي النظر إليها بوصفها سلاحًا سياسيًا في الصراع ضد الخطر الرئيس المتمثِّل في الزحف الاستعماريِّ الغربيِّ على بلاد الإسلام.
وقد عبَّر عن ذلك صديقه ألفريد سكاون بلنت حين قال في كتابه: التاريخ السري لاحتلال انكلترا مصر: «كان الشَّيخ محمد عبده، فيما يختص بالخلافة، يشاطر كل المسلمين المستنيرين رأيهم في وجوب إصلاحها وتجديدها على قواعد روحية. وقد شرح لي كيف يؤدي حُسن استخدام سلطتها على وجه شرعي إلى مساعدة حركة الترقِّي الأدبي، وكيف أن أصحاب هذه الخلافة أهملوا بحيث صاروا غير أهل الإمارة المؤمنين. والواقع أنَّ الأسرة العثمانية لم تحفل بالخلافة (الرُّوحية) مثقال ذرة خلال القرنين الماضيين، ولم يبق لها حقٌ ولا سلطان؛ حقُّ السيف ولا سلطانه، على أنهم ما زالوا أقوى أمراء المسلمين، ومن ثم يستطيعون القيام بالشطر الأكبر من العمل لخير الجميع. أما إذا لم يمكن حملهم على القيام بواجبهم؛ فلا مناص من البحث عن أمير آخر للمؤمنين».
وفي سياق رده على فرح أنطون رفض الإمام الدعوى التي تريد أن تستعير من المسيحية الجمع بين السُّلطتيْن: الدِّينية والمدنية، زاعمة كذبًا أنَّ لذلك الجمع صِلَةٌ بتعاليم الإسلام.
يقول في ذلك المعنى: «ولا يجوز لصحيح النظر أن يخلط الخليفة عند المسلمين بما يسميه الإفرنج «ثيوكراتيك»؛ أي سلطان إلهي. فإن ذلك عندهم هو الذي ينفرد بتلقِّي الشريعة عن اللَّه. وله حق الأثرة بالتشريع، وله في رقاب الناس حق الطاعة، لا بالبيعة وما تقتضيه من العدل وحماية الحوزة، بل بمقتضى الإيمان.
فليس للمؤمن ما دام مؤمنًا أن يخالفه، وإن اعتقد أنه عدوٌ للَّه وشهدت عيناه من أعماله ما لا ينطبق على ما يعرفه من شرائعه؛ لأن عمل صاحب السلطان الديني وقوله في أي مظهر ظهرا: هما دينٌ وشرع. هكذا كانت سلطة الكنيسة في القرون الوسطى، ولا تزال الكنيسة تدَّعي الحقَّ في هذه السلطة (إلى الآن)».
ففي معرض إجابته عن التساؤل المتعلِّق بطبيعة السُّلطة السياسية في المجتمع الإسلاميِّ، وما إذا كانت سُلطة دينية أم مدنية؟! رفض الإمام رفضًا قاطعًا أن يكون الدِّين الإسلاميُّ نصيرا لقيام سُلطة دينية في المجتمع الإسلاميِّ بأيِّ شكل من الأشكال وبأيِّ وجه من الوجوه، مُقيماً على ذلك الحجج العقلية، ومُقدِّمًا لذلك البراهين النَّقلية.
وعندما تحدَّث عن موضوع «الفصل بين السُّلطتيْن: الدِّينية والمدنية في المسيحية»، طرح الإمام عدداً كبيراً من الأسئلة حول إمكانية ذلك في الدِّيانة المسيحية، فبدأ أولًا بالتَّساؤل حول جدوى وغائية هذا الفصل؟، ثم تساءل بعد ذلك: «هب أنَّ مصالح الملِك تكون دائماً أغلبُ على النَّفس من حكم العقيدةِ وقاهِر الإيمان والوجدان، وقد أقام الدِّينُ سُلطتيْن مُنفصلتيْن؛ إحداهما تحلُّ وتربطُ في الأرض وفي السَّماء فيما هو من خاصَّةِ الدِّين؛ والأخرى تحلُّ وتربطُ في الأرض فيما هو من خصائص الدُّنيا؛ أفلا يكون هذا الفصلُ قاضيًا بتنازُع السُّلطتيْن، وطلب كلِّ واحدة منهما التغلُّب على الأخرى فيمن تحت رعايتهما معًا؟! وهل يسهُل على «السُّلطة الدِّينية» أن تدَع رعاياها تتصرَّف في أبدانهم وأموالهم؛ بل وفي عقولهم، إذا كان ذلك التَّصرُّف مخالفا لما جاء في كنز المعارف؛ وهو الكتُب السَّماوية، وتأويل الرُّؤساء الرُّوحيين وسُنَنِهم؟! فإذا همَّت هذه السُّلطة بالمعارضة، أفَتصْبِرُ الأُخرى؟! هذا هو الذي وقع في العالم المسيحيِّ منذ أن ظهرت «سُلطة الدِّين».
ومن ثم يمكننا الوقوف على أبرز عناصر رؤية الإمام محمَّد عبده المتعلقة بطبيعة ووظيفة وعلائق وطرائق «السُّلطة الدِّينية في الإسلام» من خلال نفيه وجود تلك السُّلطة على مستوى كل من: النَّصِّ، والاجتماع، والقانون، والتَّجربة التَّاريخية، وطرق اكتساب المعرفة الدِّينية، ونفي الصِّبغة الرُّوحية عن السُّلطة السِّياسية.
ففي معرض حديثه عن السُّلطان في الإسلام، وفي سياق ردِّه على فرح أنطون، أكَّد الإمام محمَّد عبده أنَّ القائلين بمحاربة الإسلام للعلم إنَّما يتوهَّمون أنَّ الإسلام يُحتِّم قرْن السُّلطتيْن في شخص واحد، فيظنون أنَّ السُّلطان هو مُقرِّر الدِّين، وهو واضِعُ أحكامِه، وهو مُنفِّذُها، وأنَّ الإيمان آلةٌ في يده يتصرَّف بها في القلوب بالإخضاع، وفي العقول بالإقناع. ويبنون على ذلك أنَّ المسلم مُسْتَعْبَدٌ لسُلطانِه بدينِه. وقد عهِدُوا أنَّ سلطان الدِّين عندهم كان يُحارب العلم ويحمي حقيقة الجهل؛ فلا يتيسَّر للدِّين الإسلاميِّ أن يأخُذ بالتَّسامح مع العلم! ما دام من أصولِه أنَّ إقامة السُّلطان واجبٌ بمُقْتَضى الدِّين.
ويردُّ الإمام على ذلك بالنِّفي القاطِع أن ليس في الإسلام سُلطةٌ دينيةٌ، سوى الموعظة الحسنة، والدَّعوة إلى الخير، والتَّنفير عن الشَّرِّ.
وأنَّ هذه السُّلطة ليست حكرا على أحد دون أحد؛ وإنما «هي سلطة خوَّلها الله لأدنى المسلمين يقْرعُ بها أنفَ أعلاهم، كما خوَّلها لأعلاهم يتناولُ بها مِن أدناهم». كما أنَّه «ليس لِمسلم- مهما علا كعبُه في الإسلام-، على آخر- مهما انحطَّتْ منزلتُه فيه- إلَّا حق النَّصيحة والإرشاد، فالمسلمون يتناصحون، ثمَّ هُم يُقيمون أمَّة تدعو إلى الخير».
كما أكِّد الإمام بأنَّ إحدى المهام الكبرى التي جاء لها الإسلام، ونهض بها في المجتمع الذي ظهر فيه- والتي تعدُّ أصلاً من أصوله- هي «قَلْبُ السُّلطة الدِّينية» واقتلاعها من جذورها، والإتيان عليها من أساسها، حيث «هدم الإسلامُ بناء تلك السُّلطة ومحا أثرها، حتَّى لم يبق لها عند الجمهور من أهله اسم ولا رسم». وأنَّ «لكلِّ مسلم أن يفهم عن اللَّه من كتاب اللَّه، وعن رسوله من كلام رسوله، من دون توسيط أحد من سلف ولا خلف. وإنما يجب عليه قبل ذلك، أن يُحصِّل من وسائله ما يؤهّله للفهم فليس في الإسلام ما يسمى عند قوم بالسلطة الدينية بوجه من الوجوه».
نقلا عن موقع الحياة