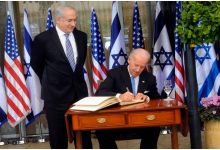*محمد علي عدراوي – أستاذ باحث، وزميل في «كلية إدموند أ. والش» بجامعة جورج تاون
*عرض وترجمة: أحمد بركات
في بداية تسعينات القرن الماضي، وبعد انفراط عقد الاتحاد السوفيتي، الذي كان يمثل التهديد الأكبر للولايات المتحدة الأمريكية، وفشل الشيوعية كأيديولوجيا ثورية، تحول مفهوم حركة إسلامية عابرة للوطنية، إلى هاجس ملح على العقل السياسي الأمريكي. في هذه الأثناء، عكف بعض صناع السياسة الأمريكيين على النظر إلى جماعة الإخوان المسلمين في مصر، والحركات التي ارتبطت بها مثل «جبهة الإنقاذ الإسلامية» في الجزائر، أو «حركة حماس» في فلسطين، باعتبارها جزءا من حركة أيديولوجية إسلامية عابرة للوطنية وقادرة – على غرار الشيوعية الغابرة – على الإضرار بالمصالح الأمريكية في أي مكان في العالم.
جدل أمريكي حول «الخطر المتغول»
أعرب السفير إدوارد دجيرجيان عن هذه المخاوف بوضوح في «خطبة ميريديان» الشهيرة التي ألقاها في 4 يونيو 1992، في «مركز مريديان الدولي» في العاصمة الأمريكية واشنطن. وللمرة الأولى، وصف مسئول أمريكي رفيع المستوى «التطرف الديني أو السياسي» باعتباره «خطرا متغولا على الاستقرار في الشرق الأوسط، وتهديدا سافرا للمصالح الأمريكية». ومنذ ذلك الحين، تم تعريف «الأصولية الإسلامية» بشكل متكرر على أنها مصدر قلق مستمر للدبلوماسية الأمريكية. في الوقت نفسه، برز جدل أمريكي جديد بشأن الحكمة، وربما الفائدة التي يمكن أن تتحصل عليها واشنطن جراء التعامل الدبلوماسي مع الحركات «الأصولية» مثل جماعة الإخوان.
السفير إدوارد دجيرجيان
وبالفعل، حرصت السفارة الأمريكية في القاهرة على التواصل مع الإخوان في السنوات الأولى من عقد التسعينات، وبات يُنظر إليها على أنها لاعب محوري على الساحة السياسية المصرية وقوة مؤثرة في مستقبل المنطقة. لكن هذا التوجه أثار حفيظة نظام مبارك القمعي الذي احتج بقوة على مساعي حليفه الأمريكي إلى إقامة علاقات دبلوماسية مع خصمه الإسلاموي المحلي، الذي كان لا يزال يخضع للحظر الرسمي بموجب القانون. ونتيجة لذلك، أوقفت الولايات المتحدة تواصلها الدبلوماسي مع الإخوان في النصف الثاني من التسعينات.
لكن رياح الألفية الجديدة حملت معها متغيرا تاريخيا تمثل في هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 التي نفذها تنظيم القاعدة في الداخل الأمريكي. أدى هذا العدوان الصادم على الولايات المتحدة إلى تكثيف النقاش بشأن المخاطر التي يفرضها الإسلام السياسي، أو الإسلام الراديكالي. كان واضحا للجميع – برغم الغبار السياسي الكثيف الذي أثارته هذه الهجمات – أن المنظرين الأيديولوجيين المحسوبين على الإخوان، من أمثال سيد قطب، قد تركوا تأثيرا غائرا ومباشرا على ظهور وتمدد تنظيم القاعدة. لكن، كان هناك أيضا خلاف دائم حول الأيديولوجيا والاستراتيجية الخاصة بكل من الإسلام السياسي الذي يمثله الإخوان من جانب، والحركة الجهادية العابرة للوطنية من جانب آخر. ونتيجة لذلك، ثار جدل محتدم داخل دوائر التأثير في واشنطن وخارجها بشأن تقييم المخاطر التي تفرضها جماعة الإخوان، ودورها البنيوي في ظهور الإسلاموية الحديثة. في هذا السياق برز رأيان متضادان في الأوساط الأكاديمية الأمريكية وفي دوائر صناعة القرار.
نظر أحد الرأيين إلى الإسلاموية باعتبارها أيديولوجيا وحركة سياسية حديثة لم تشهد المجتمعات المسلمة مثيلا لها من قبل. وعلى وجه التحديد، فُهمت الإسلاموية كشكل من أشكال المحافظة السياسية «وليس الدينية» التي بدأت مع ظهور الإخوان في مصر، ثم انتشرت منها بنجاح إلى سائر الأقطار في جميع أنحاء العالم. وبينما استندت الإسلاموية إلى الهوية المسلمة وإلى حالة الإحباط والمظالم التي غشيت المجتمعات المسلمة، إلا أنها لم تكن حركة دينية في ذاتها، وإنما ردة فعل سياسية حديثة ضد السلطوية المستعصية والجامحة، وغيرها من المعضلات السياسية التي يرزح تحت نيرها العديد من المجتمعات ذات الأغلبية المسلمة.
من الناحية الأخرى، ذهب فريق آخر من المحللين إلى التعاطي مع أحداث 11 سبتمبر باعتبارها تعبيرا عنيفا، ليس عن أيديولوجيا سياسية، وإنما عن ثيولوجيا «عقيدة» دينية، أو عن تفسير للإسلام بكل ما يمكن أن يستدعيه ذلك من ممارسة سياسية حديثة، أو عنف. فعلى سبيل المثال، في تقرير صدر في عام 2003 عن «مؤسسة راند»، وحمل عنوان Civil Democratic Islam «الإسلام المدني الديمقراطي»، ربطت العالمة السياسية «تشيريل بينارد» بوضوح بين قضية الدمقرطة والإصلاح داخل المجتمعات الإسلامية من جانب، وبين قضية العلمنة من جانب آخر. ومن هذا المنظور، لايمكن التعامل مع تهديدات الإسلام الراديكالي وانحسار الديمقراطية في المجتمعات الإسلامية، إلا من خلال الإصلاح الديني، وليس السياسي.
أوعز هذان الرأيان بمقاربتين سياسيتين متباينتين في التعامل مع الإسلاموية، كان من بينهما التعاون الدبلوماسي مع جماعة الإخوان المسلمين. على سبيل المثال، أكد الرئيس جورج دبليو بوش على التعزيز النشط للإصلاح الديمقراطي في المجتمعات الإسلامية. وبالنسبة إلى كثيرين في هذا الوقت، كان هناك اعتقاد سائد بإمكانية حدوث تحول تدريجي في الأيديولوجيات السياسية التفاعلية، كتلك التي تعتنقها جماعة الإخوان والدفع بها نحو «الاعتدال»، وذلك عبر توسيع قاعدة الديمقراطية. وبموجب «شعار» تعزيز الديمقراطية، جدد الدبلوماسيون الأمريكيون تواصلهم مع أفراد وجماعات من داخل تيار الإسلام السياسي العابر للوطنية الذي ألهمته جماعة الإخوان المسلمين.
جورج دبليو بوش
وعلى النقيض من «المثالية الديمقراطية» التي انتهجتها إدارة بوش، تبنى باراك أوباما مقاربة أكثر واقعية في التعاطي الأمريكي مع جماعة الإخوان والاسلاميين. فقبيل انتخابه، كشف أوباما بجلاء عن شكوكه حيال الإخوان المسلمين، واصفا أعضاءها بأنهم «الأباء المؤسسون» للإسلام السياسي والراديكالية الإسلاموية، وبأنهم «غير جديرين بالثقة»، و«يتبنون وجهات نظر معادية للولايات المتحدة»، و«لا يحترمون معاهدة كامب ديفيد للسلام مع إسرائيل».
باراك أوباما
بالنسبة إلى أوباما، كان الإسلام السياسي أو الإسلاموية نتاجا عضويا حديثا للسياسة والثقافة الإسلامية، وعلى وجه التحديد للتفسير المحافظ للإسلام. ففي وقت لاحق من فترته الرئاسية – على سبيل المثال – ذكر أوباما في مقابلة لمجلة The Atlantic، أجراها جيفري جولدبيرج، أن: «هناك… ضرورة أن يواجه الإسلام ككل هذا التفسير للإسلام، وأن يعزله، وأن يتم إجراء حوار عميق وناجع داخل المجتمعات الإسلامية حول دور الإسلام كجزء من مجتمع سلمي حديث».
وعلى النقيض من بوش، لم يعتقد أوباما بأن هذا التغيير الديني والسياسي داخل الإسلام يمكن فرضه، أو تحفيزه من الخارج، وإنما كان يجب أن يحدث من داخل المجتمعات الإسلامية، ومن خلال القيادات المسلمة.
وعلى نحو متزايد، بدا أن كثيرا من الباحثين والعلماء والقيادات الأمريكية من كافة ألوان الطيف السياسي يتشاركون واقعية أوباما بشأن جماعة الإخوان المسلمين والإسلاموية الحديثة. رغم ذلك، ظل حجم الاتفاق بشأن فكرة التعامل الدبلوماسي مع الجماعة أقل بكثير، حيث أصر البعض على دعم التواصل مع الإخوان، معتقدين أن الحركة الإسلاموية ربما تصبح أكثر علمانية وتعددية وديمقراطية عندما يتوافر لها مناخ سياسي ديمقراطي تتمتع فيه بمزيد من الحرية، بينما أصر آخرون على أن التعامل الدبلوماسي مع الإخوان لن يكون سياسة رشيدة، ما لم تبادر الجماعة إلى إضفاء طابع علماني على نفسها، وتتنازل عن أجندتها المناهضة للتعددية وللغرب. إضافة إلى ذلك، كانت الجماعة لا تزال محظورة رسميا في مصر وفي غيرها من الدول. ومن ثم، فقد ظل هذا الجدل الأمريكي يدور في حلقته المفرغة حتى اندلاع ثورات الربيع العربي في بداية عام 2011.
حوار مع «الإخوان»
في شهري يناير وفبراير 2011، بدأت سلطة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك تتداعى، بعدما أعرب كثير من المصريين عن رغبتهم في «إسقاط النظام». وفي الأيام الأولى من الحراك الشعبي في مصر، كان الهاجس السياسي الأمريكي يتمحور بالأساس حول مصير مبارك. لكن مبارك سرعان ما حسم هذا الصراع بعدما تبين له تداعي سلطته تحت وقع الحراك الشعبي الجارف، فبادر إلى تسليم حكم البلاد إلى المجلس العسكري.
كانت جماعة الإخوان المسلمين آنذاك هي الكيان السياسي الأكثر تنظيما، وربما الأكثر قدرة على ملء الفراغ السياسي في مصر، وهو ما أثار مجددا الجدل حول الإسلام السياسي، الذي كان يلح بقوة على مائدة السياسة الأمريكية في أعلى مستوياتها على مدى ما يقرب من عقد من الزمان. وفي مواجهة تصاعد وتيرة الاحتجاجات «التي بلغت ذروتها في يوم 28 يناير2011، «جمعة الغضب» »، كان على الولايات المتحدة أن تتعامل مع احتمال تولي حكومة يسيطر عليها الإسلاميون زمام الأمور في مصر، وهو ما أدى إلى زيادة المخاوف، وإثارة العديد من التساؤلات: هل ستستمع حكومة إخوانية إلى مطالب وطموحات الشعب المصري، بما في ذلك غير الإسلاميين؟ أم ستسعى إلى تجذير سلطتها في محيط أجندتها الإسلاموية؟
في هذا السياق أعلنت هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك، أنه: «ليست أمريكا هي من وضع الناس في الشوارع في تونس والقاهرة». وأضافت: «هذه الثورات لا تخصنا؛ إننا لم نقم بها، كما أنها لم تقم علينا، أو من أجلنا». لكنها ألمحت إلى ضرورة أن تلبي الحكومة المصرية القادمة طموحات الشعب المصري.
هيلاري كلينتون
وفي شهري مارس وأبريل 2011، تصاعدت التحذيرات من عدد من القادة السياسيين والمحللين الأمريكيين بشأن الصعود المحتمل لجماعة الإخوان إلى سدة السلطة. ومع زيادة حدة الاضطرابات السياسية في مصر، شرعت وزيرة الخارجية الأمريكية صراحة في فتح الباب أمام الإخوان وتحدثت كلينتون مرارا في الفترة بين ربيع وخريف عام 2011 عن حاجة الولايات المتحدة إلى التعامل مع هذه الحركة. كما أعلن عدد من الدبلوماسيين رفيعي المستوى والمسئولين في البنتاجون أنهم عقدوا «محادثات مشجعة مع مجموعة من قادة المعارضة، بمن فيهم جماعة الإخوان». وفي وقت لاحق، عبرت كلينتون بجلاء في أثناء زيارتها إلى العاصمة المجرية بودابست، في يونيو 2011، عن الموقف الرسمي لإدارة أوباما حين قالت: «في ضوء المشهد السياسي المتغير في مصر، نعتقد أنه من مصلحة الولايات المتحدة أن تتعامل مع جميع الأطراف الملتزمة بالسلمية وعدم العنف، والعازمة على خوض السباق الانتخابي على المستويين البرلماني والرئاسي. وبناء على ذلك، فإننا نرحب بالحوار مع أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الذين يرغبون في الحوار معنا».
يلفت الانفتاح الدبلوماسي من قبل إدارة أوباما على الإسلاميين إلى أن الدعم الذي كانت تقدمه واشنطن في السابق إلى بعض النظم الاستبدادية في عدد من بلدان الشرق الأوسط ،قد خضع للمراجعة والنقد. وهكذا أكدت كلينتون في نوفمبر 2011 أنه «على مدى سنوات، كان الديكتاتوريون يخبرون شعوبهم بأن عليهم أن يقبلوا المستبدين الذين كانوا يرفضونهم، والمتشددين الذين كانوا يخافونهم… لطالما قبلنا نحن أنفسنا بهذه السردية».
(يُتبع)
*هذه المادة مترجمة. يمكن مطالعة النص الأصلي باللغة الإنجليزية ومراجع الدراسة من هنا