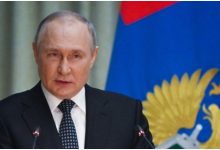أرفض التنميط والكلام المعلب ولا أسعى لشهرة أو أعجاب من أحد
أحترم المشاهد ولا أضحك عليه أو لا أقول كلام مستهلكا
لايوجد فيلم يمكن أن يكسر حاجز الظلم، وأندهش ممن يصفون عملا سينمائيا بالخطير
السينما في مصر تعاني من احتكار غير معلن لعشرة أشخاص يتحكمون في الذوق العام
“هالة جلال” ليست مجرد مخرجة من بين مخرجات مصريات كثر.. إنها حالة إبداعية مميزة اختارت منذ البداية أن تسلك الطريق الصعب، وأن تنحت في الصخر لتقدم سينما تبنى ولا تهدم، تنتصر للإنسان دون أن تتقيد بحسابات الربح المادي أو الخسارة، سينما تحترم عقل المشاهد ولا تحاول خداعه عبر شخصيات نمطية أو قوالب ثابتة.
حقق فيلمها الأخير “من القاهرة” نجاحا كبيرا، واستحق عن جدارة جائزة أفضل عمل سينمائى غير روائى بمسابقة آفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة السينمائي، فى حوارها مع “أصوات أون لاين” بدت “هالة جلال” متفائلة إلى حد كبير بالمستقبل، وبأن مصر رغم التحديات تمتلك أضخم سوق لصناعة السينما في المنطقة.
كما شددت –في الوقت نفسه– على رفضها للتنميط، فهو الآفة التي ترى أنها تهيمن على الكثير من الأمور في مجتمعنا، أما هي فيحكمها احترامها الكامل لعقلية المشاهد؛ لذلك فهي تقدم دوما ما تشعر به –غير ساعية لشهرة أو إعجاب– فهناك دوما طاقة نور يجب أن نتشبث بها وسط العتمة، مثلما ينبغي أن نحتفي بالبهجة في حياتنا وإلى تفاصيل الحوار:
حقق فيلمك الأخير “من القاهرة” نجاحا كبيرا فهل تعتقدين أن رسالة العمل وصلت لمن يهمه الأمر؟
لست أنا من يحدد ما إذا كانت الرسالة قد وصلت أم لا، ولكن دعنى أتحدث عن أن رد فعل الجمهور التلقائي خلال العرض الأول –قد تجاوز الكثير من التوقعات كما أن “من القاهرة” هو الفيلم الوحيد الذى عرض للمرة الرابعة خلال مهرجان القاهرة السينمائي، وفي كل منها كانت القاعة ممتلئة عن آخرها بالحضور.. وأظن أن السبب في ذلك أن المشاهدين شعروا أنه كان صادقا، ولمس لديهم وترا معينا، ولا يعنى هذا مطلقا أننى أصف أعمالا أخرى بعدم الصدق أو احتكر هذه القيمة لنفسي.
ما السبب في هذا النجاح الكبير للفيلم من وجهة نظرك؟
صدقنى لا أعرف لماذا أحب الناس الفيلم، وارتبطوا به بهذا الشكل، ولكن ما أعرفه أننى كنت صادقة جدا فيه حتى لو بدا الطرح محرجا من وجهة نظر البعض، فأنا أقول الحقيقة كما أراها دون أدنى قدر من المواربة. ففي الفيلم أقول بشكل صريح أن حياة النساء داخل القاهرة تمضى بهذا الشكل وبتلك التحديدات التى يتعرضن لها صباح مساء. وللأسف فإن هناك من يغمض عينيه عن الحقيقة، وربما يتخذ موقفا عدائيا ممن يتكلم؛ لأن هؤلاء يريدون أن تمضى حياتهم كما هي ويخشون من أن ينتابهم شعور بالذنب يوما ما إذا اكتشفوا حقيقة تعمدوا إخفاءها عن أنفسهم طويلا، وهى أن هناك مظلومين؛ تخاذلوا عن مد يد العون لهم .
ودعنى في هذا الصدد أذكرك بالكلمة التاريخية للجنة التحكيم، عندما إعلانها منح الفيلم جائزة أفضل فيلم غير روائى خلال الدورة الماضية من مهرجان القاهرة السينمائى “الجهد الكبير الذى بذلته مخرجة العمل حتى خرج بهذه الصورة” وصدقني أنا كمخرجة ليس لي علاقات شخصية أو مصالح مع أحد ولكن الفيلم فاز بهذه الجائزة الكبيرة بعد أن أحبه أعضاء لجنة التحكيم الذين قالوا أن الفيلم “معمول بقلب”.
ومن ناحيتى فأنا أتكلم دوما عما أفكر فيه، بعيدا عن الكلام “المتذوق”. وكوني “ست” مؤدبة ولطيفة ولا أحب النكد على المستوى الشخصي –لا يمنعني من أن أتحدث مع المشاهد –عبر العمل– باحترام وتقدير شديدين؛ فأنا لا أضحك عليه ولا أقول كلاما نمطيا، ولا أقدم “كليشيهات” نمطية أو شخصيات تعيش ضمن قوالب ثابتة، وأنا بشكل عام أرفض التنميط والكلام المعلب ولم يكن نُصب عيني أبدا أن أحوذ إعجابا من أحد.
هل نجحت مثل هذه الأفلام في كسر حاجز الصمت حول الظلم الذى تتعرض له المرأة في مجتمعاتنا؟
لايوجد فيلم يمكن أن يكسر الظلم، وأنا هنا أندهش بشدة ممن يقول أن فيلما ما لايجب أن يعرض لأنه خطر، خطر على ماذا لا أدرى؟! فالأفلام لاتؤثر في الناس تأثيرا مباشرا، بحيث نجد الشخص بعد الانتهاء من مشاهدة عمل ما، يتصرف بكيفية معينة. هذا لايحدث بالطبع ولكن دعنى أقول لك أن هناك من يخشى الحقيقة التى تضعنا جميعا أمام مسئولياتنا، فأنت لا تريد أن تعرف أن هناك مظلوما، وأنك تقاعست عن مد يد العون له؛ فالكثيرون لايحبون أن ينتهبوا إلى أن هناك مشكلة ما.. وفي هذا السياق أستغرب أن يقيم أحدهم الدنيا ولا يقعدها بسبب فيلم أو عمل معين، وأنا لا أريد من هذا العمل أن “أنكّد” على الناس فأنا على المستوى الشخصي أكره “النكد” ولكن أود أن أقول أن هناك مظلومين، في حياتهم طاقة نور ويمتلكون فرصا لحياة جديدة، فمهما كان حجم الظلم والمدى الذى وصلت إليه الضغوط والمسئوليات فأنت يمكن أن تعيش سعيدا، وهَبْ أنّ شخصا اكتشف إصابته بالسرطان، وأن حالته ميئوس منها، ولم يتبقَ في حياته سوى عدة أشهر، أليس من الأفضل أن يغتنمها؟ ماذا عنا لو فكر كل منا في أن وجوده على ظهر الأرض، مقدر بسنوات ستمضى طالت أم قصرت، وأن علينا أن ننعم، سنكون –بالطبع– أفضل حالا.. وصدقنى أنا على المستوى الشخصى حياتي ليست سهلة ولكن يجب أن يتشبث المرء بالأمل حتى لو كان النفق مظلما.

وماذا عن بطلات الفيلم؟
بطلات العمل سيدات حالمات حياتهن ليست سهلة أبدا اقتصاديا أو اجتماعيا أو نفسيا، ولكن رغم هذا كله يفعلن كل شيء بالطريقة التي يردنها، وينحتن في الصخر من أجل أن تحتفظ كل واحدة منهن بذاتها، في حياة أقل ما توصف به أنها صعبة، فينتزعن حقوقهن دون “خناقات” فيعملن ويلعبن ويلبسن ما يحلو لهن ويعبدن الله.
لماذا اخترتي أن تبدئي الفيلم باقتباس “كل خطوة بـ انكسر وارجع صحيح” من شعر “فؤاد حداد”؟
“فؤاد حداد” شاعر عظيم يمتلك قدرة كبيرة على توظيف اللغة، كما استخدمت بالفيلم أيضا بعضا من كلمات الرائع “صلاح جاهين” كما استعنت أيضا بمشاهد تجمع بطلات وأبطال عدد من الأفلام القديمة، وأنا شخصيا أحب هذه الأفلام جدا، وكذلك أغانى وكلمات الحب الصادق والتى أحرص على الاستماع إليها طوال الوقت، وفي الفيلم يظهر أن كلام الحب ليس له أثر في حياة الناس، وأتمنى أن تكون البطلات أكثر سعادة إذا عاد إلينا بعض ما غاب عنا في زحمة الحياة.
والفيلم كله دعوة من أجل الحياة، فمهما كان حجم التحديات والضغوط يجب أن يكون المرء صادقا مع نفسه، ويجب ألا ينكسر ويمضى في طريقه.. وأكرر أن كل شىء في فيلم “من القاهرة” أقصده تماما، فأنا مخرجة أقوم بعمل أفلام أريدها بالفعل، ودوما أقدم ما أحبه، فأنا لا أسعى لشهرة أو مال أو تكريم هنا أو جائزة هناك، وحلمي أن تكون حياتنا جميعا أفضل، فنحن جميعا نستحق ذلك وحولنا ما يمكن أن يسعدنا لكننا ربما نغفل عنه.
وما دلالة تكرار مشهد “المانيكان” في الفيلم؟
“المانيكان” واحدة من ملاحظاتي على جزء من الحياة التى نعيشها الآن، إنه يعبر ببساطة شديدة عن الناس عندما تختار للمرأة الطريقة التى يجب أن تعيش وتتكلم وتتزوج أيضا بها. حيث تتحول النساء إلى مجرد أشياء، ولو قمت بجولة في محلات وسط البلد ستجد في “ڤاترينات” العرض ملابس ومستلزمات نسائية تصدم الذوق العام في مجتمع يفترض أنه محافظ بطبعه.
جزء رئيسي من المشكلة أن قيمة المساواة غائبة عنا، فالمرأة حتى اليوم يتم حصرها في إطار معين يتم تسليط الضوء فيه على، كيف تتكلم وماذا تلبس، ومتي تخرج من منزلها، ومتى تعود إليه؟
أما المجتمعات الغربية –فرغم تاريخها الاستعماري– فقد نجحت في تحقيق المساواة بين الرجال والنساء والسود والبيض.. نعم هناك تجاوزات تحدث بين الحين والآخر، ولكنها تبقى محرمات يرفضها المجتمع ويجرمها القانون.
وصدقني.. غياب المساواة في مجتمعاتنا مؤذٍ للرجل مثل المرأة تماما، فبدلا من أن يكون شريكا يتحول في العلاقة إلى صاحب الشركة، فالمسألة ليست مظلومية المرأة، فالتداعيات أكبر من هذا بكثير، والثمن فادح.. فظلم المرأة يؤذى المجتمع بأكمله، هل تدرك فداحة أن يتربى الأطفال في ظل “بابا” ذلك الوحش الكاسر، و”ماما” تلك الجارية المستكينة، إذا كان هناك من يعترض على هذا الطرح، فليتفضل ليخبرنا بماذا علينا أن نفعل وإذا عدنا إلى الفيلم فإنه صرخة ضد الظلم الذى تتعرض له أى فئة من الفئات.

لكن تهميش المرأة يبدو أنه يشغل حيزا كبيرا من اهتمامك؟
كما قلت لك سابقا ما يشغلنى هو محاولة التصدى للظلم، وأنا ضد التنميط والتقسيمات الجائرة وفي هذا الصدد دعنى أخبرك أن فيلمي القادم سيكون بطله رجل، وحتى في أفلامي السابقة كنت أسعى جاهدة للانتصار للقضايا التى أراها عادلة من وجهة نظري، ففي فيلم “دردشة نسائية” أناقش تطور المجتمع المصري من أوائل القرن العشرين حتى اليوم، عبر تسليط الضوء على وضع المرأة كما عاشته أجيال عديدة داخل نفس الأسرة.
كيف تنظرين لكونك أمرأة ومبدعة في الوقت نفسه؟
الحقيقة أن حظى كان أفضل من أناس كثيرين، حيث ولدت في أسرة تضم صحفيين مشغولين بالهم العام، شاركوا في تاريخ مصر، وتربينا نحن –ثلاثَ بناتٍ– تربية قائمة على الرحمة والتسامح والحنان، ولم أكن أخشى أهلى كحال الكثيرات من صديقاتى خلال تلك الفترة المبكرة من حياتي، وإنما كنت أخاف بشكل أساسى من ردود فعل الجيران، في ظل نظرة تحصر المرأة في حيز معين كما قلنا سلفا.
ودعنى أؤكد –في هذا الصدد– أننى لست ممن يؤمنون بأن الأنحياز للمرأة يجب أن يكون على حساب الرجل أو العكس، فهذا يندرج ضمن دائرة التنميط المنبوذ، فلكل منهما أدواره التي يقوم بها والتى يحتاج إليها المجتمع، والتي لا تعنى نفيا للآخر بأي حال من الأحوال.
في مشوارى الفني أركز على أن أحكى حكاية من تعرّض للظلم أيا كان نوعه، ويجب أن تعلم أن الفن غريزة؛ فالإنسان البدائى كان يأكل ويشرب ويمارس العلاقة الخاصة، ويرسم على الكهف.. وفي هذا الأطار علينا أن نركز أن الأطفال الصغار يجب أن يربوا برفق في ظل علاقة قائمة على الحب والاحترام المتبادل بين الأب والأم.
في ظل هذا كله هل أنت متفائلة بالمستقبل؟
أنا متفائلة بالمستقبل ويقيني أن هناك دوما مَخْرَج من أى شىء صعب، وحتى نضع الأمور في نصابها الصحيح؛ جَرِّدْ الأشياء من كل ما يحيط بها، فالعمر –بطبعه– محدود؛ لذا علينا أن نستمتع بحلوه، كما نشكو من مُرِّه.. وفي النهاية لن نعدم شيئا يعطينا دفعة أمل، وأنا حياتي بها صعوبات كثيرة مثل كل الناس ولكن دوما أقول لنفسي أن هناك مخرج من كل أزمة وحل لكل مشكلة.

إلى أى حد أنعكس وجود جيل من المخرجات أنت أحد رموزه إيجابا على قضايا المرأة؟
هذا السؤال أيضا يدخل في دائرة التنميط الذى يفرغ كل شىء من محتواه الحقيقي؛ فلا يجب أبدا أن يطرح الأمر في سياق قضايا المرأة والصراع مع الرجل، فحقوق الإنسان تضمن الحرية والمساواة لكل البشر مهما اختلفت ألوان بشرتهم وأجناسهم، ومن حق كل إنسان –رجلا كان أو امرأة– أن يعيش سعيدا، وأن يتمتع بالأمان والرجل اليوم يواجه مشكلات كثيرة مثل المرأة. ولو تحدثنا عن المجال السينمائى سنجد الرجال يعانون من نقص الفرص مثلهم مثل النساء اللاتى كن قديما يمتلكن استديوهات وينتجن أفلاما ويقمن بأدوار البطولة على خشبة المسرح وأمام شاشة السينما.. الآن بفعل متغيرات كثيرة صار الوضع ضاغطا، ولايعنى أن المرأة أصبحت قاضية ومحامية ومخرجة؛ أن كل مشاكلها قد حُلَّت فهناك نماذج وصلت بالفعل إلى مناصب لم تكن متاحة للنساء من قبل، لكن في الوقت نفسه، فإن امرأة تريد أن تشعر أن تطورا طرأ على حياتها الخاصة بعيدا عن الرمز، وليس معنى أن تطالب بأن تكون أن يصبح الآخر في الكفة الأخرى لا يكون.
دعنى أضرب لك مثلا بخطورة التنميط والذى يجعل الرعب يسيطر على طريقة تفكيرنا في بعض الأحيان بسبب ثنائيات –ما أنزل الله بها من سلطان– فلنتفرض أن هناك صحفيان متنافسان داخل مؤسسة صحفية مطالبان بتقديم كشف إنتاج معين لا يقل عن عشرة موضوعات يوميا، حتما لن يهتما بالجودة والمصداقية وربما يضطران إلى مداهنة رئيس التحرير حتى لا يتعرَّضا لسخطه، وفي كل الأحوال لايجب أن تهيمن الروح العدائية على علاقة المرأة بالرجل في المجتمع؛ فالحقوق يجب أن تكون مكفولة للناس كلها رجالا ونساء ولكن يبدو أن صوت الحقوق مرعب في كثير من الأحيان.

كيف تقيمين الدور الذى تلعبه السينما المستقلة؟
في سنة 2000 قمنا بتكوين مؤسسة لدعم السينما المستقلة؛ فمصر تعاني من احتكار غير معلن وغير رسمي لصناعة السينما، فهناك ما بين سبعة لعشرة منتجين وموزعين كبار يتحكمون في كل شيء، فهم الذين يوجهون بوصلة العمل السينمائي، ولهم اليد العليا في تشكيل الذوق والذائقة فهم الذين يحددون الفيلم الذى يخرج إلى النور، والفيلم الذى يظل حبيس الأدراج.. وفي بلد يصل تعداد سكانه إلى 100 مليون نسمة، ليس مقبولا أن يحدد لنا عشرة أشخاص ما يمكن أن نراه على الشاشة، وبما إن هذا الاحتكار غير رسمي فقد اتجه تفكيرنا إلى تأسيس شركة تنتج أفلام للسينما المستقلة، بحيث نعطى الفرصة لأجيال جديدة وأفكار مختلفة نفسح فيها المجال لمخرجين جدد، فالفيلم يبقى صوت المخرج، وهو فيه يعبر عن نفسه ويشكل تجربته الخاصة وبعد ذلك تبنى الفكرة آخرون وقررنا أن نتوقف في وقت لاحق؛ خاصة أن السينما تحتاج إلى تمويل كبير، فهي تعتمد على التكنولوجيا بشكل كبير.
كيف ترين واقع صناعة السينما اليوم ؟
لو نظرنا لدول مثل: ألمانيا وبريطانيا سنجد سوقا ضخمة للانتاج السينمائي، كما أن هناك اقتصاديات ورأسمال يضمن انتظام دورة العمل، وأنا أتساءل هل نحن بدورنا نمتلك اقتصاديات لصناعة السينما؟ الحقيقة أننا نمتلك سوقا ضخمة تضم 100 مليون شخص، ونحن في حاجة إلى بناء عدد أكبر من دور العرض السينمائي، ولكن تبقى المشكلة أن المسئولين عن هذه الدور في كثير من الأحيان لايعرفون شيئا عن احتياجات الجمهور والسوق، لكن دعنى أؤكد لك أنى متفائلة جدا بالمستقبل، وأننا يجب أن نقدر البهجة في حياتنا.