عوامل متعددة قد اجتمعت في ابن رشد وله، جعلته أكثر من غيره من الفلاسفة العرب والمسلمين، أهلا لكي تُقرر عدة مؤسسات أكاديمية عربية ودولية إطلاق اسمه على العام1998،
احتفاءً بمرور ثمانية قرون على وفاته، وذلك من حيث كونه أحد أهم فلاسفة ومفكري العالم الإسلامي تأثيرًا في الفكر الأوروبي في عصر النهضة وما تلاه من عصور.
ولد أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد في قرطبة في العاشر من شهر ديسمبر من عام 1126، وتمكّن من دراسة العلوم الشرعية والطبية والفلسفية والفلكية، وولِيَ القضاء، ولُقّب بقاضي قرطبة، وعاش في بلاط الموحدين طبيبا ومستشارا، ولكنه لم يكن تابعا أو متأثرا بمذهب الدولة بقدر ما كان له تأثير واضح –منذ شبابه– في السياسة الثقافية للموحدين، ولعل هذا ما ساهم في جعل مذهبهم منفتحًا، لا هو بالأشعري، ولا هو بالظاهري الخالص، ولا هو بالمتشدد.
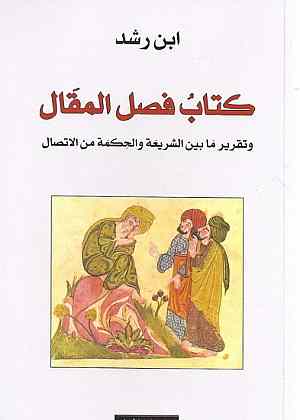
الدين والفلسفة
وقد استحق ابن رشد بجدارة لقب الشارح الأكبر لفلسفة أرسطو، من حيث إن هذه الشروح كانت قد اكتملت على يديه، وبلغت به قمتها وغايتها في العصر الوسيط. وإذا كان أرسطو قد استحق لدى جميع الأمم في العصور الوسطى لقب المعلم الأول، فقد جاء ابن رشد ختاما لشُرَّاح عديدين تناولوا من قبله فلسفة أرسطو.
يكفي أن نشير هنا إلى جهود الفلاسفة المسلمين السابقين على ابن رشد، وخاصة الكِندي (185 ـ 252 هـ) والفارابي ( 259 ـ 339 هـ) وابن سينا (370 ـ 428 هـ) وغيرهم، وهي الجهود التي كانت أبرز أعمال العصر على فلسفة أرسطو؛ لكن هؤلاء الفلاسفة قد ساروا في الخطأ نفسه الذي وقع فيه من قبلهم شُرّاح كثيرون، عندما خلطوا بعض فلسفة أرسطو بفلسفة أفلاطون، وعندما حاولوا التوفيق بينهما في ما لا يمكن التوفيق فيه من موضوعات.
وكما كان ابن رشد الشارح هو الذي أعاد تحديد معالم فلسفة أرسطو، وقدّم في شروحه دراسة نقدية لما ارتكبه قبله الشراح من أخطاء؛ فقد كان مجيء هذا الفيلسوف خاتمة لعصر ازدهار الفلسفة العربية الإسلامية في العصر الوسيط، وإعطاؤه لهذه الفلسفة دفعة من الازدهار لم تشهدها من قبل.
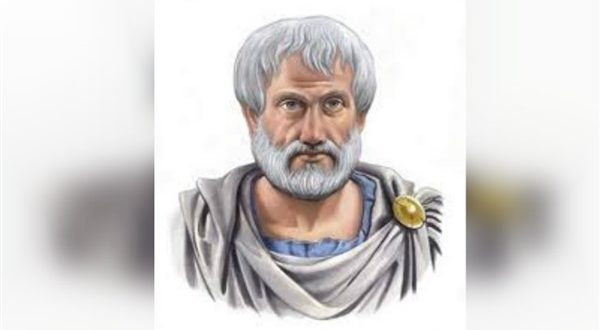
بيد أن المتابع لكتابات ابن رشد، سواء مؤلفاته العامة أو شروحه على أرسطو، لابد أن يلحظ هجومه الشديد على المتكلمين ومنهجهم، وهجومه الأشد على ابن سينا وطريقته في الاستدلال التي لا تختلف، في نظر فيلسوف قرطبة، عن طريقة المتكلمين.
يكفي أن نشير هنا إلى كتابه “تهافت التهافت” الذي يرد فيه على الغزالي، بعد أن كتب الأخير “تهافت الفلاسفة” وقد وضعه أبو حامد لبيان تناقض وتهافت آراء ابن سينا والفارابي، كـونهم ناطقين باسم أرسطو. ففي “تهافت التهافت” لا يرد ابن رشد على الغزالي دفاعا عن ابن سينا؛ بل على العكس لقد كان هجومه على هذا الأخير أشد وأقوى. فهو قد اتهم ابن سينا والغزالي معًا بأنهما يعتمدان طريقة في الاستدلال، لا تبلغ مرتبة اليقين في الفلسفة. ومن ثم، فهو يرى أن الغزالي لم يرد على الفلاسفة بإطلاق، ولكن على تأويلات ابن سينا لأقوال الفلاسفة.
على أساس هذا النقد المبدئي لمنهج ابن سينا والمتكلمين عموما، يرفض ابن رشد المفاهيم الأساسية التي حاول هؤلاء توظيفها في محاولاتهم الرامية إلى التوفيق بين الدين والفلسفة؛ من منظور أن نقطة الضعف الأساسية في هذه المحاولات –في نظر فيلسوف قرطبة– أنها تجمع بين عالمين مختلفين تماما، عالم الغيب وعالم الشهادة.

فصل المقال
يعني ذلك، أن ابن رشد كان يفصل بكل وضوح بين الفلسفة والدين، أو بحسب تعبيره بين الحكمة والشريعة، وله في ذلك رسالة شهيرة بعنوان “فصل المقال في ما بين الحكمة والشريعة من الاتصال”. ولم يتوقف عند هذا الحد بل عُنِي بإثبات أن الشريعة الإسلامية تحث على إعمال العقل، بل وأوجبت ذلك، وأنها والفلسفة حق، والحق لا يضاد الحق بل يؤيده ويشهد له.
وقد وضع في هذا الشأن رسالتين إحداهما “فصل المقال” والأخرى “الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة” وهي الرسائل التي تشير إلى محاولات ابن رشد التوفيق بين الفلسفة والدين من المنظور العقلي.
والواقع أن الخطاب الرشدي، عبر أشهر رسالاته “فصل المقال” ينبني كله على النظر إلى الدين والفلسفة كبناءين مستقلين، يجب أن يتم البحث عن الصدق فيهما داخل كل منهما وليس خارجه. والصدق المطلوب في نظر ابن رشد، هو صدق الاستدلال وليس صدق المقدمات، ذلك لأن المقدمات في الدين، كما في الفلسفة، أصول موضوعة يجب التسليم بها دون برهان.
وهكذا، فإن “ما في الدين” ليس مجرد “مثالات لما في الفلسفة” بل لكل منهما كيانه الخاص ومنهجه الخاص. وبحسب ابن رشد، فإن هذا لا يعني أنهما متناقضان، بل على العكس، فـ”الحكمة والشريعة ترميان إلى هدف واحد، هو: معرفة الحق، والحق لا يضاد الحق بل يوافقه ويشهد له”.
وإذا كان هناك من أذى لحق إحداهما باسم الأخرى، فإنه إنما جاءهما ممن ينتسب إليهما. فالأذى إنما جاء إلى الدين من المنتسبين إليه من المتكلمين، كما أنه لحق الفلسفة من المنتسبين إليها السائرين على طريقة المتكلمين طريقة “الاستدلال بالشاهد على الغائب” التي تقوم على الجمع بين عالمين مختلفين تمامًا.
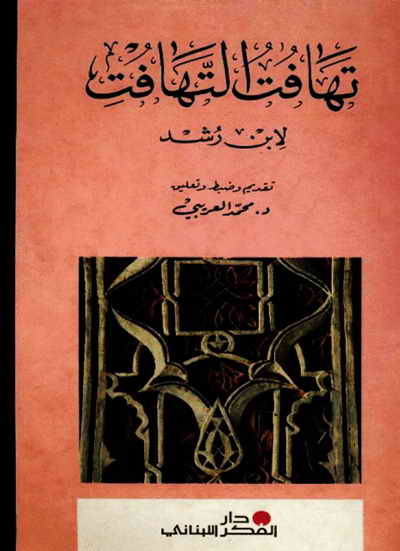
الفلسفة الرشدية
ولعل هذا ما يتبدى بوضوح إذا لاحظنا كيف تعامل ابن رشد مع إحدى المسائل الرئيسة التي شغلت المتكلمين والفلاسفة أي “هل يعلم الله الجزئيات أم يعلم الكليات فقط؟” ففي رأي المتكلمين عموما والأشاعرة بوجه خاص، أن القول بأن الله يعلم الجزئيات، يؤدي إلى القول بتغيُّر علم الله، وبالتالي إلى حصول التغيُّر في ذاته، ولهذا قال الفلاسفة، خصوصًا الفارابي، إن الله يعلم الكليات فقط؛ وهو قول ثار ضده “النصيون” لأنه يؤدي في نظرهم إلى إسقاط الثواب والعقاب على أفعال الإنسان، حيث إنها كلها جزئيات.
أما ابن رشد، فقد رأى أن هذه المشكلة “زائفة” برمتها؛ لأنها أيضًا نتيجة لقياس الغائب على الشاهد أي قياس علم الله على علم الإنسان، وهذا ـفي نظرهـ خطأ من حيث إن “علمنا معلول للمعلوم به، فهو محدث بحدوثه ومتغير بتغيره، وعلم الله سبحانه بالوجود مقابل هذا، فإنه علة للمعلوم الذي هو الموجود، فمن شبَّه أحد العلمين بالآخر فقد جعل ذوات المتقابلات واحدة، وذلك نهاية الجهل” بحسب ما يؤكد في “فصل المقال”.
وبهذا يؤكد ابن رشد على خطأ الاستدلال على علم الله سبحانه بعلم الإنسان؛ لأن هذا الاستدلال لا يصلح، كما يقول في رسالته “إلا حيث تكون النقلة معقولة بنفسها، وذلك عند استواء طبيعة الشاهد والغائب”. وفي رأيه، فإن هذا شرط غير متحقق في هذا الميدان، لأن عالم الغيب عالم مطلق، أما عالم الشهادة فعالم مقيد، ولذلك لا يجوز قياس أحدهما على الآخر.
وبعد.. فهل نحتاج إلى تأكيد القول بأن الرشدية، أو فلسفة ابن رشد، كانت قادرة على طرق آفاق جديدة تماما، وعلى أساس نظرة واقعية عقلانية إلى الأمور، نظرة تعالج “الواقع” الديني و”الواقع” الفلسفي، بروح نقدية تحترم معطيات الواقع، ولكن دون أن تستسلم له أو تتركه أن يحتويها، بل بالعكس تحرص على احتوائه وتعمل على إعادة بنائه وإخصابه.









