منذ سبعين عاما بالتمام والكمال، في ليلة الثاني والعشرين والثالث والعشرين من شهر يوليو، أي ليلة الثلاثاء/ الأربعاء من عام ١٩٥٢، خرجت مجموعة محدودة من الشباب، متوسط أعمارهم لا يزيد عن الثلاثين عاما لتغيير وجه التاريخ، تاريخ مصر والمنطقة والعالم.
كان حب الوطن وكراهية القهر هو الدافع.. والظلم هو العدو المطلوب هزيمته، ملك فاسد ورأسمالية ظالمة وإقطاع متخلف ومجتمع النصف في المائة هو عنوان مصر في ذلك الزمن.
كانت مصر هي بلد الحُفاة والفقراء والمُعدمين، مصر التي كتب عنها نجيب محفوظ رائعته الحزينة “القاهرة الجديدة” أو “القاهرة ٣٠” وكذلك رائعته البائسة “بداية ونهاية” وما خطه بيده عميد الأدب العربي طه حسين في “المعذبون في الأرض” والتي فضحت الفقر المُدقع والقهر المُقيم الذي كان يعيشه الشعب المصري في تلك السنوات السابقة ليوم الثالث والعشرين من يوليو، وقد صودرت الرواية بأمر الملك فاروق وحكومات عصره الليبرالي، واتهم كاتبها بأنه شيوعي خطر على البلاد والعباد، ولم يُسمح بنشرها إلا بعد قيام الثورة.
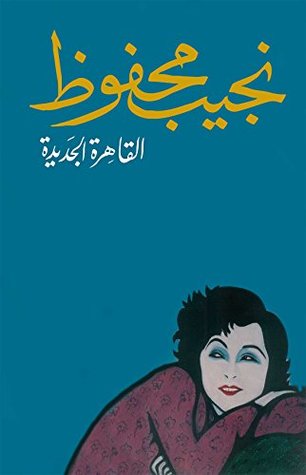
في هذه الاعمال الإبداعية –وأكتفي بالقليل منها على سبيل المثال لا الحصر– كانت الثورة وحيثيات قيامها!
ففي صباح يوم الأربعاء الثالث والعشرين من يوليو عام ١٩٥٢، وللمفارقة الغريبة، يكتب الأستاذ كامل الشناوي مقالا غريبا وعجيبا، يتصدر الصفحة الأولى من جريدة الأخبار القاهرية، وكان وقتها مديرا لتحريرها، كان عنوان المقال هو “مصر تبحث عن رجل”!
كان موضوع المقال وبنص كلماته، تجسيدا لأزمة وطن ومحنة حكم وانهيار طبقة الإقطاع ورأس المال، والتي أسماها عبدالناصر بطبقة النصف في المائة.
كان حال مصر، لا يعبر عنه مقال الأستاذ كامل الشناوي ونبوءته فقط، بل كان هاجس وحلم كل من أمسك بالقلم، وتسلح بضمير وطني صميم، فالأستاذ العميد هو أول من أطلق على حركة الضباط الأحرار اسم الثورة، وليس غيره والأستاذ نجيب محفوظ هو من قال عنها رغم اتجاهاته الليبرالية الوفدية المعروفة، عندما سُئل عن روايتيه السابقتين: “القاهرة الجديدة” و”بداية ونهاية”: “كتبتهما لأفضح النظام الملكي الإقطاعي السابق للثورة، وعندما قامت الثورة وأنصفت العامل والفلاح وأبناء الطبقة الوسطى، أحسست بجدوى ما كتبته، فالأدب والثورة صنوان لا يفترقان”.

أما الأستاذ توفيق الحكيم، فكان له فضل الريادة على هذا الصعيد الأدبي والإبداعي والإنساني، فكتب روايته “عودة الروح” عن ثورة ١٩١٩، ليدعو في ثناياها إلى ضرورة وحدة الصف إذا أردنا أن نطرد الاحتلال البريطاني، رافعا دعوته الشهيرة “الكل في واحد” مُعتبرا ذلك النداء، الذي أخذه من التراث الفرعوني، هو مُفْتاح النصر لمصر في كل تاريخها، فكانت تلك الرواية هي النبع الصافي الذي شرب منه ثوار يوليو، المعاني النبيلة في حب الوطن والإخلاص له.
وبعد الثورة وفي غمار معاركها التي امتدت إلى أركان الأرض، في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، من باندونج في أقصى الشرق إلى هافانا في أقصى الغرب، نسجت الثورة مع جيل جديد من الأدباء وبصحبة هؤلاء الكبار، معركة البناء والتحرر، فمع يوسف إدريس قرأنا روايته البديعة “قصة حب” والتي عرفت طريقها إلى شاشة السينما باسم “لا وقت للحب” لتؤرخ لمعركة الوطن في حربه ضد المحتل البريطاني.

وكذلك نجد إسهامات فتحي غانم النقدية كما جاءت في “الرجل الذي فقد ظله” وعبد الرحمن الشرقاوي وإحسان عبد القدوس وصلاح جاهين وفؤاد حداد وصلاح عبدالصبور والأبنودي وأحمد فؤاد نجم… وغيرهم في أكثر من عمل إبداعي، سواء كانت رواية أو قصة قصيرة أو قصيدة شعر.
كان صوت مصر الجديدة، والذي صاحب كلمات وإبداعات الآباء المؤسسين، فكتب محفوظ أعماله الإبداعية الناقدة للثورة مثل “ميرامار” و”ثرثرة فوق النيل” وروايته البديعة “الشحاذ” التي جسدت أزمة المثقف والسياسي اليساري، في مجتمع التحول الاشتراكي، فقد بدا غريبا في وطن يسعى لتحقيق حلمه في بناء العدل والحريّة.
وأسهم توفيق الحكيم في مناقشة أزمة الحكم في مسرحيته “السلطان الحائر” وكانت في عقب أزمة مارس ٥٤ بعدة سنوات، ثم نقده لتضخم دور الأجهزة الأمنية في مطلع عقد الستينيات، في عمله الرائد “بنك القلق” والذي أسس به نوعا جديدا من الإبداع أسماه “مسرواية” إذ جمع فيه بين فن الإبداع المسرحي، وفن الإبداع الروائي.
أما الأستاذ العميد فقد لخّص المعضلة الثورية في ضرورة “تلازم العدل الذي جاءت به الثورة مع الحرية التي تطمح اليها الثورة”.
كانت دعوة طه حسين، استشعارا لمتطلبات مرحلة جديدة من عمر الوطن، وبدا الأستاذ فتحي غانم رائدا في عمله الرائع “زينب والعرش” مُناقشا بكل جرأة قضية حرية الصحافة في سنوات الستينيات، موجها سهام النقد إلى تجربة تأميم دور الصحف مثل: دار أخبار اليوم ودار الهلال ودار روزاليوسف… وغيرها.

أما الأستاذ عبد الرحمن الشرقاوي؛ فكتب عن مصر السابقة لقيام الثورة، بإبداعه الخالد رواية “الأرض” ومسرحيته النقدية لسلطة يوليو “الفتى مهران” عن علاقة قائد الثورة بالجماهير، وكان الرمز فيها واضحا وكاشفا، فكان المقصود فيها هو جمال عبد الناصر والقضية هي سلطة الحكم، وكانت حرب اليمن والدور المصري العسكري والحضاري في هذا البلد العربي العزيز، تلقي ببعض تفاعلاتها عَلى الحياة الثقافية والسياسية المصرية والعربية آنذاك.
ويدخل الأستاذ لطفي الخولي الكاتب الماركسي الساحة فيبدأ بـ”القضية ٦٨” مُناقشا فيها ما سُميّ حينها وبعد سنوات هزيمة ٦٧ بقضية المجتمع المفتوح، وشاركه من موقع الدراسات الأدبية النقدية أساتذة كبار مثل الدكتور لويس عوض ناقدا نظام التعليم المصري، مُقارنا إياه بنظام التعليم الفرنسي، ومُتحدثا عن الاشتراكية والأدب وعارضا لمعضلة التحول الاشتراكي في مجتمع يُعاني من مشكلات الحرية في التعبير الأدبي والبحث العلمي.
أما الدكتور حسين فوزي فيُتحفنا بعمله الخالد “سندباد مصري” ليضعنا أمام قراءة جديدة ومنهج جديد لقراءة تاريخ الوطن، إلى الحد الذي وصف مُفكرنا الكبير أنور عبد الملك في كتابه “مصر: مجتمع جديد يبنيه العسكريون” بأنه أهم وأخطر كتاب في النصف الثاني من القرن العشرين عن تاريخ مصر.
وإذا كان كتاب حسين فوزي على هذا النحو الخطير، بوصف الدكتور عبد الملك؛ فإن الدكتور زكي نجيب محمود فيلسوفنا الكبير، حاول أن يستكمل ما بدأه صديقه حسين فوزي، وإن كان على صعيد فلسفي واجتماعي، لا تاريخي سياسي، فجاء كتاباه “قصة عقل” و”قصة نفس” أكمل صورةٍ وأعظم بيانٍ لتكامل حوار فلسفي وتاريخي بين قمتين كبيرتين، ولم يقف الدكتور زكي عند هذا الحد، إذ استكمل عمليه السابقين، وهما في الأصل سيرة ذاتية، بكتابيه الخطيرين “مجتمع جديد أو الكارثة” و”تجديد الفكر العربي”.
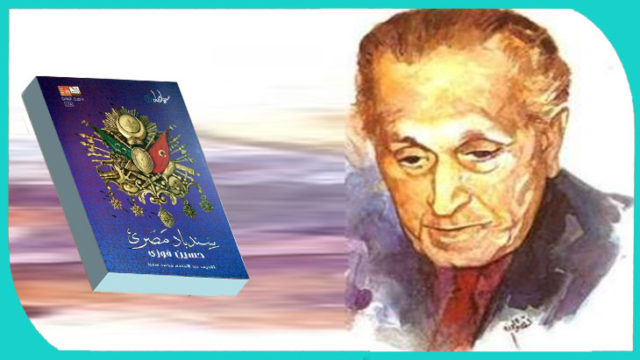
أما مؤرخنا الموسوعي الكبير حسين مؤنس صاحب موسوعة “قريش” فلم يترك البيروقراطية المصرية في حالها، فكتب رائعته الروائية “إدارة عموم الزير” ساخرا من الدور التخريبي الذي تقوم به هذه الفئة من الموظفين التقليدين الذين لا يدركون معنى الحضارة والحداثة والتقدم! وبعد ذلك كتب الأستاذ “الخولي” بالمشاركة مع صديقه المخرج الكبير يوسف شاهين فيلمهما المُشترك “العصفور” والذي ناقشا فيه ما يمكن تسميته بأزمة الثورة والثوار، وبناء الاشتراكية بدون اشتراكيين!
وهي كلمات عبد الناصر نفسه الذي كان الناقد الأول لتجربة الثورة والسلطة، فقد حذّر من خطر الثورة المضادة عند منتصف عقد الستينيات من القرن الماضي، محددا جوانب النجاح وبعض أوجه الفشل “نجحنا في تأميم قناة السويس وبناء السد العالي، وفشلنا في إدارة مستشفى القصر العيني!”.
والعودة إلى مناقشات عبدالناصر في مؤتمر المبعوثين الذي عُقد في رحاب جامعة الإسكندرية صيف العام ١٩٦٦، تُقدم لنا أكثر من دليل عَلى جُرأة وشجاعة الرئيس في نقد التجربة الوطنية والتحديثية التي يقودها في وطنه.
ولم يكن الأستاذ محمد حسنين هيكل رئيس تحرير الأهرام الأشهر وصديق عبد الناصر، بعيدا عن تلك التحولات، فكتب في مطلع الستينيات وقبل صدور “الميثاق” عن “أزمة المثقفين” وبعد النكسة كتب عن المجتمع المفتوح وأزمة التنظيم السياسي الواحد وزوار الفجر فضلا عن كتاباته النقدية الحادة التي تناول فيها جوانب الإخفاق والفشل في حرب يونيو ٦٧، والتي أظن لجرأتها وعنفها قد نشأت فكرتها بالحوار مع الرئيس عبد الناصر.
وفي الوقت نفسه شارك الرائع أحمد بهاء الدين في تلك المعركة، فقد أعاد نشر كتابه الرائد “إسرائيليات” المنشور في عام ١٩٦٥، تحت عنوان جديد وهو “إسرائيليات وما بعد العدوان” وألحقه بكتاب “اقتراح دولة فلسطين” في عام ٦٨، ثم أتبعهما بكتابه “ثلاث سنوات” وهو تأريخ سياسي واجتماعي بل وعسكري لحرب الاستنزاف العظيمة، ولكن من المهم الإشارة إلى سلسلة من الكتابات الطليعية والتحديثية ، قام بنشرها الأستاذ بهاء الدين عندما كان رئيسا لمجلس ادارة مؤسسة الهلال في سنوات الستينيات، وهي ربط التحولات الاجتماعية التي يتعين على الثورة خوضها بالتقدم العلمي والتكنولوجي الدولي، إذ كتب سلسلة مقالات صدرت بعد ذلك في كتابين هما “هذا العالم” و”اهتمامات عربية” كانت سلسلة المقالات هذه تحت عنوان جميل لم أنسه أبدا، هو “الكلامولوچيا والتكنولوجيا” طبعا “إحنا بتوع الكلامولوچيا، والعالم المتقدم هُما بتوع التكنولوجي” وعلى نفس النهج ولكن من منظور فلسفي ماركسي، كتب الأستاذ محمد سيد أحمد سلسلة دراسات في صفحة الرأي بالأهرام ومجلة الطليعة اليسارية، كان عنوانها “أزمة الأيدولوجيا وآفاق التكنولوجيا” كان نقدا طليعيا بكل المقاييس، كان نقدا للتجربة المصرية في التحول الاجتماعي، وكان نقدا رائدا شجاعاً للنظرية الماركسية في العالم كله.

ثم يدخل العبقري جمال حمدان الميدان فيصدر كتابه الخطير “شخصية مصر: دراسة في عبقرية المكان” وتاريخ صدوره الخامس من يونيه ٦٧.
الأمر الذي يثير الدهشة عن مدى إدراك حمدان لأهمية مصر، الموضع والموقع والدور وليكشف عن المعدن الأصيل للشخصية المصرية، غير أنه تحدث عن قضية أساسية وخطيرة هي معالم التغيير الاجتماعي في مجتمع نهري، وهو الموضوع الذي لفت نظر واهتمام طائفة من المفكرين المصريين الماركسيين وغير المصريين، عن موضوع “النمط الآسيوي للإنتاج، أو ما يسمى “الإقطاع الشرقي” وقد كتب وأسهم في ذلك طائفة رائعة من مفكري مصر والعرب، منهم فؤاد مرسي وسمير أمين وأحمد صادق سعد وإسماعيل صبري عبد الله ومهدي عامل وحسين مروة اللبنانيين وصادق جلال العظم وجورج طرابيشي السوريين، وإن كانا من زاوية فلسفية/اجتماعية، أكثر منها زاوية اقتصادية.
وإذا اكتفينا بإطلالة سريعة عن تلك الدوريات الفكرية والثقافية التي واكبت سنوات التحول إلى الاشتراكية، لأدركنا قيمة ومعنى الإنجاز الثقافي للثورة، فيُكلف الأستاذ لطفي الخولي بإصدار مجلة “الطليعة” لتكون منبرا واضحا وصريحا لليسار المصري، وتحديدا اليسار الماركسي، في الوقت الذي يصدر عن نفس المؤسسة الصحفية، أي مؤسسة الأهرام، وفي زمن الأستاذ هيكل، دورية ربع سنوية علمية وأكاديمية، تختص بشئون الصراعات الدولية، وهي مجلة “السياسة الدولية” ويترأسها مفكر ليبرالي كبير هو الدكتور بطرس غالي.
في الوقت الذي تتولى وزارة الثقافة في عهد الدكتور ثروت عكاشة أهم وزير ثقافة في تاريخ مصر والعرب الحديث، مجموعة من الإصدارات الثقافية والسياسية الشهرية والدورية، منها مجلة “الكاتب” برئاسة المفكر القومي الكبير أحمد عباس صالح؛ لتكون المنبر المواجه لمجلة “الطليعة اليسارية” أو تحديدا استكمالا لاجتهادات الطليعة، ويُكلّف في الوقت نفسه الدكتور زكي نجيب محمود ويعاونه زميله وتلميذه الدكتور فؤاد زكريا بتأسيس وإصدار أول مجلة مصرية وعربية تناقش قضايا الفكر الفلسفي بكافة مدارسه، وهي مجلة “الفكر المُعاصر” لتُلقي بالضوء عَلى تلك العلاقة الغامضة والمُعقدة، بين الفلسفة ومجتمع يمر بمرحلة تحول اجتماعي شامل وخطير.

ولم تتوقف خارطة الثقافة وتلك المعركة الفكرية والفلسفية عند هذا الحد، وتحديدا وفي وطن يسعى للتحول، ويطمح في بناء مجتمع الكفاية والعدل؛ فكان تطوير ما يعرف الآن بالخطاب الديني، هدفا لمؤسسة الأزهر العريقة، وشيخها العملاق، فضيلة الدكتور محمود شلتوت صاحب ومؤسس “هيئة التقريب بين المذاهب الإسلامية”، فقد صدر عن مجمع البحوث الإسلامية في عهده أُمهات الكتب والدوريات الإسلامية، منها أعمال رائدة مثل “الاشتراكية في الإسلام” للعلامة السوري الشيخ مصطفى السباعي، وكذلك البحث الرائع “العسكرية الإسلامية” للفريق الركن محمود شيت خطاب ابن العراق الشقيق، فضلا عما تحمله وتنشره دورية الأزهر “منبر الإسلام” والتي تحمل اجتهادات كبار العلماء والفقه الإسلامي، سواء من مصر أو من عموم العالم الإسلامي.
ثورة ضخت دماء الحياة في طبقات ظُلمت وقُهرت عبر عقود وعهود طالت وامتدت، وفتحت آفاق من التحرر والثورة في كل مكان، كانت بالنسبة لمصر قبل يوليو ٥٢ لا يأتي ذكرها إلا مقروناً بالكوارث والأمراض والاستعمار.
ثورة كانت تتويجا لدعوة قادة الفكر وأعلام الإصلاح قبل اندلاعها، وإثر قيامها وبناء دولتها، سارت في رفقة الفكر والأدب والإبداع، وحافظت على قوة مصر الناعمة، وطورت من وسائلها وأدواتها ورجالها، وأضافت إلى نُخبتها المُثقفة، عشرات الملايين من المثقفين والمُتعلمين والعلماء والباحثين.
فمع الثورة تحققت دعوة وحلم الأستاذ العميد في كتابه الرائد “مستقبل الثقافة في مصر” حيث دعا في ثلاثينيات القرن الماضي إلى أن يكون “العلم ضرورة للمواطن المصري، كضرورة الماء والهواء للإنسان…”.
رحم الله جمال عبدالناصر ورفاقه من قادة الثورة ورجالها، وكان فارسها المثقف والنبيل خالد محيي الدين آخر قادتها الذي لحق بقائدها وباقي زملائه إلى رحاب الله.
أما قادة الفكر وأمراء الكلمة ، فقد تركوا لنا ما نُفاخر به الأمم من إبداع صادق وإحساس رقيق ونقد بناء، كان هاديا ومُرشدا للثوار في كل زمان وعصر ومكان.













