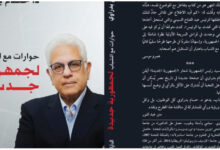هو المتحكم الأول في الكثير من الأمور في حياتنا بشكل يومي وإذا شئت الدقة فإنه الحاكم بأمره على مدار الساعة حيث يرفع أقواما إلى السماء، ويهبط بآخرين إلى “سابع أرض“، لا يحتاج الأمر قدرا كبيرا من التخمين أو الدراسة حتي ندرك التأثيرات الهائلة لـ “التريند“.
“التريند” في حد ذاته ليس شيطانا ولا ملاكا، فهو باللغة الرقمية التي تحكم كل شيء في حياتنا اليوم؛ تعبيرٌ عن أكثر القضايا التي تشغل عقول الناس على مدار الساعة والتي تقوم عناكب جوجل، ومواقع التواصل المختلفة برصدها بشكل لحظي، تحدد على أساسه قائمة بأكثر القضايا رواجا.
ما المشكلة إذن؟ من الناحية النظرية لا توجد ثمة مشكلة على الإطلاق، ولكن أي محلل للصورة في مجملها لا يمكنه أن يغفل ذلك الجدل اليومي الذي يحتدم على “التريند” ومن يصنعه ومن يتحكم فيه؟ والتأثيرات التي يتركها على طريقة تفكير الناس، وترتيب اهتماماتهم خاصة عندما يصبح “التريند“ ساحة خلفية لتسطيح الفكر بحسب ما يراه بعض المعنيين بالشأن الثقافي، والذين يرون أن الوعي العام تخلقه حالة من القراءة الأكثر عمقا بعيدا عن تغريدات“السوشيال ميديا“ التي تفتقد المعلومة فيها –في كثير من الأحيان– لأبسط معايير التوثيق والتحقق منها؛ ورغم ذلك تلقى رواجا واسعا خلال دقائق معدودة.
لا يمكن في هذا الصدد أن نتجاهل هوس “التريند” الذي أصاب قطاعات واسعة من المشاهير خاصة في الوسط الفني، والذين لدى البعض منهم استعداد لفعل كل شيءمن أن أجل أن يظلوا ممثلين في “التريند“ بصورة دائمة بداية من حلق الشعر “زيرو”، وحتى إفشاء أدق تفاصيل العلاقات والخلافات الزوجية الخاصة بهم.
في ظل هوس “التريند” تقترف الكثير من الجرائم المجتمعية، التي تنال من قيم المجتمع وثوابته.. كما رأينا في فيديو المشرحة لـضحية جريمة جامعة المنصورة “نيرة اشرف” وفي مشهد تكالب البعض تسجيل لحظات انهيار جدتها في الجنازة.
ليست هذه السطور من أجل إدانة “التريند“ أو تحميله جرائم كثيرة اقترفها آخرون باسمه، وإنما هي من أجل أن نقف جميعا، كتابا ومفكرين ومثقفين وفنانين وقراء مع أنفسنا لحظة، وأن ندرك المصير الذي ينتظرنا، إذا ظلت الأمور تراوح مكانها، وبقينا داخل الدائرة نفسها حيث يظل وعي الناس العام أسيرا للتريند الذي تغيب عنه الكثير من قضايانا الأكثر إلحاحا، خاصة ما يتصل منها بالهوية والتنوير والتنمية ونشر الوعي الثقافي.
لا يجب أن تظل ثقافة “التريند“ بصورته الحالية هيالحاكمة للإطار العام لتفكيرنا فـ “التريند“ وحده لا يجب أن يكون البوصلة التي تحرك الأجيال القادمة؛ التي ندخرها من أجل مستقبل أفضل لهذا البلد يليق بما يملكه من تراث حضاري وثقافي لا نظير له.
أخشى إذا تباعدت المسافات أكثر بين الشباب وقضايا الوطن والهوية الكبرى، أن ندفع ثمنا فادحا على المدى الطويل، لتسطيح الوعي وأن تولد أجيال كاملة تعيش حالة من القطيعة مع الموروث الفكري والحضاري للبلد.
في السياق نفسه.. على المثقف أن يجاهد للخروج من عزلته، وأن يتخفف بعض الشيء من أوهام النخبوية التي تجعله في كثير من الأحيان غارقا في قراءاته.. عاجزا عن التواصل مع الشباب الذي يراه عزوفا عن القراءة الجادة، وليس في حياته سوى إدمان الموبايل والمستحدثات التكنولوجية.
المثقفون مطالبون بقدر أكبر من أجل استثمار “التريند“كي تصل المعرفة إلى كل بيت، وأن يعود الجميع إلى القراءة، ولو لدقائق معدودة كل يوم؛ فبدون القراءة لا يمكن أبدا أن نتفاءل خيرا بالمستقبل، فالمعرفة أول خطوة في طريق النهوض الحضاري.
يجب أن يتحرك المثقفون سريعا؛ فاستيراد الأفكار والمفاهيم التي تتصادم في كثير من الأحيان مع قيم وتقاليد المجتمع الراسخة أشد خطورة بكثير من استيراد السلع ومخرجات التكنولوجيات الغربية التي لا يخلو منها بيت من بيوتنا اليوم.
لم تغب الثقافة عن “التريند“ بالكلية فقد كانت حاضرة مؤخرا في أغلفة روايات أديبنا الأكبر نجيب محفوظ الصادرة عن دار ديوان وما خلفته من جدل واسع، ولكن يظل تمثيل الثقافة في “التريند“ بالمجمل هامشيا وثانويا لأسباب كثيرة ولا يقارن على الإطلاق بذلك الحضور القوي والدائم للرياضة ومشاكل الفنانات الزوجية وخناقات ومعارك من يسمون بنجوم الأغنية الشعبية وغناء المهرجانات.
نحتاج إلى أن يفكر الجميع في كيف نفك الحصار المفروض على الثقافة الجادة بـ “التريند“ وكيف يمكن في الوقت نفسه استثماره من أجل الوصول إلى أجيال من الشباب المتعطش للمعرفة، قبل أن تغرق في بحر التسطيح والتفاهة.