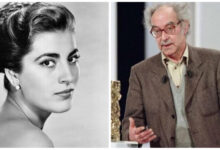عام سبعة وسبعين قطعت دراستي واكتفيت بالثانوية العامة؛ بسبب وفاة والدى وعدم وجود مورد مادي، لمواصلة تعليمي أنا وباقي إخوتي الخمسة، الذين كانوا يصغرونني بسنوات، وكان قدري أن أكون أكبرهم وأقدرهم على تحمل المسئولية، وتفاصيل أخرى ستنسيني الموضوع الأصلي إذا ما واصلت سردها الآن.
المهم أنني تقدمت بشهادة الثانوية العامة للعمل في بنك التسليف، ودونما مزيد من التفاصيل قُبلت وعُينت في غضون شهرين من تقديم الطلب.. رغم أنني ثانوية عامة أدبي؛ لكن تصادف أن البنك كان وقتها في طور التوسع، ويبحث عن موظفين، ولم تكن هناك مشكلة بطالة ضاغطة على سوق العمل.. ثم أنه يبدو أن رئيس مجلس إدارة البنك وقتها، قد ترفق بحالي عندما وقفت أمامه حاملا أوراقي قائلا له: أنا والدي -الله يرحمه- كان يعمل في البنك، وأنا سحبت أوراقي من مكتب تنسيق الجامعات، وأريد أن أعمل لأرعى والدتي وإخوتي، ولدى إعفاء مؤقت من التجنيد لأنني عملت كشف عائلة.
كنت أحد موظفين جديدين في بنك التسليف، الأول كان اسمه حسن وكان يحمل مؤهلا أعلى هو البكالوريوس، وأنا الذي كنت أحمل شهادة الثانوية العامة؛ فاستدعى مدير البنك حسن أولا ووجهه للعمل مع عم عبده زغلولة مساعدا، فخرج حسن غاضبا وتناول ورقة “فلوسكاب” من أحد الزملاء وهو يصيح: “بقي أنا خريج الجامعة ومعايا شهادة بكالوريوس يودوني اشتغل تحت إيد راجل خريج محو أميه؟
مش مهم هأعيد تقديم ورقي للقوي العاملة، وهأكتب رغباتي على مكان تاني غير بنك التسليف”.
كتب حسن استقالته، وعلمت بعدها بسنوات أن إدارة القوى العاملة قد وظفته إداريا في التأمين الصحي بعد أن رفض العمل مع عم عبده زغلولة لفترة ربما أرادها مدير العمل أن تكون فترة تدريب وتأهيل وصقل خبرات.
وجاء دوري أنا فقبلت العمل مع عم عبده زغلولة دونما أي تبرم أو اعتراض.. رغم أن البعض من الزملاء كان قد همس بأذني بحكاية “سفاح كرموز” إلا أنني لم أكن أمتلك لا قوة ولا ترف الرفض.. لم أكن أملك سوى التشبث بالوظيفة التي حصلت عليها.
ذهبت مع عم عبده زغلولة الذي نظر إلى دونما إبداء أي مشاعر عاطفية وبمنتهي الجدية قال: اسمع يا ابني، الساعة ثمانية الصبح بالضبط ألاقيك عند باب الجمعية الزراعية.. تمانية وخمسة لأ.. أنت هتشتغل مع عبده زغلولة.. عاوزك تتعلم تسمع كلامي كويس، مش عاوز.. يبقي ذنبك على جنبك، ياللا رَوّح أنت دلوقتي عشان تجييني بكرة في الجمعية.
في الثامنة تماما من صباح اليوم التالي كنت اقف علي باب الجمعية الزراعية للقرية والذي كان مغلقا في انتظار أن يفتحه عم عبده زغلولة، فوجدت فتاة صغيرة تقترب مني وتسألني: الأستاذ حمدي؟ عمك عبده زغلولة بيقولك هوه مستنيك في البيت وعاوزك تيجي معايا دلوقتي.
كانت المهابة التي أسقطها عم عبده زغلولة داخلي يوم أمس كفيلة بأن أذهب مع الفتاة الصغيرة دونما أي تساؤل. كان الوقت شتاءً، وكان شتاءً قارسا، وكنت أعاني من قصور في الدورة الطرفية الدموية يجعل أطرافي تتجمد عند تعرضي للبرد ويصبح لونها متراوحا ما بين الأزرق والأصفر الباهت.
ادخلتني البنت الصغيرة التي اتضح لي أنها ابنة عم عبده زغلولة– الغرقة التي كان والدها جالسا فيها وسط أولاده وبناته وزوجته.
سلمت علي عم عبده زغلوله الذى قال لي: أقعد.
قلت: سأنتظرك في الخارج عند الجمعية.
فصاح بي أو بمعني أدق “شخط فيا” في لهجة آمرة قائلا: بأقولك أقعد.
جلست إلي جوار عم عبده زغلولة حيث كان يجلس مع أولاده وزوجته علي الأرض المغطاة بقطع فرو الأغنام فوق “الكِلِيم” الذى هو عبارة عن سجادة كانت تنسج من وبر الأبل والخراف في أنوال مدينة فُوَّه تلك المدينة القديمة الصغيرة التي تقع على شاطئ النيل المقابل للشاطئ الذي تقع عليه قرية عم عبده زغلولة الذي أمسك بكفي وهاله درجة برودتهما وتجمدهما، فسألني كيف أتعامل معهما وكيف سأمسك القلم وأعمل بهما، فأخبرته بأن كل هذا سينصرف بمجرد التدفئة، فطلب من زوجته التي كانت تجلس أمام “وابورين” من الغاز مشتعلين أحدهما كبير عليه إناء اللبن، والآخر صغير يرتكز عليه غلاي شاي كبير كانوا يسمونه “بَكْرَك” وبجوارهما أبرمة الأرز الصغيرة الخارجة من فرن الأمس، والتي تبيت في الفرن المنطفئ بعد العشاء أو يوقد من أجلها الفرن بعد صلاة الفجر خصيصاً للإفطار. طلب الرجل من زوجته أن تضع الوابور المشتعل على “بكرك” الشاي أمامي مباشرة، و”شخط فيا” بصرامة أقل في هذه المرة: يلا قرب إيدك من الوابور ودفيها.
فقربت كفيَّ من النار واشتغلت بعملية فركهما، ثم بسطتهما بالقرب من حرارة النيران حتي شعرت بدبيب سريان الدماء في الأوعية الدموية لأطراف يدي، وحل الاحمرار محل اللونين الأزرق والأصفر اللذين كانا يهيمنان عليها، وبدأت أشعر بأصابع قدمي تدب فيها الحياة على إثر اقتراب وابور الجاز مني، وهممت بالاستئذان للانصراف إلى الجمعية، فإذا بعم عبده زغلولة يكرر شخطته: أقعد.مش هتقوم إلا ماتفطر معانا.
رددت عليه شاكرا بأنني تناولت فطوري في المنزل.. رد بحسم وكأنه لم يستمع إلي من الأساس: أقعد. أنت هتشتغل معايا، وأنا اللي يشتغل معايا لازم أحط في رقبته دين العيش والملح.. يا طلع ابن ناس و”تمر” فيه العيش والملح، يا طلع ما يستاهلش.. واستأنف: حطي الأكل يا حاجة، وحطي قدام الأستاذ حمدي برام رز وصُبّي له عليه لبن سخن عشان يدفيه.
أحسست بخليط من الاختناق وقلة الحيلة والخجل وفقدان العزم، على مواجهة هذا السياق غير المنطقي بالنسبة لي، في مواجهة هذا الرجل الذي فاجأني بصورة آدمية مربكة، وبنمط من السلوك والكلمات أربكت ردودي عليه، فامتثلت لهيبته وتناولت معه ووسط وأولاده وزوجته الإفطار، وبعد أن ناولتني الحاجة أم صبحي زوجته كوب شاي كبير باللبن أعقبته بكوب شاي سادة صغير ضمن أكواب الشاي الصغيرة التي دارت على الجميع، تناول عم عبده عباءته السوداء على كتفه بالرغم من أنه يرتدي بالطو فوق الجلباب، ثم تناول عصاته الخيرزان ذات المقبض العسلي الداكن بدوائره الصغيرة الغائرة، وحمل حقيبته المنتفخة بالدفاتر وهَمّ واقفا وقائلا: يلا بينا نتوكل على الله.
رددت: ونعم بالله. وقمت معه وسرنا إلى الجمعية، وعندما وصلنا تناول مفاتيحه وفتح باب مقر مندوبية بنك التسليف، وأشار إلى كرسي خشبي بجوار مكتبه آمرا إياى بالجلوس، ومتابعة كل ما يكتب وكل ما يفعل، بعد أن بدأ بكلمات كأنه يضعها كخطوط لأساسيات تدشين بدء العمل.
– كلنا عيش وملح مع بعض.. وقعدتك وسط عيالي في داري وبقيت واحد منهم،
هنا بقي في الشغل ما فيش مواعيد رسميه، إحنا هنشتغل لغاية ما يخلص الشغل إنشاء الله الساعة واحدة الصبح.
وهكذا ظللت لأسبوع لا أفعل شيئا سوى متابعة قلمه، ثم بدأت أساعده في توزيع مقررات الأسمدة والتقاوي علي الفلاحين، كلٌ حسب حصته المقررة في كشف يسلمني إياه كلما فرغ منه. ويوميا عند الظهيرة كانت ابنته تأتي بصينية نحاسية عليها أرغفة ساخنة وغموس يتراوح ما بين الجبن والقشدة وعسل النحل، وبعض الخضروات ، وأصر كل مرة على أنني لا أشعر بالجوع، وأنني سآكل في البيت فيكون رده: كُلْ ما فيش بيت.. قلت لك إحنا بـ نتأخر ف الشغل.. وبعدين أنت بقيت واحد من ولادي.. عاجبك ولا مش عاجبك؟
فأرد عليه: لا طبعا عجبني يا عم عبده، وده شرف ليا طبعا.