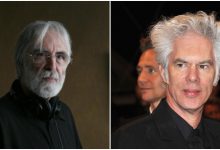قرية “سنبادة” التي انتدبني إليها بنك التسليف الزراعي مساعدا لعم عبده زغلولة، قرية صغيرة تفصل بينها وبين مدينة المحمودية شركة مشروع توليد كهرباء العطف، والتي تقع عند نقطة بداية تدفق مياه النيل (فرع رشيد) في بداية مجرى ترعة المحمودية؛ ولذلك فهي تعتمد على المياه في توليد الكهرباء، وقد تغير اسمها فيما بعد إلى محطة توليد كهرباء المحمودية، بينما ظل اسمها الدارج الذي يعرفه الناس في المحمودية حتي وقت قريب هو “المشروع” وكذلك جانبا من مصنع غزل القطن التابع لشركة كفر الدوار، وربما كان هذا الجوار كان سببا في توظف كثير من أبناء هذه القرية، عمالا وكموظفين في الشركة والمصنع، فكانوا يخرجون من الوردية ليستبدلوا بالأڤرولات الجلاليب، ليزرعوا قراريطهم الصغيرة أو ما يحوزون من قطع الكنارات المنتشرة بطول حافة النيل، حيث كانت تطل هذه القرية الصغيرة على نهر النيل؛ لتبدو كما لو كانت قد تمددت طوليا في حضن مياه النيل، وكان منهم من يأتي إلى الجمعية بالأڤرول مرتديا طاقيته، وهذا ما أضفي على طبيعة أهل القرية سمات خاصة؛ يتسمون بها عن باقي الأرياف فهم هادئون منظمون قليلا ما تجد بينهم المتعالي أو المتعجرف أو حاد الطباع، وربما كان وجودهم في حضن النيل سببا من أسباب طباعهم الهادئة، وكرههم لافتعال المشاكل والصراعات التي كانت تحتدم في بعض القري ما بين العائلات بسبب تشابك حدود حقل مع آخر أو مشاية أو قناية ماء أو خلاف على حصة تدوير الكباس (الساقية التي كان تدار بالبهائم لتروي الغيطان) لدرجة أنه لا يوجد في ذاكرة الناس، في كامل مركز المحمودية التابعة له قرية سنبادة أية حوادث أو قضايا شهيرة يمكن تداولها عبر تاريخ هذه القرية النائمة في حضن النيل.
كانت ثقة عم عبده زغلولة في الاعتماد عليّ قد تزايدت؛ فكف عن تلقيني دروس العمل.. ويبدو أنه قد قرر الانتقال إلى تدريبي وصقلي من خلال تقسيم العمل بيننا، ومباشرة التجربة والخطأ أمام ناظريه.
أنا أفتح الجمعية صباحا وهو يتوجه إلى بنك التسليف الذى كان قد اسند إليه مندوبية إلى جوار سنبادة في قرية أخرى تسمى “اللوية” نظرا لظروف ترقية مندوبها إلى وكيل بنك قرية مع بدء نظام بنوك القرى الزراعية، وكان يذهب إليها يومين في الأسبوع، كان يعتمد علي فيهما، فتأتي أيام التسويق التعاوني التي تقتضي العمل المتواصل من الصباح المبكر، لتمتد إلى ما بعد العشاء. كان عم عبده زغلولة يذهب إلى البنك ليستلم كشوف مقدمات الأثمان للمحاصيل التي سلمها المزارعون، وكذلك كشوف نهائيات أثمان المحاصيل بعد فرزها وتقييمها بمعرفة لجان التسويق المختصة، ويستلم العهد المالية المترتبة على هذه الكشوف من استحقاقات، وكان نظام البنك يقتضي أن نقوم بتسليم هذه المبالغ لأصحابها المزارعين وفقا لكل استحقاق محصولي تم توريده، على أن تسلم الكشوف والتوقيعات، وأن تسوى العُهد في صباح اليوم التالي مباشرة، كانت الجمعية الزراعية تمتلئ عن آخرها بالمزارعين لدرجة أننا كنا بالكاد نتنفس الهواء من شباك جانبي يطل على مكتبينا المتجاورين في الغرفة، لم يكن بيننا وبين هذا الازدحام أية فواصل غير حدود المكتب الذى كانت تستند عليه بعض أيادي المتزاحمين التي لم تكن تتراجع إلا إذا ما نفخ عم عبده نفخته المعتادة، وخبط على مكتبه بكفيه فيتراجع المتزاحمون خطوة للوراء، وكنت عندما أصيح في الواقفين “يا جماعه ما يصحش كده، أدونا فرصه ننده على الأسامي” كان ينظر إلى ويدوس بقدمه على قدمي المجاورة لقدمه قائلا: “مالكش دعوه بيهم.. إنده الأسامي أنت بس وسيبنى أنا أنظمهم”.
لم يكن ينطق بعد إطلاقه لنفخته وخبطة كفيه علي مكتبه سوي كلمة “وبعدين؟” فيتراجع الواقفون خجلا، لم يكن يسمح لأي أحد بطلب استثناء يسبق به دور أحد آخر، إلا في حالات كبار السن الذين لا يستطيعون التحمل أو العجائز، وكان يخصص الساعات الأولى للقبض للسيدات والرجال العجائز فقط، بعد أن أكون أنا قد قرأت على رؤوس الأشهاد الحاضرين أسماء من وردت أسماؤهم في كشوف الاستحقاقات؛ لكي ينصرف من لم يرد اسمه من أول النهار.. والحاضر كان يبلغ الغائب فيأتي، وهكذا.
كنت أتولي التحقق من شخصية المزارع عبر بطاقته الشخصية، وآخذ توقيعه وأتلو على عم عبده المبلغ المستحق له بالجنيه والقرش والمليم، وهو يدون في كشفه المسطر لهذا الغرض ويقوم بتسليمه المبلغ لنطابق الكشفين, بعد انتهاء تسليم الاستحقاقات ونقوم بالعمليات الحسابية ونطابق كشوف العهدة علي المنصرف من المبالغ تارة والمتبقي منها تارة أخرى.
كان عم عبده يحرص على إعطاء كل مستحق حقه ولا يهمل كسر الجنيه، كان يصيح فيمن يحاول الانصراف اكتفاءً بصحيح المبلغ من جنيهات
– جرى إيه يا سي (يذكر اسمه) أنت هتبقشش عليا ولا إيه، ثم ينهره قائلا خد باقي فلوسك.
كان يشترط على موظف خزينة البنك أن يسلمه ضمن ما يسلمه من عهدة ما يقترب من مائة جنيها تتراوح ما بين فئات القرش والخمسة قروش والعشرة قروش، وإذا لم يكن ذلك كان يعطيني مائة جنيهاً عند الانصراف لأقوم بتحويلها إلى فئات القروش المعدنية من تجار الجملة في المدينة على أن آتي بهم في صباح اليوم التالي.
كان يقول لي عندما نجلس آخر النهار: “أنا عارف إنك ابن ناس وواثق فيك.. بس عاوز أقولك حاجة حطها حلقة في ودانك طول العمر، أوعي تخلي حد يكسر عينك بفتفوتة، أو حتي بمال الدنيا، ولو ف يوم ممعاكش أجرة السكة استلف أو خدها مشي، وما تبصش لعهدتك أو لأي فلوس من حد”.
وقتها عرفت لماذا كانت الناس في سنبادة تحترمه وتهابه، وكيف تتسامح مع نفخاته في ووجوههم وكيف تتفهم صرامته، ولا تضمر تجاهه إلا مشاعر الإجلال والمودة.
عندما بدأنا نتسامر على المقهى قال لي: “أسمع دول ولاد بلدي، ناس طيبين ذي ما أنت شايف، بس أنا لو اشتغلت بالعواطف الدنيا هتخرب مني، والقادر هياخد حق اللي مش قادر.
ظننت للحظة ما أن عم عبده زغلولة يهتم بالسياسة والعمل العام لأنه كان يسعي مع الساعين من قريته لأي مصلحة خدمية حكومية تعود على القرية بخير.. قال لي عندما سألته عن علاقته بالعمل العام: “اسمع.. أنا آخر حاجة فاكرها إنهم حطوني عضو في لجنة وحدة الاتحاد الاشتراكي عندنا، ومن بعد ما اتحل الاتحاد الاشتراكي، ما رحتش أي حزب وما ليش دعوة بالسياسة خالص ولا بحبها، أنا راجل على قدي وعندي ولاد ومش غاوي بهدلة وقلة قيمة وكلام فاضي”.
بهذا القول قطع عم زغلولة كل هواجسي حول أنه يقوم بدوره الاجتماعي في القرية لقناعة سياسية ما، أو تحينا لفرصة تبوء مكانة ووجاهة سياسية، وتأكدت أن المسألة تعود في الأساس لطبيعته وتركيبته الإنسانية الفريدة.. اكتشفت أنه يفعل ما يفعله إرضاءً لذاته وحفاظا على توازن داخلي وراحة نفسية.
كان الشيء الوحيد الذي لا يخجل عم عبده من الاعتزاز الشديد به هو قدرته على حل أعقد المسائل الحسابية لدرجة أنه في أيام استخراج الميزانيات الحسابية للبنك كان يتطوع بنفس شغف صبي يسافر إلى دار سينما أو لمباراة كرة قدم، ويبادر بالعمل في ضبط الميزانية رغم أن هذا لم يكن عمله ولم يطلب منه أحد ذلك على الإطلاق، ولكن رئيس وموظفي الحسابات كانوا يحتفون بقدومه لمساعدتهم لثقتهم أنه يستطيع حل أعقد المسائل شأنه شأن موظفي البنك الذين يحملون مؤهلات محاسبية عليا وخبرة في الحسابات.
ساعتها لم تكن هناك أجهزة رقمية أو الات حاسبة، وكانت كل العمليات الحسابية تتم يدويا.
ولا أكذب لو قلت أنني كنت أندهش من قدرته على استخراج ناتج جمع عمود من الأرقام بطول صفحة مستطيلة في أقل من دقيقة، كنت أراه وهو يشمر كم جلبابه ويزر على عينه ويدني وجهه من الأرقام؛ فيمرر طرف إبهام يده التي تحمل القلم الرصاص، وما إن ينتهي مرور إبهامه على عمود الأرقام حتي يضع ناتجها، وقليلا ما كان المراجع يصحح ورائه خطأً ما.
ربما كان لدى عم عبده زغلولة نزوعا داخليا يحاول التأكيد عليه دائما دونما أن يصرح به، وهو أنه الفلاح ذو الطاقية والجلباب الواسع الأكمام التي يسخر منها أبناء البندر، ويستهين كبار أفندية المدينة بمن يرتديهما؛ يستطيع أن يقتحم عالم هؤلاء الأفندية وأن يتفوق عليهم، فيما هم يعتقدون أنهم فقط الأهل للمقدرة والذكاء والألمعية العقلية، طالما كانوا يرتدون قمصاناً وبناطيل وجواكت وكرافتات ويشخطون في الفلاحين ويتعاملون معهم باستعلاء أجوف وباطل.
أما أنا .. فقد قررت أن اتعلم منه كل ما يمكن أن اتعلمه، وهذا ما نفعني كثيراً فيما بعد.
لم تدم مدة خدمتي مع عم عبده كثيرا فقد حدث في شتاء 1978، أن أعلنت اتفاقيات كامب ديفيد وكنت وقتها عضوا في حزب التجمع، فكلفت بتوزيع بيان الحزب المعارض لكامب ديفيد في مدينة المحمودية، وكان أن قبض علي متلبسا بتوزيع منشورات تحض على قلب نظام الحكم، وهدم الدولة وترويج إشاعات وبيانات كاذبة؛ طبقا لما قاله لي وكيل النيابة الذي حقق معي وأمر بحبسي على ذمة قضية أمن دولة، وبعدما خرجت من السجن قرر البنك نقلي إلى قرية بعيدة على أطراف المحمودية، وبحيث أشغل وظيفة كاتب شئون إدارية ومطبوعات وأرشيف، وهي وظيفة هامشية كان الغرض منها إبعادي عن أي تعامل مع الجمهور بناء على طلب الجهات الأمنية.. ولكن هل توقفت حكايات عم عبده ومآثره المدهشة عند هذا الحد؟
سأحكي لكم…
عند الإفراج عني وعودتي إلى المنزل، أحضرت أمي مظروفا احتفظت به في عناية في الفاترينة الزجاجية للنملية التي كانت تتصدر صالة البيت، وتستند على جدارها المواجه لباب الشقة. لم يكن المظروف مدونا عليه كحال ما يستخدم عادةً من المظروفات، لكنه كان يشي بوضوح أن داخله أوراقا نقدية، وقبل أن أسألها عمن أتي به أبلغتني بأن أحدهم كان يرتدي جلبابا وبالطو ناولها الظرف بعد دخولي السجن بأيام، وأبلغها أنه زميلي في العمل وأنه يدعى عم عبده وأنه أبلغها بأن هذا المظروف يحمل أمانة كانت لدي عنده، وأنه قال ذلك وهو يقف على باسطة السلم رافضا الدخول، وأنه انصرف مسرعا معتذرا لها عن عدم تلبية دعوتها له بالتفضل لتناول واجب الضيافة.
قمت بفتح المظروف وأنا على يقين أنني لم أعط عم عبده شيئا وما تركت له أية أمانات ليردها، إلي وكانت المفاجأة أن وجدت داخل المظروف مبلغ مئتي جنيه، وهو مبلغ كبير جدا في هذا الوقت، ويساوى مبلغ راتبي مضروبا في أربعة أو خمسة أشهر في وقتها.
في عصرية اليوم التالي دسست المظروف في جيبي وسارعت إلى بيت عم عبده الذى سلم علي واحتضنني وقال ممازحا: “إيه اللي جابك عندي أنت عاوز تشبهني ولا إيه.. الله يخرب عقلك.. دا أنت يا بني طلعت خطر وأنا ما أعرفش.. أنت عرفت إنهم نقلوك؟
مددت يدي إلى جيبي وأخرجت المظروف واضعاً إياه على “الترابيزة” التي أمامنا بعد أن ارتشفت كوب الشاي الذى طلبه لي من الحاجة أم صبحي زوجته التي انصرفت بعد أن سلمت علي واطمأنت على أحوالي.
وكان أن التفت إلي عم عبده وكأن شئيا قد أفزعه ثم بعد أن ألقي نظرة باردة غير مكترثة علي المظروف نظر ثانية إلي قائلاً: “بتاع إيه ده؟”.
فقلت له أن هذا هو المظروف الذى تركه لأمي في المنزل وشكرته وأبديت له مدي امتناني لهذا الجميل الكبير.. فقاطعني بعد أن ربع يديه قائلاً: “وإيه لزوم الكلام ده؟ بقي جاي مخصوص عشان كده؟ ما كانش العشم يا أستاذ حمدي”.
قاطعته قائلا: “أنت أول مرة تقولي بيني وبينك يا أستاذ حمدي ودي حاجه تزعلني”.
فرد بدوره: “يا عم حمدي أنت اللي بتزعلني دلوقتي.. أولا أنا ليه ميت جنيه بس في الفلوس دي هخدها لما تقبض، وثانياً الميت جنيه الثانية دي من زمايلك لموها من بعض بس حلفوني ما أجيب سيرة لحد وأنت كمان ما تجيبش سيرة لحد لحسن تودينا ف داهية”.
تنهدت ووقعت في حيرة من أمري.. ثم وجدتها، وقلت له: “خلاص تاهت ولقيناها.. المئة جنيه اللي اتلمت دي ماينفعش ترجع إحنا متعودين كزملا نلم من بعض لأي حد بتحصله حاجه، بس المئة جنيه بتاعتك تاخدها، ورجوته وأقسمت بأغلظ القسم له أن يأخذها؛ فرد وهو يمد يده لتناول المظروف قائلا: “خلاص هآخد فلوسي يا سيدي، بس أوعي تحرجني مع زمايلك وترجع المبلغ اللي اتجمع.. وبعدين الأيام جايه وياما هتساهم معانا”.
بالطبع علمت بعدها أنه هو من بادر وطرح الفكرة على زملائي الموظفين بالبنك في سرية شديدة، وهو من اقترح أنصبة المساهمات وما إلى ذلك، وهذا ما جعلني فيما بعد وبعد أن ذهبت إلى مكان عملي الجديد أن اقترح على زملائي أن نؤسس صندوق زمالة نضع فيه مساهمة شهرية من كل زميل، خمسة جنيهات بحيث يكون هناك رصيد دائم عند حدوث أي مناسبة أو حدث عند أي زميل يستدعي أن نساهم فيه بمبلغ أو هدية أو ما إلى ذلك، وكانت هذه الفكرة مفتاحا لعمل وجهد تطور إلى أن دفع بي زملائي في إحدى انتخابات النقابات إلى عضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية للبنك، وهذا موضوع له تفاصيل أخرى ليست مهمة الآن، ولكن الأهم هو ما كان لعم عبده زغلولة من سيرة حافلة بالأفعال التي رسخت داخلي دروسا من أهم دروس العمر؛ بأبوية تنوعت ما بين الصرامة والحسم والشهامة والمودة، بمثابرة وإصرار فلاح مصري يراكم ما يفعله في جهد ومثابرة دون شكوي من ثقل الجهد وعناء الشقاء، ودونما إعلان أو ادعاء ودونما تطلع لبطولة أوجاه أو سلطان أو تسلط على البشر.. بالتأكيد كان يتبرم أحياناً من عدم استيعابي لبعض المسائل، وتضايق من عدم سماعي لبعض نصائحه الخاصة بالبعد عن السياسة ووجع القلب كما كان يقول.. لكنه حتي بعد أن توفي قبيل انقضاء النصف الأول من ثمانينيات القرن الماضي، ظل حيا داخلي يلقي علي بدروسه الناصحة، ويدوس بقدمه على قدمي ويضغطها بقوة كلما أخطأت في مسار ما من مسارات الحياة.