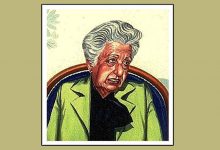اللغة وعاء الفكر والوسيط والمعبِّر عن رؤى العقل، وهي سبيل الإفصاح عن تفاصيل المدركات وما يعتمل فيها من تفاعلات تؤسس للوعي وللثقافة الإنسانية.. ولكنَّها لا يمكن أن تكون بمعزل عن المجتمع الذي يمنحها خصوصيتها ويهبها القدرة على التطور من أجل أن تبقى حيةً تجري على الألسنة، لكن الجمود يطالها بدعوى الحفاظ عليها بمنأى عن الهدم ومن ثَمَّ البدد؛ فتعجز عن مجاراة كثير من التغيرات المجتمعية فيكون مقتلها في ذلك البادي في هيئة الحامي لها
يرى ديكارت وبرجسون أنَّ كلا من اللغة والفكر مستقل عن الآخر، و ينطلق ديكارت في طرحه من اعتبار الفكر جوهرًا لا ماديًا هو مبدأ كل وجود، ولهذا فهو سابق على اللغة التي تعتبر من طبيعة مادية، ولهذا يعتبر ديكارت أنَّنا في حاجة إلى أداة لإخراج الفكر إلى حيز الوجود وجعله مدرَكًا من قبل الآخرين، وهـذه الأداة هي اللغة، أما بـرجسون فيعتبر أنَّ اللغة عاجزةٌ عن الإحاطة بكل موضوعات الفكر، ويرى أنَّ اللغة الإنسانية باعتبارها علامات و رموز ذات طبيعة مادية وأنَّها لا تغطي موضوعات العالم المادي إلا من خلال نقل الكلمة لتدل على أكثر من شيء.

وباعتبار أنَّ هناك تلازمًا بين اللغة والفكر، فإنَّ اللغة هي جسر التواصل بين الفكر والمجتمع، ومن ثَمًّ فإنَّها تحاكم إلى قدرتها على الإبانة عن الأفكار بشكل شفاف لا يكتنفه غموض أو كتمان، إذ أنَّ كل تواصل قابل لأن يتخذ دلالات متنوعة خصوصًا وأنَّه يتم داخـل مجتمع معين وبما أنَّ العلاقات الاجتماعية علاقات متعددة ومتنوعة فإنَّ عملية التواصل تتخذ أيضًا نفس الدلالة، ولهذا فإنَّ اللغة لا تتخذ فقط وسيلةً للتواصل، بل إنَّها تحدد الإطار المرجعي لهذا التواصل؛ ذلك لأنَّه داخل كل مجتمع توجد مجموعة من المحرمات، ما يجعل عملية التواصل بمثابة قواعد لعب يومية تحدد ما هو مباح وما هو ممنوع هذا بالإضافة إلى المحظورات التي يتضمنها كل نظام لغوي، ما يفرض على الأفراد اللجوء إلى التعبير الضمني الذي يعفي من المسئولية، هذا بالإضافة إلى ضرورة تفادي كل نقد أو اعتراض يمكن أن يعرِّض الفرد للسخرية أو المحاسبة من قبل الآخرين، و هذا ما عرَّفه دوكرو بآليتي الإخفاء والإضمار.
ويرى الدكتور جيرار جهامي أنَّ “هناك علاقة ثنائية قائمة أصلا بين الفكر واللغة التي تعبر عن رؤى هذا الفكر وتطلعاته بدقائقه وخصوصياته. لذا تبقى التأثيرات والتفاعلات متبادلة بين اللغة والثقافة الإنسانية، وعلى الصُعُد النظرية والعملية معًا. فلكل مجتمع نمط تفكير وبالتالي طريقة تعبير، ترفق بمنطق خاص في فقه الأمور وترجمتها استدلالات يوجبها تركيب هذه اللغة. فالمقولات الفكرية التي بنى اليونانيون عالمهم بواسطتها، وحددوا آفاق تصوراتهم بتفرعاتها، غيرها عند العرب؛ وتلك التي راجت في الفكر الألماني مثلا مختلفة عن مثيلاتها في النظرة الأنجلوسكسونية إلى الكون ومدى علاقة الفكر به”.
لذلك فإنَّ الإشكالية الأولى التي تواجه اللغة هي إشكالية داخلية تكمن في ثنائية التنازع بين المواكبة والجمود، وهي ثنائية تفرض قدرا من الحذر في التعامل مع دعاوى التجديد كونها تستلزم مبارحةً واضحة للقواعد والأصول التي شكلت البناء اللغوي الذي أعطى للغة شخصيتها وملامحها المستقلة.

إذ أنَّ للغة قيودا شديدة الصرامة، وقدرة هائلة على المراوغة وصنع الالتباس، وهي ما تفتأ تنصب شَراكها للسامع والقارئ، وأحيانـا تكون مقصلةً للمتكلم والكاتب، وهي الكاشفة والمجردة من الخوف، والمغرضة والمضللة حد الزيف؛ وهي -رغم ذلك- الحكم على المعرفة، والمعيار للفهم.
وهي المغرية بثرائها بالانضباط المتكلف، والاهتمام بالتفاصيل، حتى إنَّها تجعل من إسقاط الفكرة -أحيانًا- فعلا عمديـا لحساب جمالها ورونقها، والاستمتاع بها كسطوةٍ هائلة مخاتلة تتأبى على نكران الذات.
واللغة العربية على ما لها من حضور، هي في القلب من إشكالية ثنائية اللغة والفكر، وتكمن معضلتها الكبرى في ذلك التحول الرهيب الذي طرأ عليها بظهور الإسلام وانتشاره في ربوع الأرض، ومن ثم انتقالها من البداوة كحالة وكبيئة حاضنة إلى الحضر وما له من واقع مغاير تماما من حيث الألفاظ والتراكيب والتعبيرات التي هي وليدة حياة تختلف شكلا ومضمونا عن حياة البادية، ناهيك عن اختلاط العرب بغيرهم من أجناس الأرض، والذي أحدث لديهم ما يشبه الصدمة الحضارية، ما أوقف اللغة العربية -في أحيان كثيرة- في موقف العاجز عن الاحتواء والمواكبة.

لكن إسهاما كبيرا قد تحقق في قرون الإسلام الأولى رغم المناوءات الشديدة والحرب التي شُنت على متفلسفة تلك الفترة.. ما يمكننا معه القول بأن اللغة العربية قد أنضجت فلسفيا على نحو ما في هذا العصر؛ وليس أدل على ذلك من إيثارها من جانب كثير من الفلاسفة على لغاتهم الأم لتكون حاضنة لأفكارهم ورؤاهم.. فلم تتوقَّف المسألة “عند الفارابي أو الشيخ الرئيس، أو شهاب الدين السهروردي، وإنما تجاوزتهم إلى أكبر موسوعة فلسفية عربية كتبها آخر فلاسفة فارس الكبار ”صدر الدين الشيرازي الذي أَنْتَج “الحكمة المتعالية” وبها استكملت “الحكمة المشرقية” وأعمال “شهاب الدين” الإشراقية، وبنحوٍ لا ينقصُه مَنْطِق هذه المرة”.