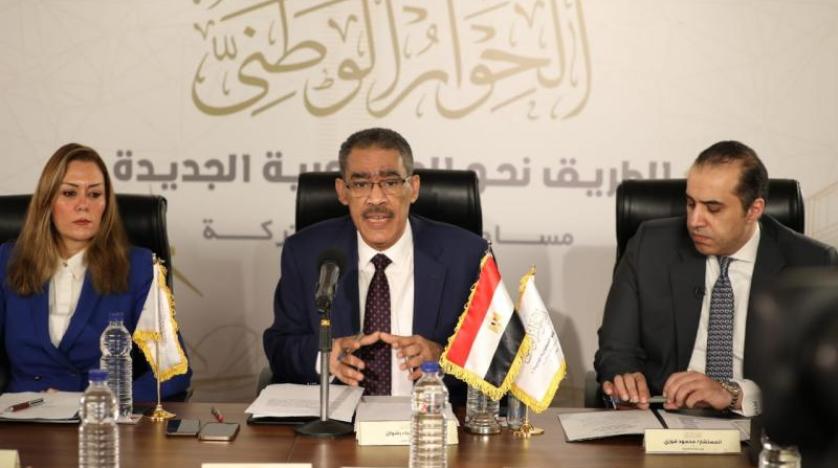بقلم: حسين عبد الغني، إعلامي وصحفي مصري
نقلًا عن صحيفة مصر 360

لم يكن شهر مارس الحالي كباقي شهور السنة الأخيرة، منذ أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي دعوته لإجراء حوار وطني. فإذا كانت الشهور الـ١١ الأخيرة مرت بطيئة دخل فيها الحوار الوطني نفسه في سبات عميق، فإن شهر مارس شهد أخطر تطور سياسي منذ عام كامل.
إذ يبدو الأمر من وجهة نظر التحليل السياسي، وكأن المعارضة المصرية قد قبلت ضمنيا، وعمليا، بأن تجعل سقفها السياسي أقل من السقف الشعبي، المتجه نحو ضرورة إحداث تغيير كامل في بنية النظام السياسي الحالي الفردي، وإنضاج الظرف الوطني لمرحلة تحول انتقالية، تقود مصر نحو نظام ديمقراطي، وتعددي يسمح بتداول سلمي للسلطة، وينهي الخلل الفادح في التوازن بين السلطات، وينقل الوضع الحالي لرئيس الجمهورية من الوضع شبه المقدس الحالي إلى وضع بشري يكون فيه الرئيس مسئولا، ومحاسبا محاسبة تامة من الشعب المصري.
*****
خفض مطالب الحركة الشعبية المصرية بتوجيهها إلى الحديث عن الانتخابات الرئاسية، يغير ببساطة دفة الحديث الأصلي عن الحاجة إلى تغيير شامل في بنية النظام الفردي، والتحول إلى نظام ديمقراطي، يتم فيه استثمار هذا العام في ممارسة ضغط سلمي مشروع على إدارة مأزومة لم تعد مطلقة اليد كما كانت سابقا في إسكات المعارضين، ولم تعد كذلك قادرة على إخفاء مظاهر السخط الشعبي على إخفاقها الاقتصادي، وانحيازها الطبقي، وما يعنيه ذلك من تآكل مخيف في شرعيتها السياسية .
****
كيف حدث هذا التطور الخطير؟
في خلال شهر تقريبا – بقدرة قادر -تحول أو على الأصح تدحرج جدول الأعمال الوطني كله؛ ليتركز في قضية واحدة هي انتخابات الرئاسة المقبلة التي يفترض إجراؤها بعد عام من الآن، أي في مارس ٢٠٢٤. فبعد مطالبة مبكرة من رئيس حزب الإصلاح وعضو الحركة المدنية السيد محمد أنور عصمت السادات، دعا فيها الحركة إلى الاتفاق على مرشح رئاسي للمعارضة أمام مرشح النظام السياسي القائم، وبعد إعلان النائب السابق أحمد الطنطاوي عزمه على العودة في شهر مايو، والترشح لانتخابات الرئاسة القادمة، فوجئ المصريون أن الحوار الوطني دبت فيه الحياة مرة واحدة، وخرج مجلس أمنائه بتوصية يطلب فيها من رئيس الجمهورية مد العمل بالإشراف القضائي من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات -قاض لكل صندوق- وهو إشراف كان تشريعا سابقا يجعله للهيئة المذكورة من العام المقبل اختياريا، وليس وجوبيا فلها بعدها أن تبقي على وجود القضاة على رأس اللجنة الإنتخابية، أو تضع موظفين إداريين يعملون لدى الحكومة مكانهم .
وفي استجابة سريعة في خلال أقل من ٤٨ ساعة رحب رئيس الجمهورية بالمقترح، ووعد بإحالته للحكومة لدراسته، وعقدت جلسة لمجلس الشيوخ، تبارى فيها الأعضاء في الإشادة بتوصية مجلس الأمناء، وتفاعل الرئيس الإيجابي معها. لكن المفاجأة الكاملة كانت في صدور بيان من قيادة الحركة المدنية ممثلة المعارضة يرحب بهذه الخطوة .
اللافت للنظر أن هذه الهيئة الموقرة وبإشراف قاض على كل صندوق، هي التي أشرفت على انتخابات الرئاسة ٢٠١٨، وهي التي أشرفت على انتخابات البرلمان ٢٠٢٠، ولكن هذه الهيئة تعمل وفق مناخ، اتفقت كل المنظمات الحقوقية الدولية على أنه مناخ غير موات بعد التعديلات التي أدخلت على قانون السلطة القضائية ٢٠١٩.
فإذا تركنا الانتخابات الرئاسية التي كانت بين الرئيس، ومنافس أعلن بنفسه تأييده للرئيس الذي ينافسه، وبالتالي كان فوز الرئيس فيها محسوما. وراجعنا الانتخابات البرلمانية لوجدنا أن الاختلال في التوازن بين السلطات الثلاث، وتعديلات قانون السلطة القضائية، جعل الممارسة الفعلية محل عشرات الملاحظات الدولية والمحلية، وشكاوى مرشحين تعرضوا إلي مخالفات انتخابية تؤثر على جدية ونزاهة الانتخابات، وفاز فيها -باستثناء خمسة أو ستة نواب معارضين- كل من أرادت الحكومة له أن يفوز.
أي أن الإشراف القضائي -الذي بات فيما يبدو وكأنه أغلى أماني المعارضة بموافقتها على نداء مجلس أمناء الحوار الوطني- يكون فعلا ضمانة كافية لانتخابات متكافئة ونزيهة، في حالة ما إذا كان التوازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية، واستقلال كل منها عن الأخرى، ومراقبتها لها قائم، وليس كما هو الحال في بلادنا الذي تجور فيه السلطة التنفيذية على باقي السلطات، وفي حالة أيضا ما إذا كان القانون الذي تعمل فيه السلطة القضائية متفقا مع مواد الدستور، وليس مجافيا لها كما علقت أندية القضاة عليه عام2019.
****
استدراج علي طريق طويل
لا يمكن فهم كيف استُدرِجت المعارضة إلى هذا الوضع؟ دون فهم عاملين: الأول: هو لماذا تحملت الإدارة المصرية كل الاتهامات والانتقادات اللاذعة التي طالتها بسبب إبطاء وتيرة الحوار الوطني؟ من أنها ليست لديها إرادة سياسية أو أن الحوار مات و«شبع موتا» وحتى أنها لم تكن جادة أصلا من البداية. تحملته لأن المكاسب من الإبطاء كانت أكبر من خسائر النقد، الذي وجه لها من النخب السياسية. أهم هذه المكاسب أن الدولة كانت تحتاج هذا الوقت الطويل؛ لكي تستطيع ترجيح كفتها على كفة المعارضة في التفاوض. وقت تختمر فيه وتتسرب إليه تدريجيا الخلافات، بين ممثلي الحركة المدنية في الحوار الوطني في مجلس أمناء الحوار وزعماء الحركة السياسيين، وجلسات الحوار السياسي الموازي الذي يتم بين الدولة، وزعماء المعارضة، وكانت النتيجة هي :
– لم يعد تقريبا هناك معارضة، وموالاة داخل مجلس الأمناء بل هناك مجلس «إلا قليلا» متناغم مع بعضه لا فرق بين ممثلي الحكومة، ومهمتهم الحفاظ على الوضع القائم، وممثلي المعارضة المفترض أنهم دخلوا الحوار لتغيير هذا الوضع. إذ يميل معظم ممثلي المعارضة في مجلس الأمناء للتعامل مع وجودهم في المجلس، بوصفهم شخصيات عامة مستقلة لها تاريخ سياسي، وليس مجرد ممثلين تابعين للحركة المدنية، التي تدير الحوار السياسي الموازي مع قيادات في الدولة، وهم يرون أنفسهم شخصيات عامة اعتبارية موجودين بصفتهم الشخصية رغم أن الحركة هي التي رشحتهم. ويري هؤلاء الأعضاء أن من حقهم المبادرة أو الموافقة على توصية مثل: توصية مجلس الأمناء المشار إليها دون الرجوع إلى قيادة الحركة.
وعلى الرغم من أن قيادات في الحركة المدنية تنبهت بذكاء لخطر الانشقاق، الذي قد تحمله الدعوة المبكرة للحديث عن الانتخابات الرئاسية، واستطاعت إقناع الأغلبية بتأجيل النقاش بشأنها إلى وقت متأخر من شهور العام الحالي، إلا أن أعضاء مجلس أمناء الحوار من فريقهم شاركوا فريق الحكومة في إصدار التوصية.
وربما لم يجد المستوى السياسي للحركة مفرا من إعلان تأييده للتوصية، بعدها بيوم أو يومين حتى لا يبدو وكأن الحركة مختلفة علنا مع ممثليها في مجلس الأمناء.
– إغراق الحركة المدنية في التفاصيل الصغيرة، بدلا من التفاوض المنهجي في القضايا الكبرى، مثل: التوصل لبرنامج لإنهاء مرحلة الحكم الفردي، وتركز السلطة في يد رئيس الدولة في السنوات العشر الأخيرة، والذي ربما لم تعرف مصر له مثيلا منذ صدور دستور ١٩٢٣، إذ جرى حصر معظم الحوار تقريبا في موضوع السجناء، وداخل هذا الموضوع أيضا، تم استدراج المعارضة تقريبا إلي مناقشة اسم كل سجين على حدة، كأن كل اسم منهم هو خطوة جبارة وكأنها هدم سجن الباستيل مع إعطاء الانطباع وكأن الإفراج عن هذا السجين، أو ذاك هو خطر يهدد أمن الدولة، لا بد من دراسة عواقبه شهورا وشهورا.
أما العامل الثاني: فهو الفائدة المذهلة، التي جنتها الدولة من عملية القبض على المعارضين المدنيين بأعداد هائلة، وارتهانهم في سجونها أو التي جنتها من تشريعها قوانين غير مسبوقة، مثل: قانون الحبس الاحتياطي، وغيرها والتي تتعارض بشكل تام مع الدستور و المواثيق الدولية التي صدقت عليها الدولة المصرية.
وتحملت الإدارة المصرية في سبيل ذلك كل الإدانات الدولية والحقوقية، وتبعات تدهور صورة مصر ونظامها السياسي في العالم و الإعلام الدولي في السنوات الأخيرة، لأن ما حدث هو أن الدولة أوجدت لنفسها بهذه الإجراءات الاستثنائية، مكاسب أهم بكثير مما لاقته من انتقادات دولية في ملف الديمقراطية وحقوق الإنسان.
أوجدت باختصار أوراق تفاوض رابحة، جعلت المعارضة تشعر أنها عندما تقنع الدولة بالتخلي عن ورقة من هذه الأوراق، أو جزء من هذه الورقة وكأنها حققت مكسبا كبيرا وانتزعت صيدا ثمينا من فم الأسد، بحيث أصبح الأمر يبدو وكأن كل آمال هذه المعارضة بات منحصرا في العودة إلي مرحلة الرئيس المخلوع حسني مبارك، الذي قامت عليه أصلا ثورة شعبية .
أي أن ترسانة القوانين وتعديلات الدستور المقيدة للحريات، والمرسخة للحكم الفردي المطلق في السنوات العشر الأخيرة، التي حار البعض لماذا تقوم بها الإدارة الحاكمة رغم أنها تهز صورتها الدولية؟ إنما جعلت سقف المعارضة ينزل لمستوى تمنى بلوغ الحالة البائسة قبل ٢٥ يناير ٢٠١١، التي ثار عليها الشعب، ودفع في ذلك أرواح ودماء آلاف الشهداء والمصابين .
لقد جعل ذلك الوضع مناضلين حقيقيين ذاقوا مرارة السجن في مرحلة ما بعد ٢٠١٤، ولم تعد لديهم أي أولوية سوى أن يتمخض الحوار الوطني عن الإفراج عن زملائهم سجناء الرأي الذين تركوهم خلفهم وراء القضبان، وأن يفوا بعهدهم لزملائهم أن لا يكلوا ولا يملوا يوما حتى يخرجوا مثلهم إلى الحرية، كما خرجوا هم في الـ ١١ شهرا الأخيرة، وهي مهمة مقدسة، ونبيلة لكنها أساسا حق من حقوق الإنسان، لم يكن يفترض أن تخضع لكل هذه المفاوضات المنهكة، وحتى في هذا السياق المنهك، مازال خروج سجين رأي مثل أحمد دومة وعلاء عبد الفتاح غير محسوم حتى الآن .
خطورة الحديث عن الانتخابات الرئاسية تكمن في أنها تحصر- النقاش الوطني العام في السباق الرئاسي، والحصول على بعض الضمانات عند إجرائه، وتتجاهل المزاج العام والحالة الشعبية، التي جعلتها آلام المعاناة المعيشية غير المسبوقة تدرك أن نظام الحكم المطلق في السياسة، والذي يعمل لصالح مجتمع العشرة في المائة من الأغنياء في الاقتصاد، هو الذي أوصل البلاد لهذا الوضع وأن الخروج من هذه الكارثة الاقتصادية ومن إغلاق المناخ العام، يستدعي تغييرا شاملا في بنية النظام السياسي وأن مصر تستحق التحول الجاد- خلال هذا العام الذي يسبق الانتخابات الرئاسية- نحو نظام ديمقراطي حقيقي، فيه انتخابات حرة على جميع المستويات وتوازن بين السلطات، لا تتغول فيه السلطة التنفيذية على سلطتي التشريع والقضاء، ولا يستحوذ الرئيس فيه على كل هذا الفائض الرهيب من السلطة بين يديه .
ويحول أيضا، تدحرج سقف النضال الديمقراطي المصري إلي سؤال الانتخابات الرئاسية كمرشحين، و قواعد وضمانات إجرائية، يحول الصراع من صراع سلمي بين الديمقراطية والاستبداد، إلي صراع داخل معسكر المعارضة، أي بين فصائل الحركة المدنية ويلقي الكرة في ملعبهم، وليس في ملعب السلطة، التي تستطيع من الآن أن تقف، وتتفرج، وهي مرتاحة على الخلافات بين المعارضين الطامحين للترشح في انتخابات الرئاسة .
و سواء كان الطامحون منهم أو من خارجهم،فإن معسكر المعارضة سيتفرق شيعا و أشلاء حول مرشحيه المتنافسين، بينما مرشح السلطة السياسية واحد ومتفق عليه.