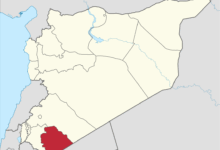في مقالنا السابق، حول اصطلاح “الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ”، تناولنا مفهوم ودلالة هذا الاصطلاح، القرآني، الذي ورد مرتين في آيات التنزيل الحكيم؛ وعبر هذين الموضعين، وصلنا إلى أنه كما كانت الآية السابعة الواردة في سورة آل عمران، محل اختلاف بين المفسرين حول “أين يكون الوقف”، عند لفظ الجلالة “اللَّهُ”، أم عند اصطلاح “الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ”؛ فإنها هي الآية التي يتمحور حولها الأصل في معنى التأويلية في الثقافة الإسلامية بصفة عامة، وفي “ثقافة تأويل الكتاب” على وجه الخصوص.
وهنا لابد من التأكيد على أن الموقف من التأويل، كان قد خضع في الكتابات الإسلامية غالبا، إلى “الاختلاف المذهبي” القائم على اختلاف المنطلق الفكري، العائد بدوره إلى الاختلاف في مناهج الاجتهاد، أو إلى الاختلاف في الفهم اللغوي لبعض الآيات الكريمات الواردة في كتاب الله العزيز.
مصطلح التأويل
وهنا لابد من التأكيد أيضًا على أن معالجة النص القرآني، لابد أن تتم عبر ضوابط الاستخدام الإلهي للمفردة، وهو استخدام مميز يرقى بالمفردة إلى مستوى المصطلح. لذا فمن حيث إن القرآن مُركب على اللغة العربية كأداة تعبيرية، فإن التعامل مع هذه الأداة يجب أن يكون بمستوى الانضباط المنهجي نفسه. وعليه فإن التعامل مع المصطلحات القرآنية، لا يمكن أن ينبني إلا على “البنائية القرآنية” نفسها. إذ، ليس الأمر قضية ظاهر وباطن، أو مُطلق ومُقيد، وغيرها مما اتفق على تسميته بـ”علوم القرآن” بل مصطلح محدد في دلالته ومفهومه.
ومن ثم، فإن مقاربة “التأويل”، من حيث المصطلح والمفهوم، في اتجاه محاولة اكتشاف معناه ودلالته.. لابد من أن تعتمد على دائرة المعنى الذي تتخذه اللفظة في اللسان العربي، وعلى دائرة الدلالة التي تؤكدها مواضع ورودها في كتاب الله الكريم.
يقول الله سبحانه وتعالى: “هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُوْلُوا الْأَلْبَابِ” [آل عمران: 7].
وإذا كانت لفظة “تأويل”، في هذه الآية، وردت مضافة إلى “الهاء” الدالة على “المتشابه”.. فلعل هذه الإضافة، هي التي جعلت المفسرين يقصرون معنى التأويل على “التفسير”، ويفهم كثيرٌ منهم أن تأويل المتشابه لا يعلمه إلا الله، وأن “التأويل” منهي عنه بفحوى الخطاب، أي: بدلالة الوصف “فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ”.
فهل هذا صحيح.. وهل التأويل منهي عنه، حقيقة، في آيات الله البينات؟
سوف نحاول هنا الاقتراب من المعنى بالنسبة إلى مصطلح التأويل في اللسان العربي، على أن نحاول في مقال قادم تناول دلالات هذا المصطلح في القرآن الكريم.
جانبي التأويل
جاءت لفظة تأويل اشتقاقا من مادة “أول”؛ وهي تشير في اللسان العربي إلى فعل من أفعال الأضداد، وهي أفعال كل منها يحمل معنيين: المعنى والمعنى المضاد تمامًا. وهي أيضًا أفعال.. أحيانًا ما يأتي الفعل منها متضمنا المعنى الأول، وأحيانا ما يأتي محملًا بالمعنى المضاد، ثم أحيانا ما يأتي محملا بالمعنيين معا. ومنها كمثال “ظن” ولها معنيان متضادان (الشك واليقين) ومنها كمثال آخر “قسط”: البر والإحسان، والجور والطغيان.
وبملاحظة الاشتقاق اللغوي للفظة تأويل، من “أول”، يبدو أحد المعنيين لهذا الفعل، وللفظة المشتقة عنه: الرجوع، “آل الشيء يؤول أولًا ومآلًا: رجع. وأول إليه الشيء: رجعه. وألت عن الشيء: ارتددت”.
ومن ثم، فـ”التأويل”، على هذا الجانب، هو: تفعيل من أول يأول تأويلًا، أي رجع وعاد؛ ولأنهما لا يكونان سوى إلى الأصل، الذي يمكن العود والإحالة إليه، لذلك يبدو أن المعنى الأول للفظة تأويل يتمحور حول “العودة إلى أصل الشيء”، وذلك لاكتشاف دلالته ومغزاه. وفي هذا المعنى، جاء قوله سبحانه: “هُوَ الْأَوَّلُ”، في الآية: “هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ” [الحديد: 2].. ولنا أن نلاحظ، هنا، أن هذا هو الموضع الوحيد الذي وردت فيه أسماء الله الحُسنى، يفصل بينها حرف “الواو”.
لكن لفظة تأويل، كما تعني الرجوع والعودة إلى أصل الشيء، فإنها تعني – في الوقت نفسه- الوصول إلى غاية وهدف. وهذا هو المعنى الثاني للفظة، وللفعل المشتقة عنه. إذ، كما جاء في لسان العرب: “أول الكلام وتأوله: دبَّره وقدره، والتأويل: المرجع والمصير، مأخوذ من آل يؤول إلى كذا، أي صار إليه. وأولته: صيرته إليه”.
ومن ثم، فـ”التأويل”، على هذا الجانب، هو: تفعيل من آل يؤول تأويلًا، أي صار؛ ولأن هذه الصيرورة تستهدف الوصول إلى غاية، وأن هذه الأخيرة هي ما يمكن أن ينتهي إليه الشيء؛ لذلك يبدو أن المعنى الثاني للفظة تأويل ينبني على “ما ينتهي إليه الشيء”. وفي هذا المعنى، جاء قوله تعالى: “وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ”، في الآية: “بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ” [يونس: 39]؛ أي أنهم تعجلوا بتكذيب القرآن، ولم يُؤول بعد.
حركية التأويل
وهكذا، فإذا كانت لفظة تأويل تعني “العودة إلى أصل الشيء”، وتعني “ما ينتهي إليه الشيء”، فإن الذي يجمع بين المعنيين هو دلالة الصيغة الصرفية “تفعيل” على الحركة؛ وهي دلالة لم يلتفت إليها كثير من اللغويين في تحليلهم المعجمي. لذلك، فإن الدلالة التي يتضمنها ويشير إليها “مصطلح التأويل” تنبني – بالأساس – على الحركة؛ حركة بالشيء أو بالظاهرة، إما في اتجاه “الأصل” لاكتشاف دلالته ومغزاه، وإما في اتجاه “الغاية” لمعرفة التوجه والمصير. وإذا كان الرجوع إلى الأصل هو حركة عكسية، فإن الوصول إلى الغاية هو حركة مستقبلية تطورية نامية.
وبالتالي، ومن حيث إن هذه الحركة ليست حركة مادية، بقدر ما هي “حركة ذهنية”؛ فإن دلالة مصطلح التأويل تتمحور حول: “حركة ذهنية في إدراك الأشياء والظواهر والوعي بها”؛ والإدراك هو “إعطاء الأشياء والظواهر معان محددة”، أما الوعي فهو “كيفية التعامل مع معاني الأشياء والظواهر”.
هذا عن ملامح المعنى الذي تتخذه لفظة “تأويل” في اللسان العربي.
فماذا عن دلالة التأويل، في كتاب الله العزيز(؟!).
وللحديث بقية.