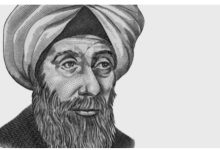وصلنا في حديثنا السابق إلى أن الفِطْرة من الفَطْر، وهو في اللسان العربي له وجهان: الأول الشق والآخر البدء والإنشاء. فإذا دققنا النظر في كل من الوجهين، يمكن أن نلاحظ تكاملهما، في حال الإشارة إلى عمليتين متتاليتين تتمان في حيز واحد، أي إذا تم “بدء الشيء وإنشاؤه من خلال الشق”. ولعل هذه تكون أهم الدلالات التي تشير إليهما لفظة الفَطْر.. يُقال فطر ناب البعير، شق اللحم فطلع.
ولعل هذه الدلالة هي ما يتبدّى بوضوح في قوله سبحانه وتعالى “فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ” وهو القول الذي ورد في ستة مواضع من كتاب الله الحكيم [الأنعام: 14، يوسف: 101، إبراهيم: 10، فاطر: 1، الزمر: 46، الشورى: 11].
الخَلقْ والفَطْر
بل لعل هذه الدلالة تتأكد إذا لاحظنا أن ثمة فروقات أساسية بين اثنين من الأفعال في خلق الوجود، والفعل هو عمل محدد معرّف كأن يقال أكل: فعل ماض أي عمل معّرف بالأكل الأول هو فعل خَلًق كما في قوله سبحانه “الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ” [الأنعام: 1] والثاني هو فعل فَطَر كما في قوله تعالى: “إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ” [الأنعام: 79].
فـ”خلق” فعل ماض أي عمل معّرف بالخَلْقُ وهو في اللسان العربي، على وجهين أحدهما التقدير أي التصميم.. تصميم الشيء وليس التصميم على شيء، والثاني إيجاد الشيء على شكل لم يُسبق إليه.. وقد وردت لفظة الخلق في كثير من المواضع، بوجهيها معا. منها قوله سبحانه وتعالى “إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ” [الأعراف: 54] فإذا لاحظنا أن الآية قد ورد فيها الفعل خَلَقَ والمصدر الْخَلْقُ –ما يُعرّف به الفعل– يمكن الاطمئنان إلى أن أهم دلالات الْخَلْقُ هي تقدير الشيء وإيجاده على شكل غير مسبوق.
أما فطر، فهو فعل ماض أي عمل معرّف بالفَطْر. والفطر كما سبقت الإشارة بدء الشيء وإنشاؤه من خلال الشق.
بناء على ذلك يمكن فهم الفروقات الأساسية بين قوله سبحانه “خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ” وقوله تعالى “فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ” بل إنه سبحانه تأكيدًا على أن كلا من خَلَق و فَطَر في هاتين الآيتين وفي غيرهما، هي أفعال ربانية غير مسبوقة، جاء بقوله “بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ” وذلك في آيتين.. الأولى “بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ” [البقرة: 117] والثانية في قوله تعالى “بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ” [الأنعام: 101].
دلالة “الفطرة”
وبناء على ذلك أيضًا، يمكن فهم الفطرة.. فإذا كانت الفطرة هي الحالة من الفَطْر وكان الفَطْر هو بدء الشيء وإنشاؤه، فإن البنية الدلالية للفطرة لابد وأن تتمحور حول الكيفية التي يكون عليها هذا الشيء أي حالته. ومن ثم تكون الفطرة ذات دلالة مؤداها “القوانين الضابطة لحركة الشيء”.
وبالعودة إلى قوله سبحانه “فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ” [الروم: 30].. لنا أن نلاحظ:
ـ أن فِطْرَةَ اللَّهِ اصطلاح يشير إلى القوانين (النواميس والسنن) الإلهية، التي أرادها سبحانه وتعالى لكي تكون بمثابة الضابط لحركة الأشياء.. ولكن لما لم يكن المقصود من الآية هو الأشياء على وجه العموم، بل الإنسان (الناس)؛ لذا جاء السياق ليؤكد أن الآية تشير إلى فطرة الله الخاصة بالناس –لاحظ أن هذا هو الموضع الوحيد الذي ورد فيه اصطلاح فِطْرَةَ اللَّهِ– لذا، جاء قوله سبحانه وتعالى “الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا” للتأكيد على ذلك.
ـ أن “فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا” هي جملة خبرية.. جاءت لتُعْلِمنا بذاتها، أن ثمة قوانين إلهية ضابطة (فِطْرَةَ اللَّهِ) لحركة الناس (الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا). ولأنها جملة خبرية؛ جاء ما قبلها لتوضيح محتوى هذه القوانين (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا) وجاء ما بعدها لتوضيح مضمونها (لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ).
ـ أن “لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ” هي الجملة التي تلي الجملة الخبرية لتوضيح مضمون القوانين أي فعالية تلك القوانين واستمراريتها.. ولأنها جملة منفية، إذ أنها تبدأ بحرف النفي لا؛ لذا فهي تشير إلى المضمون من خلال نفى إمكانية تغيير القوانين “لَا تَبْدِيلَ”.
وهنا نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى لم يقل لفطرة الله؛ بل قال “لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ” أي لا تغيير للقوانين التي قدرها وأوجدها (خلقها). ومن ثم يتبدّى بوضوح أن النفي هنا، لا يتوقف عند حدود إمكانية تغيير القوانين، في ذاتها ولكنه يمتد إلى ما هو أعمق، نفي إمكانية التغيير عن تقدير وإيجاد مثل هذه القوانين.
وهو ما يعني أن هذه القوانين قد تم تقديرها (تصميمها) وإيجادها من الله سبحانه وتعالى، لتكون غير قابلة للتغير، وتكون هي الضابطة لحركة الناس (فِطْرَةَ اللَّهِ)، ويكون الناس في حركتهم منضبطين عليها (الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا).
الدين القيم
ـ أن “فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا” هي الجملة التي تسبق الجملة الخبرية لتوضيح محتوى القوانين، أي ما يجمعها ويشملها. ولأن الفاء من حروف العطف، ويكون ما قبلها علة لما بعدها (لاحظ الآية السابقة على هذه الآية، حيث يقول سبحانه: “بَلْ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ” [الروم: 29])؛ ولأن الجملة جاءت في صيغة أمر؛ إذ إنها تبدأ بفعل الأمر “أَقِمْ” (أَقِمْ وَجْهَكَ) لذا فهي تشير إلى الدين كمحتوى لهذه القوانين.
وقد جاء حرف اللام في “لِلدِّينِ” للتأكيد على أن صيغة الأمر في “أَقِمْ وَجْهَكَ” هي توجيه خاص بالدين.. وهنا نلاحظ أن “الدِّينُ” اسم جنس يشير إلى ما دان به الإنسان لله ولزم به طاعته.. ونلاحظ أيضًا، أن “حَنِيفًا” لا تصف “الدِّينُ”. إذ إن “حَنِيفًا” حال والحال يصف الفاعل أو المفعول به، على اعتباره صاحب الحال. ومن ثم فالتقدير هو “فَأَقِمْ وَجْهَكَ حَنِيفًا لِلدِّينِ”. ولعل تأخير الحال (حَنِيفًا) يكون لتوضيح “الفصل” بين صيغة الأمر “فأقم وجهك للدين حنيفاً” وبين الجملة الخبرية “فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا” مثل ما جاء حرف النفي لا (غير معطوف) لتوضيح “الفصل” بين الجملة الخبرية، وبين صيغة النفي “لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ”.
ولعل ما يؤكد أن “حَنِيفًا” ليست حالاً من “الدين” هو لفظة “حنفاء” التي وردت في قوله سبحانه وتعالى: “وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ” [البينة: 5]. وعلى كلٍ فالحنيفية لها حديث خاص، حيث نلتقي هناك باصطلاح “دين الحنيفية” أي “الدين الحنيف” وما يشير إليه من دلالات.
أما هنا في هذا الحديث، فيمكن التأكيد على أن “دين الفطرة” هو اصطلاح يشير إلى “دين الوجود الإنساني” أي القوانين (النواميس أو السنن) التي أرادها الله سبحانه وتعالى ضابطة لحركة الناس (فِطْرَةَ اللَّهِ) وأنشأهم منضبطين عليها (الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا).
ولأنه لا يمكن تغيير هذه القوانين (الفطرة) أو تغير تقديرها (تصميمها) أو تغيير مضمونها (فعاليتها واستمراريتها) إذ “لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ”.. لذا جاء الأمر (التكليف) بـ “َأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا” أي إن من يعرف هذه القوانين من الناس ويتحرك وفقًا لإطارها، فإن حركته حينئذ سوف تكون منسجمة مع وجوده في الحياة وفي الكون. فالدين هنا، هو محتوى هذه القوانين.
ولعل ما يؤكد هذا ما يشير إليه اصطلاح “الدين القيم” من دلالات، وذلك في قوله تعالى في الآية نفسها: “ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ” [الروم: 30]… يتبع.