يروي الغزالي قصته عن عزمه الهرب من التعلق بالزوائل، واختيار الطريق إلى الله بالمعرفة القلبية التي لا تكون إلا بتخلية القلب من كل حب للشهوات؛ لتكون بعد ذلك التحلية بلذة القرب من الله تعالى – بأنَّه نظر في عمله بالتدريس وجمع العلوم، فوجد أنَّه عملٌ لا يبتغى به وجه الله، وأنَّ باعثه كان الرياء والسمعة وانتشار الصيت، ساعتها أيقن الغزالي أنَّه هالكٌ؛ إذا لم يعمل على تلافي تلك الأحوال، وكان مبدأ ذلك الإحساس وهو ببغداد، وله من المكانة عند عامة الناس وخاصتهم، ما يجل عن الوصف؛ لذلك رأى أنَّ بداية طريق التوبة أن يغادر بغداد إلى طوس فيلزم داره؛ حتى يقضي الله أمرًا كان مفعولا، لكنَّه لم يستطع الإقدام على هذه الخطوة؛ إذ كانت نفسه تنازعه في ذلك تنازعًا لا قِبل له بحسمه.
يقول الغزالي واصفًا حاله تلك: “وكنت لا تصفو لي رغبة في طلب الآخرة بُكرةً إلا ويحمل جند الشهوة حملةً فَيُفَتِرُهَا عشيةً، فصارت شهوات الدنيا تجاذبني بسلاسلها إلى المقام، ومنادي الإيمان ينادي: الرحيل! فلم يبق من العمر إلا القليل، وبين يديك السفر الطويل، وجميع ما أنت فيه من العلم والعمل رياء وتخييل، ثم يعود الشيطان فيقول: هذه حالةٌ عارضةٌ، وإياك أن تطاوعها فإنَّها سريعة الزوال”.
ولقد استمرت به هذه الحال على قسوتها قرابة الأشهر الستة، حتى “جاوز الأمر حد الاختيار إلى الاضطرار” فاحتبس صوته، ولم يعد له إلى النطق سبيلا، ثم ساءت حاله جملةً؛ فترك الطعام حتى هَزُلَ، ولم يفلح الأطباء في علاجه حتى قالوا: “هذا أمر نزل بالقلب ومنه سرى إلى المزاج، فلا سبيل إليه بالعلاج إلا بأن يتروَّح السر عن الهم المُلِمِّ”. ثم جاء الفرج من الله تعالى بعد كامل الإحساس بالعجز، وسقوط الاختيار بالكلية، والالتجاء إلى الله تعالى “التِجَأَةَ المضطر الذي لا حيلة له”.
لقد ظل الغزالي يبحث عن الحقيقة بعد أن عَمَرَ نور الإيمان قلبه، فنظر في مذاهب عصره، مستقلا بمنهجه في البحث عن غيره؛ إذ أراد أن يرتفع بالحقيقة من حضيض التقليد إلى يفاع الاستبصار -على حد تعبيره- إلى أن انتهى إلى أن الصوفية هم أرباب الحق، مبينًا أن حاصل علمهم قطع عقبات النفس، والتنزه عن أخلاقها المذمومة، وصفاتها الخبيثة؛ حتى يتوصل بها إلى تخلية القلب عن غير الله تعالى، وتحليته بذكر الله.
ولقد أقام الغزالي تصوفه على دعائم من الفقه وعلم الكلام معًا، واضعا نُصب عينيه موافقة عقيدة أهل السنة والجماعة، ومحاربة كل انحراف عنها، كالنزعات “الغنوصية” على اختلافها، والتي تأثر بها بعض فلاسفة الإسلام، والإسماعيلية من الشيعة، وإخوان الصفا وغيرهم؛ لذلك غلب الطابع النفسي والخلقي على تصوف الغزالي، وربما كان ذلك بسبب تأثره ببعض متصوفة القرنين الثالث والرابع، كأبي طالب المكي والحارث المحاسبي والجُنَّيد، وتبين له أن ما وصل إليه هؤلاء، أنه لا مطمع في سعادة الآخرة إلا بالتقوى وكف النفس عن الهوى، ورأس الأمر عندهم هو قطع علاقة القلب عن الدنيا، بالتجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والإقبال بِكُنه الهمة على الله.
ويرى الغزالي كذلك أن الصوفية هم السالكون لطريق الله تعالى خاصة، وأن سيرتهم أحسن السير، وطريقتهم أصوب الطرق، وأخلاقهم أزكى الأخلاق، وذلك لأنَّ حركاتهم وسكناتهم في ظاهرهم وباطنهم مقتبسةٌ من نور مشكاة النبوة، وليس وراء نور النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به.
كما حمل على أصحاب الشُّطَح كأبي يزيد البسطامي والحلاج حملة شديدة، وقال أن نطقهما بما تخيلوه من اتحاد أو حلول أو وصول، خطأ لا يليق بالعارفين الكُمَّل.
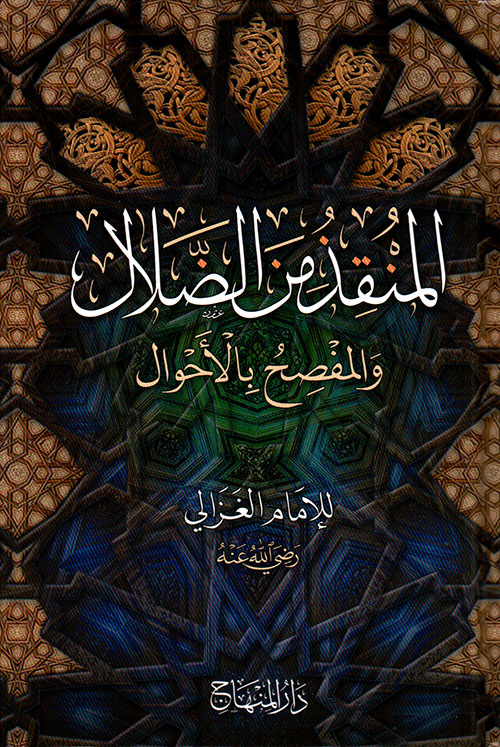
ويشير الغزالي في “المنقذ من الضلال” إلى ذلك قائلا: “ثم يترقى الحال –بالصوفي- من مشاهدة الصور والأمثال إلى درجات يضيق عنها نطاق النطق. ولا يحاول مُعَبّر عنها إلا اشتمل لفظه على خطأ صريح لا يمكنه الاحتراز عنه، ويوصي الذي لابسته تلك الحالة، ألا يزيد على أن يقول:
وكَانَ مَا كَانَ مما لَسْتُ أَذْكُره فَظَنَّ خَيْرًا ولا تَسْأَلْ عن الخَبَرِ.
كما يقول أيضا عن وجوب الامتناع عن القول أو الكتابة فيما أسماه علم المكاشفة “موضع يجب قبض عنان القلم فيه، فقد تحزَّب الناس فيه إلى قاصرين مالوا إلى التشبيه الظاهر، وإلى غالين مسرفين جاوزوا حد المناسبة إلى الاتحاد، وقالوا بالحلول، أما الذين انكشف لهم استحالة التشبيه والتمثيل، واستحالة الاتحاد والحلول، واتضح لهم مع ذلك حقيقة السر، فهم الأقلون”.
ويرى الغزالي بوجوب الاشتغال بطب القلوب، إذ لا يخلو قلب من علة لو أهملت لتفاقمت، وكانت سببًا في هلاك الإنسان؛ لذلك فالكشف عن هذه العلل والعمل على علاجها من أوجب الأمور، وهو تحقيق قوله تعالى “قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا”، وأما من يهمل ذلك فقد صدق فيه قوله تعالى” وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا”.
ويرى الغزالي أنَّ على المريد أن يلتزم شيخًا يقتدي به، حتى لا يضيع في سبل الشيطان المتعددة، وفي هذا يقول: “وليتمسك بشيخه تمسك الأعمى على شاطئ النهر بالقائد، بحيث يُفَوّض أمره إليه بالكلية ولا يخالفه”.
كما ألزم الغزالي الشيخ بالنظر في أمر المريدين، واستطلاع أخلاقهم وأدوائهم، واختيار ما يناسب كلا منهم مما تُرَاضُ به نفوسهم، ويصلح به أحوالهم، وإلا كان سببًا في هلاكهم وإماتة قلوبهم.
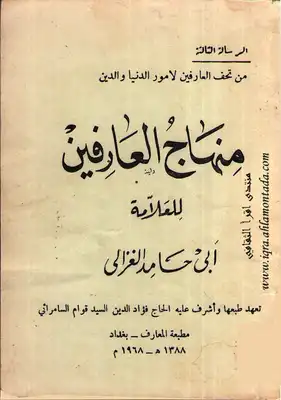
ويرى الغزالي أن أداة المعرفة الصوفية هي القلب وليس الحواس، ولا العقل والقلب عنده ليس هو العضو المعروف، الموجود في الجانب الأيسر من صدر الإنسان، وإنما هو اللطيفة الربانية الروحانية التي هي حقيقة الإنسان، وقد يكون لها بالقلب الجسماني تعلُّق، إلا أنَّ عقول الناس تحيرت في إدراك وجه العلاقة بينهما.
كما يرى أنَّ إصلاح القلب يكون بالتزام الخلوة، وكثرة الصمت والتأمل والجوع وإطالة السهر “إذ ليس سلوك الطريق إلا بقطع العقبات، ولا عقبة على طريق الله تعالى إلا صفات القلب التي سببها الالتفات إلى الدنيا” فإذا داوم المريد على رياضة نفسه بما تقدم، حصل له الكشف الذي عرَّفه الطوسي بقوله: “الكشف هو بيان ما يستر على الفهم، فيكشف عنه العبد كأنَّه رأي العين”. والكشف المباشر عند الغزالي يقابل الاستدلال العقلي، فبعض القلوب تحصِّل المعرفة بالإلهام الإلهي مبادأةً ومكاشفةً، وبعضها يُحصِّلها بالتعلم والاكتساب.
ولقد قسَّم الغزالي علوم التصوف إلى قسمين: علم المعاملة وهو ما وضعه في “الإحياء”، وعلم المكاشفة الذي قال عنه “وهذا لا رخصة في إيداعه الكتب”.
ويرى الغزالي أنَّ علم المكاشفة علم خفي لا يعلمه إلا أهل العلم بالله، ولذلك فإن أصحابه يستخدمون رموزًا خاصة، ولا ينبغي التحدث فيه خارج نطاق أهله، ويقول: “وأمثال هذه المعارف التي إليها الإشارة لا يجوز أن يشترك الناس فيها، ولا يجوز أن يظهرها من انكشف له شيء من ذلك لِمَنْ لم ينكشف له”.
وهو يرى أنَّ الفناء مقام من مقامات علم المكاشفة، ومنه نشأ خيال من ادعى بالاتحاد والحلول، وهو خطأ جسيم يشبه خطأ من “يحكم على المرآة بصورة الحُمْرَة؛ إذا ظهر فيها لون الحُمْرَة من مقابلها”.
إن منهج الغزالي في التصوف، منهج متفرد عما سبقه من مناهجَ، شابها ما شابها من الزيغ والشُّطَح، وهو عودة إلى الأصل في التصوف الإسلامي الذي هو الإحسان كما في الحديث “أن تعبد الله كأنَّك تراه، فإن لم تكن تراه؛ فإنه يراك”.













